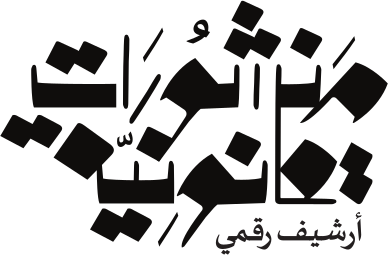ثغرات إجرائية في صرح العدالة الإدارية
* الكاتب: د. فتحي فكري - أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، عضو لجنة الخبراء العشرة لدستور 2014، وزير القوى العاملة والتنمية الإدارية الأسبق
أنهى دستور 1971 الاختصاص المحدود لمجلس الدولة، عاهدًا إليه في المادة 172 بنظر "المنازعات الإدارية" ([1]).
وهذا التحول كان يقتضي إعادة النظر في القانون رقم 55 لسنة 1959 المنظم لمجلس الدولة آنذاك؛ لتغير محوره الرئيسي المتمثل في حصر اختصاص القاضي الإداري في المنازعات المحددة نصًا.
وإنشاء قضاء مستقل لنظر الخصومات الإدارية، لا سيما إذا بُسطت ولايته العامة عليها، يتطلب وضع نظام إجرائي يتماشى مع خصوصياتها. ولذا، كان المأمول أن يواكب مراجعة القانون رقم 55 لسنة 1959 إصدارُ قانون خاص بالإجراءات أمام محاكم القضاء الإداري، أو على أقل تقدير تنظيمُ قانون المجلس لتلك الإجراءات، والتخلي عما درج النص عليه في القانون المار ذكره ([2]) والسابق عليه ([3]) من تطبيق قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد به نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي.
وخير برهان على أهمية هذا المطلب وجودُ قانون خاص للإجراءات أمام القضاء الإداري في فرنسا بخلاف قانون المرافعات المدنية ([4])، وهو البلد الذي اقتفينا أثره في نظام القضاء المزدوج.
بيد أن هذه التطلعات سرعان ما تبددت؛ حيث رُوجع قانون 1959 من خلال لائحة ضرورة ([5])، تمخض عنها القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ([6]). وكما هو معروف، تُعد تلك القرارات بقوانين بعيدًا عن الأنظار، بما لا يضمن إلمام السلطة القائمة عليها بكل المشكلات المُعانَى منها، وأبعاد الحلول المتوافقة معها.
من هنا، لم يكن مستغربًا أن تكون أبرز إضافات القرار بقانون، مقارنة بالتشريع السابق، النص في ختام المادة العاشرة البند الرابع عشر على اختصاص مجلس الدولة بـ "سائر المنازعات الإدارية". وتلخص هذا المسلك في تأكيد ما قرره المشرع التأسيسي، مكررًا التعهد بإصدار قانون خاص للإجراءات أمام القسم القضائي لاحقًا ([7]).
وبمرور الوقت، عُرض على المجلس منازعات لم تتعرض لها النصوص النافذة في مجالات شتى، وكان ذلك بمثابة نداء للسلطة التشريعية للعمل على إصدار قانون الإجراءات الخاص بالقضاء الإداري المُبشَّر به، على الأقل لتيسير نظر تلك المنازعات. إلا أن البرلمان لم يُلْقِ بالًا للنداء.
والمرة الوحيدة التي تدخل فيها البرلمان في الشق الإجرائي كانت عام 1984، مستهدفةً أساسًا ([8]) استحداث ما يُعرف بـ "دائرة توحيد المبادئ" ([9])، التي أسفر تطبيقها واقعيًّا عن بعض التساؤلات كان يمكن للمشرع التدخل لفضها، ولكنه تقاعس عن ذلك، مما فتح الباب لتضارب التفسيرات بشأنها.
في هذا الإطار، اجتهدت الأحكام في صياغة وتطوير المبادئ اللازمة لمواجهة الإشكاليات، لا سيما الإجرائية -التي طُرحت على ساحة القضاء- ولا توجد لها حلول نصية.
وكنموذج لذلك، نشير إلى دعوى تهيئة الدليل أو إثبات الحالة. ففي ظل القصور الإجرائي لقانون مجلس الدولة، جرت الأحكام بدايةً على عدم اختصاص محاكم القضاء الإداري بتلك الدعوى إذا رُفعت مستقلة عن أي طلب موضوعي يندرج في اختصاص القاضي الإداري ([10]). إلا أن أهمية هذا الإجراء، خصوصًا في منازعات العقود الإدارية، جعلت القضاء يحول بوصلته نحو قبولها؛ بوصفها "دعوى وقائية تستهدف تفادي ضياع دليل الدعوى الموضوعية في المنازعة الإدارية، وهي بهذه المثابة تعتبر -والحال كذلك- دعوى مستقلة يجوز رفعها استقلالًا كمنازعة إدارية أمام القضاء الإداري دون ارتباطها بطلب موضوعي" ([11]).
ولا مراء في أن هذا الحل، وإن لم يكن مثاليًّا ([12])، فحسبه منع تفتيت أواصر الدعوى بين أكثر من قضاء، وكان ذلك أقصى ما تسمح به النصوص القائمة.
ولا يزال القضاء ينهض بهذا الدور، إلا أن بعض النصوص التي صيغت في ظل غياب نظام إجرائي متكامل تقف دونه وبلوغ الهدف المتوخى.
وسوف نشير في السطور التالية إلى ثلة نماذج تجسد هذا الوضع.
والنماذج التي قدرنا إبراز أهمية بسط قصور تنظيمها الإجرائي هي:
- عدم منطقية نصاب اختصاص المحاكم الإدارية بالمنازعات العقدية، والحاجة إلى مراجعة نظام الطعن على عموم أحكامها.
- ضرورة مراجعة تنظيم وقف تنفيذ القرارات الإدارية.
- انتقاص رفض دائرة فحص الطعون للطعن من حق التقاضي.
- تحجيم التطبيق لدور دائرة توحيد المبادئ.
وننتقل الآن من الإجمال والكليات إلى التفاصيل والجزئيات، وفقًا للترتيب أعلاه.
عدم منطقية نصاب اختصاص المحاكم الإدارية بالمنازعات العقدية، والحاجة إلى مراجعة الطعن على عموم أحكامها:
أ) نصاب اختصاص المحاكم الإدارية بالمنازعات العقدية: حددت المادة 14 من قانون مجلس الدولة اختصاص المحاكم الإدارية ([13])، وهي تتوزع على قسمين: الأول، دعاوى الموظفين بالمستويات الدنيا، سواء أكانت دعاوى إلغاء أم تعويض أم طلبات تسوية؛ والثاني، منازعات العقود الإدارية التي لا تتجاوز قيمتها "خمسمائة جنيه".
وربما كان هذا النصاب مقبولًا لحظة صدور القانون، ولكنه منذ وقت طويل تجاوزه الواقع ([14])، وأضحى اختصاصًا معطلًا. فلا يُتصور الإقدام على رفع نزاع عقدي لا تزيد قيمته عن خمسمائة جنيه؛ لأن تكلفته الواقعية ببساطة تفوق ذلك بكثير، هذا على فرض إبرام عقود إدارية حاليًّا بهذا الرقم شديد التواضع.
وهكذا، أضحت الحاجة ملحة لمراجعة هذا النصاب، ليس فقط لإخراج النص من حالة السبات التي يعاني منها، وإنما أيضًا لتخفيف العبء على محكمة القضاء الإداري بالعهود للمحاكم الإدارية بشق من المنازعات العقدية.
واتفاقًا مع ما تقدم، نقترح زيادة نصاب اختصاص المحاكم الإدارية بالمنازعات العقدية إلى مائة ألف جنيه.
ب) الطعن على أحكام المحاكم الإدارية: تتبع التطور القانوني للطعن على أحكام المحاكم الإدارية يفيد تحفظ المشرع على تقريره. فوفقًا لقانون مجلس الدولة رقم 165 لسنة 1955، كانت أحكام المحاكم الإدارية نهائية ([15])، وحُرم أصحاب الشأن من الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا، إلا من خلال رئيس هيئة مفوضي الدولة وبموافقته، وفي الفروض المحددة قانونًا ([16])، وهي فروض أقرب للطعن بالنقض، مما يعني انتفاء طريق الاستئناف الذي يتيح إعادة النظر في النزاع من جديد.
وإذا كان قانون مجلس الدولة التالي رقم 55 لسنة 1959 قد سمح لذوي الشأن بالطعن في أحكام المحاكم الإدارية ([17])، فإنه حصر الطعن في الفروض الواردة في التشريع السابق، مما يعني أن الطعن بالاستئناف ([18]) بالمعنى الدقيق لا يزال بعيد المنال.
ولم يتبدل الحال إلا بصدور القانون رقم 86 لسنة 1969، الذي أتاح الطعن بالاستئناف ضد أحكام المحاكم الإدارية لذوي الشأن، مع تقرير هذا الحق أيضًا لرئيس هيئة مفوضي الدولة ([19]).
ولم يوفق الشارع في منح رئيس هيئة المفوضين حق الاستئناف. فوجود حق الطعن لرئيس هيئة المفوضين في التشريعات السابقة مرده أننا كنا بصدد طعن على غرار الطعن بالنقض، وبالتالي جاز السماح لرئيس هيئة المفوضين بالطعن، قياسًا –إذا جاز هذا القياس– على منح النيابة العامة هذا الحق لمصلحة القانون في القضاء العادي ([20]).
وانتقل هذا الخلط إلى القانون القائم؛ حيث نصت المادة 13 من قانون مجلس الدولة على جواز الطعن على أحكام المحاكم الإدارية أمام محكمة القضاء الإداري. ويُقدَّم الطعن من ذوي الشأن (أطراف الخصومة أمام أول درجة)، علاوة على رئيس هيئة مفوضي الدولة ([21]).
ونرى، بعد استبيان خلفيات إسناد حق الطعن لرئيس هيئة المفوضين، إلغاء تلك المكنة لتأكيد الطابع الاستئنافي للطعن وأثره في إعادة بحث موضوع النزاع من كافة جوانبه أمام محكمة أعلى من تلك التي أصدرته.
ويثور التساؤل حول جواز الطعن على أحكام محكمة القضاء الإداري كدرجة استئنافية. أجابت المادة 22 من قانون مجلس الدولة في عجزها على ذلك بقولها إن "الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية، فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس مفوضي الدولة خلال ستين يومًا من تاريخ صدور الحكم، وذلك إذا صدر الحكم على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا، أو إذا كان الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق لهذه المحكمة تقريره" ([22]).
والواقع أن الطعن المستند إلى الحاجة لتقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة الإدارية العليا تقريره، يندر توقع مباشرته؛ إذ يتطلب دراسة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا، وتقييمها لاستنتاج الحاجة إلى إضافة مبادئ أخرى إليها. يدعم هذا الاستخلاص بلوغ الدوائر الاستئنافية –حسب معلوماتنا– الآن (32) دائرة، تحسم كل منها في كل جلسة مئات الخصومات، وهو وضع يتعذر معه متابعة كافة الأحكام الصادرة من تلك الدوائر؛ لتحديد ما يجب الطعن عليه منها. علمًا بأن القانون لم يُجز لرئيس هيئة المفوضين تفويض مباشرة هذا الاختصاص لغيره ([23]).
وعليه، يقتصر طعن رئيس هيئة المفوضين على فرض مجاوزة أحكام محكمة القضاء الإداري الاستئنافية للمبادئ المعلنة من القضاء المتربع على قمة مجلس الدولة.
ويُثار التساؤل حول فرض عدم طعن رئيس هيئة المفوضين على حكم صدر من محكمة القضاء الإداري كدرجة استئنافية على خلاف المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا. وفقًا للوضع القائم، سيكتسب الحكم في هذه الحالة حجية الأمر المقضي، مما يسفر عن حالة صارخة من حالات إنكار العدالة. فطعن صاحب الشأن في حكم المحكمة الإدارية كان يتغيا إعمال مبادئ المحكمة الإدارية العليا، وقضاء محكمة القضاء الإداري بنقيض ذلك يعني ضياع الغاية من تعدد درجات نظر النزاع، مما ينتقص من حق التقاضي الدستوري ([24]). ولذا، نرى تعديل النص ليسمح لأصحاب الشأن –في الفرض المطروح– باللجوء إلى المحكمة الإدارية العليا حال انقضاء مدة الطعن دون تقدم هيئة المفوضين به.
يعضد هذا الحل تعدد المحاكم الإدارية، ومن ثم كثرة الطعون على أحكامها، وتزايد احتمال صدور أحكام في تلك الطعون لا تطبق المبادئ المعمول بها في قضاء المحكمة الإدارية العليا.
وحرمان أصحاب الشأن من الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا نتج عنه أوضاع تئن منها العدالة، كصدور أحكام متعارضة من نفس المحكمة في ذات النزاع. فقد عُرض على إحدى دوائر محكمة القضاء الإداري ستة طعون استئنافية محلها إلغاء قرار الإدارة السلبي بالامتناع عن تعيين ذوي الشأن على وظيفة دائمة على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور، بالنظر إلى استيفاء الشروط المقررة في المادة 73 من قانون الخدمة المدنية ([25]). أصدرت المحكمة خمسة أحكام بالقبول الموضوعي، وحكمًا سادسًا بالرفض ([26])، رغم أن المستندات المقدمة في كافة الدعاوى هي ذاتها، كما أنها استندت إلى نفس الأسس القانونية.
وفي محاولة لإيجاد مخرج من هذا الوضع، لاذ صاحب الشأن بالطعن بطريق التماس إعادة النظر. إلا أن المحكمة -بعد استعراض حالات الطعن بهذا السبيل كما أوردها قانون المرافعات- خلصت إلى انتفاء حالة من الحالات المجيزة لقبول الالتماس، ومن ثم رفض الطعن؛ لنجد أنفسنا أمام فرض ضاعت فيه الغاية من الاحتماء بالقضاء.
وحريٌّ بالذكر أن تقرير هيئة المفوضين في الدعوى، وإن انتهى إلى رفض الطعن بدوره، إلا أنه أشار إلى المفارقة التي نوهنا عنها، المتمثلة في قبول المحكمة لخمسة طعون ورفض السادس، رغم وحدة الأساس القانوني للدعاوى ([27]).
وهذا الوضع كان يمكن تجنبه بالسماح لذي الشأن بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بالضوابط التي يراها المشرع، وبما يفعّل الحق في التقاضي، ولا ينتقص منه كما هو الوضع الحالي.
وربما يُطرح التساؤل حول إمكانية تجنب المفارقة المشار إليها باستدعاء دعوى البطلان. بيد أن أحكام المحكمة الإدارية العليا تحدد نطاق تلك الدعوى بوجود خطأ جسيم ([28]) يفقد الحكم وظيفته ([29])، والمسألة في الفرض المطروح دارت حول وجود أو تخلف قرار سلبي بالرفض، أي أن الأمر تعلق بتباين التفسيرات، وهو ما لا يمكن تصنيفه في خانة الخطأ الجسيم.
ضرورة إعادة تنظيم وقف تنفيذ القرارات الإدارية:
يحكم المنازعات الإدارية مبدأ الأثر غير الواقف للطعن ([30])، إلا أن بعض الفروض تقتضي أحيانًا وقف تنفيذ القرار المَنْعِيّ عليه بالإلغاء لحين الفصل في موضوع الدعوى، كصورة من صور القضاء المستعجل في المنازعات الإدارية.
ولم تغفل كافة قوانين مجلس الدولة الإشارة إلى هذا القضاء، بيد أن التطور الذي ناله يحتاج إلى إعادة النظر فيه، وهو ما سنوضحه تَوًّا.
فقد نصت المادة 9 من أول تشريع لتنظيم مجلس الدولة (القانون رقم 112 لسنة 1946) على أنه "لا يترتب على رفع الطلب إلى محكمة القضاء الإداري وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، على أنه يجوز لرئيس مجلس الدولة أن يأمر بوقف تنفيذه إذا رأى أن نتائج التنفيذ يتعذر تداركها".
ومنح رئيس مجلس الدولة، ورئيس محكمة القضاء الإداري، سلطة البت في طلبات وقف تنفيذ القرارات الإدارية يتفق مع طبيعة الطلب المستعجل والحاجة إلى سرعة البت فيه.
ولم يستمر هذا الوضع طويلًا؛ حيث صدر القانون رقم 6 لسنة 1952 لينص على: "تُعدل المادة 10 من القانون رقم 9 لسنة 1949، الخاص بمجلس الدولة على الوجه الآتي: لا يترتب على رفع الطلب لمحكمة القضاء الإداري وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الأمر مؤقتًا إذا طُلب ذلك في صحيفة الدعوى، ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها..." ([31]).
وقيد التعديل طلبات وقف تنفيذ القرارات الإدارية من زاويتين:
- ضرورة تقديم طلب وقف التنفيذ في ذات عريضة دعوى الإلغاء.
- إسناد الفصل في طلب وقف التنفيذ إلى المحكمة بكامل تشكيلها، لا إلى قاضٍ فرد، كشكل معتاد في القضاء المستعجل.
ويتردد أن هذا التعديل باعثه سياسي، يتمثل في إصدار رئيس مجلس الدولة حكمًا بوقف تنفيذ لائحة لتنظيم بورصة القطن. وإذا كان يصعب تأكيد باعث التنقيح، فإنه من المؤكد أن هذا التعديل قضى على نبتة القضاء المستعجل في المنازعات الإدارية، والتي كان يؤمل البناء عليها دعمًا للعدالة الإدارية ولحق التقاضي في ذات الآن.
على أي حال، ظلت القوانين اللاحقة لمجلس الدولة تردد الأحكام التي أتى بها تعديل 1952، بما في ذلك القانون الساري رقم 47 لسنة 1972. فوفقًا للفقرة الأولى من المادة 49 منه: "لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طُلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها" ([32]).
وهكذا لا محل للحماية القضائية العاجلة إذا قُدم طلب وقف التنفيذ بدايةً ريثما يعد صاحب الشأن عدته للهجوم الموضوعي على القرار. ولا يختلف الحال إذا قُدم طلب وقف التنفيذ لاحقًا أثناء نظر دعوى الإلغاء ([33])، ولو كان ذلك نتيجة تفاقم الأضرار، وبروز الحاجة الماسة إلى حماية عاجلة تمنع مضاعفاتها. في هذه الحالات، يجد القاضي نفسه مضطرًا لعدم قبول طلب وقف التنفيذ، وحجب الحماية العاجلة بسبب المانع النصي الذي يفرض عليه اتخاذ هذا الموقف.
وعدم وضوح فكرة القضاء المستعجل أفضت إلى ظهور تطبيقات يصعب قبولها. ففي بعض الأحيان، ورغم التقيد بإدراج طلب وقف التنفيذ في عريضة الإلغاء، نجد المحكمة تحيل الدعوى بشقيها إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني، لتصدر في النهاية حكمها في طلب الإلغاء وحده، استنادًا إلى أن الفصل في الشق الموضوعي يغني عن الفصل في الشق المستعجل.
وهذه التطبيقات محل نظر من أكثر من جانب:
- لا مراء في أن الإحالة للمفوضين لإعداد تقرير في شقي الدعوى يؤخر الفصل فيها، وهو ما يناقض سرعة البت في الطلبات المستعجلة.
- صحيفة طعن الإلغاء ووقف التنفيذ تنطوي على طلبين ([34])، ويتعين الفصل في كل طلب على حدة، وبالأسباب المناسبة له.
- التطبيق المشار إليه يصادر حق التقاضي جزئيًا. فنظرًا لعدم إصدار حكم صريح في الشق المستعجل، سيوصد باب الطعن على حكم رفض طلب وقف التنفيذ، لسبب بسيط ألا وهو عدم وجود حكم للنعي عليه!
وتلك الأوضاع تدفعنا إلى المطالبة بالعودة إلى إسناد النظر في طلب وقف التنفيذ لقاضٍ فرد، مع فك الارتباط بين هذا الطلب والدعوى الموضوعية.
انتقاص رفض دائرة فحص الطعون للطعن من حق التقاضي:
أُنشئت دائرة فحص الطعون عام 1959 في إطار المحكمة الإدارية العليا، لتعرض عليها الطعون ضد أحكام محكمة القضاء الإداري، واحتفظت القوانين التالية بتلك الدائرة.
وينظم الدائرة حاليًّا المادة 46 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بنصها: "تنظر دائرة فحص الطعون ([35]) الطعن (على أحكام محكمة القضاء الإداري) بعد سماع إيضاحات مفوضي الدولة وذوي الشأن إن رأى رئيس الدائرة وجهًا لذلك. وإذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا، إما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره، أصدرت قرارًا بإحالته إليها. أما إذا رأت –بإجماع الآراء– أنه غير مقبول شكلًا أو باطل أو غير جدير بالعرض على المحكمة، حكمت برفضه."
"ويكتفى بذكر القرار أو الحكم بمحضر الجلسة، وتبين المحكمة في المحضر بإيجاز وجهة النظر إذا كان الحكم صادرًا بالرفض، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن."
"وإذا قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا، يؤشر قلم كتاب المحكمة بذلك على تقرير الطعن، ويُخطَر ذوو الشأن وهيئة مفوضي الدولة بهذا القرار."
ويكمل هذا التنظيم ما قضت به المادة الرابعة من تشكيل دائرة فحص الطعون من "ثلاثة مستشارين".
والنظرة الفاحصة للتنظيم السابق تفيد -في رأينا- أن رفض الطعن من الدائرة المار ذكرها يخل بحق التقاضي.
وللبرهنة على صواب هذا الاستنتاج، نوضح بادئ ذي بدء أن دائرة فحص الطعون يُنظر إليها على أنها "محكمة ذات تشكيل خاص" ([36]). وهذا التكييف يفرض على هذه الدائرة الالتزام بما تتقيد به المحاكم في ضمان الحق في التقاضي لمن يلوذون بها، وهو ما نرى تخلفه للدواعي التالية:
- حال طرح الطعن على الدائرة، يمكن البت فيه دون سماع إيضاحات أصحاب الشأن؛ فالنص يعطي رئيس الدائرة سلطة تقديرية مطلقة في سماع تلك الإيضاحات من عدمه. ولا مقنع في الدفاع عن ذلك بالقول بأن رئيس الدائرة يحدد موقفه في ضوء ملف الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، ومذكرة الطعن والرد عليها إن وُجدت؛ إذ لا يوجد ما يمنع من أن تكون لدى الطاعن أوجه دفاع جديدة اتضحت له بعد إيداع الطعن وقبل الفصل فيه. ولا نعتقد أن هذا الوضع يكفل حق الدفاع بصورة كاملة، فقد كان ينبغي السماح لذي الشأن بإبداء وجهة نظرهم، فربما غير ذلك رأي المحكمة في نتيجة الطعن.
- رفض الطعن يُقرر من ثلاثة مستشارين، في حين أن المحكمة الإدارية العليا تتكون دوائرها من خمسة مستشارين. وربما أُثير أن الشارع راعى ذلك باشتراط إجماع أعضاء دائرة فحص الطعون لرفض الطعن، وهو النصاب اللازم لرفض الطعن من المحكمة الإدارية العليا؛ حيث تصدر الأحكام بالأغلبية. وهذا القول يتغاضى عن أن توسيع دائرة المداولة من خمسة مستشارين قد يفضي إلى طرح رؤى من شأنها تغيير وجه الرأي في الطعن ([37]).
- أخطر مثلب في تنظيم دائرة فحص الطعون أن حكمها بالرفض، غير ([38]) القابل للطعن ([39])، يُسبَّب بصورة موجزة ([40])، لا تتعدى في الواقع العملي بضعة سطور ([41])، مع أن بعض أسباب الرفض حمَّالة أوجه (عدم جدارة الطعن بالعرض على المحكمة). وحتى بالنسبة للأسباب الأخرى، فإن التسبيب الموجز لا يفي بالغرض "التعليمي" للأحكام، إن جاز التعبير، والمتمثل في بيان أسانيد الحكم ومبرراته بصورة وافية؛ للاسترشاد بها في الطعون المستقبلية. ونرى أن المشرع تناقض في هذا الشأن مع نفسه؛ ففي الوقت الذي حدد أن الرفض يكون بـ "حكم"، اكتفى بتسبيب موجز لا يرضي الشعور بالعدالة. فالقاعدة في التسبيب، وفقًا للمادة 178 من قانون المرافعات والتي تطول كافة الأحكام، بيان "عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم، وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري... ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه"، علمًا بأن القصور في التسبيب يوقع الحكم في حمأة البطلان.
وهذه النقائص تفرز مفارقة غريبة: أن المنازعات القليلة الأهمية تحظى بضمانات تفوق تلك المعمول بها في الخصومات الأكثر أهمية. فالمنازعات التي تختص بها المحاكم الإدارية يُطعن فيها بالاستئناف أمام محكمة القضاء الإداري، في حين أن المنازعات التي تدخل في اختصاص الأخيرة لا تتمتع بذات الضمانات.
وهكذا يمكن القول إنه في حالة رفض الطعن من دائرة فحص الطعون، فإن القانون يسمح بالدلوف إلى ساحة المحكمة الإدارية العليا دون الحصول على الحماية المنتظرة منها.
والواقع أن التسبيب الموجز يمكن قبوله في حالة الطعن أمام محكمة على حكم سبق نظره ابتدائيًا واستئنافيًا، أي أنه فُحص ومُحِّص موضوعيًّا وقانونيًّا على درجتين، وهذا هو الطعن بالنقض، الذي يتحدد دوره في نظر الشق القانوني من النزاع ([42]). وليس هذا هو حال الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا التي لم يسبق نظرها إلا أمام محكمة القضاء الإداري، أي على درجة واحدة.
ولذا نرى، إذا أبقينا على دائرة فحص الطعون، أن يُقرر تسبيبها لحكم الرفض تسبيبًا لا يختلف عن تسبيب الأحكام الصادرة من الدوائر الموضوعية.
تحجيم التطبيق لدور دائرة توحيد المبادئ:
وفقًا للفقرة الأولى من المادة 54 مكررًا من قانون مجلس الدولة، وفق تنقيح 1984، "إذا تبين لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظر الطعون أنه صدرت منها أو من إحدى دوائر المحكمة أحكام سابقة يخالف بعضها البعض، أو رأت العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من المحكمة الإدارية العليا، تعين عليها إحالة الطعن إلى هيئة تشكلها الجمعية العامة لتلك المحكمة في كل عام قضائي من أحد عشر مستشارًا برئاسة رئيس المحكمة أو الأقدم فالأقدم من نوابه."
وقضى عجز النص بإصدار الهيئة، التي يطلق عليها دائرة توحيد المبادئ ([43])، "أحكامها بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل".
الأحكام التي تصدر من المحاكم الإدارية يُطعن فيها –على سالف البيان– أمام محكمة القضاء الإداري، وهو ما يضمن توحيد المبادئ في المنازعات المتماثلة. وهذه الغاية من غير المؤكد بلوغها حال الطعن على أحكام محكمة القضاء الإداري لدى المحكمة الإدارية العليا؛ نظرًا لتعدد الدوائر المكونة لها. ولذا، من المتوقع اختلاف المبادئ من دائرة لأخرى، بل من فترة لأخرى.
وهذه النتيجة تخل "باليقين القانوني الذي يجب أن يتوافر للمتقاضين. فاستقرار القضاء على ذات الحلول للمنازعات المتماثلة أمر يوفر للمتقاضين الاستقرار القانوني والقضائي، ويؤدي إلى التقليل من اللجوء إلى القضاء، ويشجعهم على إنهاء منازعاتهم وديًّا على هدي من المبادئ التي استقر عليها القضاء، وذلك حين يستقر في يقينهم أن اللجوء إلى القضاء لن يضيف لهم جديدًا، بل قد يحملهم أعباء قد لا يطيقونها، وتكون في النهاية بلا جدوى" ([44]).
ويُستفاد من نص المادة 54 مكررًا إنشاء المشرع لدائرة تضم عددًا يربو على ضعف عدد أعضاء دوائر الموضوع. وهذا العامل، فضلًا عن تشكيلها من كبار شيوخ القضاة، يعطي لأحكامها ثقلًا معنويًّا وقانونيًّا في ذات الآن. وهذا ما دفع البعض إلى القول بأن أحكام دائرة الفحص "تحوز حجية الشيء المقضي، وتلتزم جميع المحاكم ([45]) بالمبادئ التي تقررها" ([46]).
وهذا التحليل الأقرب للمنطق والمتفق مع الانطباع المتولد عن النص ناقضه الواقع بشكل كلي، وهو ما ستستظهره السطور التالية من زاويتين:
الأولى – لا تثريب على الدائرة المعروض عليها النزاع في إصدار أحكام تتعارض مع مبادئ قانونية صدرت منها أو من دائرة أخرى.
ففي نزاع يتعلق بأثر الانقطاع عن العمل لمدة طويلة، وتوفير هذا الانقطاع دليلًا على توافر نية هجر الوظيفة، انتهت المحكمة الإدارية العليا إلى أن استطالة مدة الانقطاع تكشف عن نية صاحب الشأن في العزوف عن الوظيفة، وتُعتبر خدمته منتهية بحكم القانون من تاريخ انقطاعه؛ ليكون قرار إنهاء الخدمة مجرد قرار تنفيذي يعلن انتهاء الخدمة بقوة القانون.
طُعن على هذا الحكم بدعوى البطلان الأصلية؛ استنادًا إلى صدوره على خلاف أحكام سابقة من دوائر المحكمة الإدارية العليا، مما كان يتعين معه إحالة الطعن قبل الفصل فيه للدائرة المشكلة وفقًا للمادة 54 مكررًا من قانون مجلس الدولة. أحالت الدائرة المعروض عليها النزاع إلى دائرة توحيد المبادئ.
وجاء تقرير هيئة المفوضين مقررًا قبول دعوى بطلان الحكم لصدوره بالمخالفة لأحكام سابقة للمحكمة الإدارية العليا. بيد أن دائرة توحيد المبادئ نفسها لم تشايع رأي هيئة المفوضين، وقضت برفض الطعن تأسيساً على دعامتين:
- تطبيق الإحالة عند تقدير الحاجة للعدول عن مبدأ قانوني مستقر في أحكام المحكمة الإدارية العليا "رهين بما تتبينه الدائرة المعنية من أن ما اتجهت إليه من رأي ستسطره في حكم تنوي إصداره سيأتي مخالفًا لمبدأ قانوني مستقر أو لأحكام سابق صدورها عنها، وهو أمر مرده إلى ما وقر في يقين الدائرة نفسها، بما لا يسوغ معه المجادلة أو المناقشة فيه أو التعقيب عليه، لا سيما أن الخروج على أحكام ومبادئ سابقة مقررة بالمحكمة لا يتأتى إلا عند تطابق الحالات بواقعاتها ووقائعها تطابقًا تامًا. أما إذا اختلفت إحدى الجزئيات في الواقعات، وصدر الحكم في ضوئها، فلا يكون ثمة خروج على أحكام سابقة؛ لعدم تطابق الحالات، ويغدو الحكم صحيحًا متفقًا وأحكام القانون". هذا التسبيب يفيد –في رأينا– أن الإحالة في الفرض المثار بيد الدائرة المعنية، خلافًا لنص القانون الذي استخدم كلمة "يتعين" دلالة على الإلزام لا الاختيار. يعضد ذلك ما يوحي به الحكم من ضرورة التطابق في الوقائع للإحالة، في حين أن المنطق يقضي بتوحيد المبادئ في المسألة الواحدة، بغض النظر عن توافر هذا التطابق أم لا. ففي المثال المطروح، المطلوب بيان حل انقطاع الموظف عن العمل لمدة طويلة، بغض النظر عن الدواعي، سواء أكانت السفر والعمل في الخارج، أم ممارسة عمل خاص في الداخل، أم حتى مجرد التكاسل.
- القاعدة أنه لا بطلان إلا بنص، ولم يقضِ المشرع به حال الامتناع عن الإحالة مع توافر موجبها، ولو أراد تلك النتيجة ما أعوزه النص على ذلك صراحة. واستطردت المحكمة معلنة: "ومن حيث إنه ابتناءً على ما تقدم، فإن الأحكام الصادرة عن دوائر المحكمة الإدارية العليا على خلاف مبادئ وأحكام صادرة عنها أو عن دوائر أخرى بالمحكمة، دون أن تستنهض ولاية الدائرة المشكلة طبقًا لنص المادة (54) مكررًا...، هي أحكام صحيحة مطابقة للقانون، لم يعتورها أي عيب يفقدها صفتها كأحكام، أو يفقدها أحد أركانها الأساسية المتعين توافرها في الحكم، الأمر الذي ينتفي معه مناط قبول دعوى البطلان الأصلية، ومن ثم لا يسوغ أن تكون هذه الأحكام محلًا لهذه الدعوى" ([47]).
ومع التسليم بخطورة القضاء ببطلان الأحكام، فإن التساؤل يثار حول المانع من تقرير البطلان بناء على نص صريح أو صياغة ضمنية لا تفترق عن النص الصريح، كما في الحالة التي نحن بصددها. فعلاوة على نهج الصياغة المُلمَّح إليه أعلاه، فإن غاية الإحالة تفادي اختلاف الحلول القضائية في الموضوعات المتماثلة؛ لتستقيم كلمة العدالة، ويستوي عود العدل. وذلك الهدف الذي يغيب عند تخلف النص على البطلان يجعلنا نقرر بإمكانية وجود استثناء على مبدأ "لا بطلان إلا بنص"، تحقيقًا للغايات المسطورة أعلاه والتي لا تقل في قيمتها عن احترام الحجية.
الثانية - لا بطلان لمخالفة ما سبق وقررته دائرة توحيد المبادئ: في نزاع أمام المحكمة الإدارية العليا ([48]) دار حول معاش وكيل سابق لمجلس الدولة، حيث طالب صاحب الشأن باستحقاقه معاش نائب وزير لبلوغ ما كان يتقاضاه مرتب تلك الوظيفة. دفعت الهيئة القومية للتأمين والمعاشات الدعوى بأنها أعملت نصوص قانون التأمين الاجتماعي على وجهها الصحيح في حق الطاعن، مما يستدعي رفض الدعوى. وأقرت المحكمة ما انتهت إليه الهيئة، خلافًا لما سبق وأن قضت به دائرة توحيد المبادئ.
طُعن على الحكم بدعوى البطلان، وقررت المحكمة التي تنظر الدعوى إحالتها إلى دائرة توحيد المبادئ. وبعد أن ناقشت الدائرة أسباب البطلان المدَّعَى بها، أعلنت "أنه إذا أجيز استثناءً الطعن بدعوى بطلان أصلية في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية، فإن هذا الاستثناء –في غير الحالات التي نص عليها المشرع كما فعل في المادة 147 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968– يجب أن يقف عند الحالات التي تنطوي على عيب جسيم وتمثل إهدارًا للعدالة يفقد فيها الحكم وظيفته". لتخلص إلى أنه "لا يتوافر فيما استثاره الطاعن من أسباب الطعن بالبطلان على الحكم الطعين، ما ينحدر بهذا الحكم إلى هاوية البطلان، إذ لا يعدو الأمر عند حد الخلف في الرأي الذي أبان الحكم قواعده ومبرراته فيما رجح لديه، وهو الخلف الذي حسمته هذه الدائرة الخاصة بقضاء فيصل من جانبها ([49]) في الطعن 32 القضائية عليا..." ([50]).
وهكذا قررت دائرة توحيد المبادئ نفسها أن مخالفة المبادئ التي تقرها لا تفضي إلى البطلان، وهو ما يطرح السؤال الآتي: ماذا بقي من أهداف استحداث دائرة توحيد المبادئ؟
ولعله مما ينجز شطرًا من هذه الأهداف النص على بطلان الأحكام المخالفة لما صدر عن الدائرة المشكلة وفقًا للمادة 54 مكررًا من مبادئ. وهذا المخرج يخفف تأذي العدالة من تباين حلول المنازعات المتماثلة، مع مراعاة أن فرصة عدول دائرة توحيد المبادئ عما قررته من مبادئ يكفل توفير التطور لتلك المبادئ بما يتسق مع ما قد يجد من متغيرات.
كلمة ختامية:
انضم مجلس الدولة إلى نظامنا القضائي منذ زهاء ثمانية عقود، وكان ولا يزال مثبتًا دوره كحصن متين للذود عن الحقوق ودرع صلب لصيانة الحريات، حتى أضحى وجوده في ذاته ضمانة لا غنى عنها.
إلا أن الممارسة العملية أظهرت حاجة هذا الدور إلى التدعيم؛ إذ يواجه عوائق إجرائية قائمة، ونظمًا إجرائية أخرى غائبة، مما يبرز إلحاح وضع قانون إجرائي للقضاء الإداري.
ويجرنا هذا الحديث إلى العودة إلى مثال دعوى إثبات الحالة؛ فبعد تردد طال لسنوات طوال، خلص القاضي الإداري إلى قبولها كدعوى مستقلة دون نص، بيد أن القضاء لم يكن بوسعه السير أبعد من تلك الخطوة بتبسيط إجراءات طلب إثبات الحالة، أو منح الأمر بها لقاضٍ فرد اتفاقًا مع طبيعتها العاجلة التي لا تحتمل التأجيل.
إننا نترقب سن هذا القانون اعتبارًا من 1955، أي منذ سبعة عقود، في الوقت الذي تنهمر فيه القوانين وتعديلاتها من حولنا لدرجة يتعذر معها، حتى على المتخصصين، الإحاطة بها بغير مشقة بالغة.
وننوه إلى أن الوضع الحالي لا يصلحه التنقيحات الجزئية في هذا الموضع أو ذاك؛ فنحن بحاجة إلى نظام إجرائي ينبثق من فلسفة واحدة، أو قل موحدة، تعالج المشكلة بصورة شاملة.
إننا نلح وبشدة على المشرع إصدار القانون المنوه عنه لملء الفراغ القائم، بما يسهم في وضوح ويسر خطوات الفصل في المنازعات الإدارية، ومن ثم سرعة حسمها كمطلب قننته المادة 97 من الوثيقة الدستورية ([51]) .
الهوامش
[1] تكرر النص على ذلك فى دستورى 2012 ( المادة 174) ، 2014 ( المادة 190 ) .
[2] المادة الثالثة من قانون اصدار القانون رقم 55 لسنة 1959 .
[3] قضت المادة 74 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بأن " تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون .
" وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد به نص وذلك إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائى " .
وكانت هذه هى المرة الأولى التى نطالع فيها هذا النص ، ففى التشريع الأول لمجلس الدولة رقم 112 لسنة 1946، وحيث تكون المجلس من محكمة وحيدة اكتفى الشارع بالنص فى المادة 34 على أنه " فيما عدا ما هو منصوص عليه فى المواد التالية تسرى فى شأن الإجراءات التى تتبع أمام محكمة القضاء الإدارى القواعد المقررة فى قانون المرافعات للمواد المدنية والتجارية " .
وورد ذات النص حرفيا فى المادة 11 من القانون التالى رقم 9 لسنة 1949 .
والسبب فى الاشارة لإصدار قانون خاص للإجراءات الإدارية فيما بعد هو إنشاء المحاكم الإدارية والمحكمة الإدارية العليا بجانب محكمة القضاء الإدارى .
[4] code de la juridication adminisrative
[5] كانت المادة 147 من دستور 1971 تتيح لرئيس الجمهورية حال غياب المجلس النيابى وحدوث ما يوجب اصدار تدابير لا تحتمل التأخير أن يسن فى شأنها قرارات لها قوة القانون . ويطلق على هذه التدابير لوائح الضرورة . وليس هنا مقام مناقشة توافر الاستعجال المبرر لاستخدام النص من عدمه ، ولكنه كان السند لوضع النصوص الخاصة بمجلس الدولة عقب سريان دستور 1971 المانح الولاية العامة لمجلس فى نظر المنازعات الإدارية .
[6] نشر القرار بقانون فى 5 اكتوبر 1972 بالجريدة الرسمية العدد (40) .
[7] المادة الثالثة من قانون اصدار القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 .
[8] أنشأ هذا القانون كذلك ما يسمى بالمجلس الخاص مُسنداً إليه النظر فى شئون أعضاء المجلس .
[9] القانون رقم 136 لسنة 1984 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 31 فى 2 / 8 / 1984 .
[10] أنظر على سبيل المثال : المحكمة الإدارية العليا – 16 /4 /1983 – الموسوعة الإدارية الحديثة – إعداد نعيم عطية ، حسن الفكهانى – الطبعة الأولى – ج 15 – القاعدة (200) – ص 404 ، المحكمة الإدارية العليا – 14 / 4 / 1984 – مجموعة المكتب الفنى – السنة 29 - العدد الثانى – ص 1005 .
[11] المحكمة الإدارية العليا – ( دائرة توحيد المبادئ ) – 2 /1 / 1997 – مجموعة المبادىء التى قررتها دائرة توحيد المبادئ منذ انشائها حتى أول فبراير 2001 – ص 385 .
[12] سنعود لتلك الجزئية فى الكلمة الختامية .
[13] انتقد البعض منذ فترة اختصاص المحاكم الإدارية داعياً لتوسعته بعد رفع مستوى تشكيلها ، حيث " اصبحت برئاسة وكيل مجلس الدولة ويدخل فى تشكيلها مستشار أو أكثر من مستشارى مجلس الدولة " .
محمد ماهر أبو العينين – إجراءات الدعوى أمام محاكم مجلس الدولة – ج (1) – 2005 - ص 141 .
[14] فى هذا المعنى : عبد الناصر على عثمان حسين – استقلال القضاء الإدارى – 2007 – ص 462 .
[15] المادة 13 من القانون رقم 165 لسنة 1955 .
[16] وفقاً للمادة 15 من قانون مجلس الدولة رقم 165 لسنة 1955 " لرئيس هيئة مفوضى الدولة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن ، إن رأى الرئيس المذكور وجهاً لذلك ، أن يطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى أو المحاكم الإدارية وذلك فى الأحوال الآتية :
(1) إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله .
(2) إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم .
(3) إذا صدر الحكم خلافاً لحكم سابق حاز قوة الشئ المحكوم به سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع .
وفى انتقاد هذا الوضع أعلن البعض أن المذكرة الايضاحية لقانون مجلس الدولة بررت " هذا المسلك بقولها ان رأى هيئة مفوضى الدولة تتمثل فيه الحيدة لصالح القانون وحده الذى يجب ان تكون كلمته هى العليا " . وقد انتقدنا ( المؤلف ) هذا المسلك من جانب المشرع فى ذلك الحين وقلنا حينذاك اننا لا نجد اى تعارض بين هذا الهدف الذى قصده المشرع وبين الاعتراف للخصوم فى الدعوى بحق الطعن فى احكام محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الادارية ، دون ان يتوقف ذلك على موافقة رئيس هيئة مفوضى الدولة ، بل ان هذا الاعتراف هو وحده الذى يوفر المزايا الحقيقية ويحقق الأهداف البعيدة لجعل التقاضى على درجتين ، وما الحرص على جعل كلمة القانون هى العليا إلا بقصد رعاية مصالح المتقاضين ، وحماية حقوقهم وحرياتهم فى النهاية " .
محمود حافظ – القضاء الادارى – 1993 – ص 692 ، وأنظر أيضاً : سعد عصفور – مذاهب المحكمة الإدارية العليا فى الرقابة والتفسير والابداع – 1957 – ص 66 – 67 إذ وصف الوضع بأنه بدعاً بين الخصومات ، إذا كيف بسوغ أن يستأثر بحق الطعن فى الأحكام القضائية من لم يكن خصماً فيها " .
[17] طبقاً للمادة 14 من القانون رقم 55 لسنة 1959 ( الفقرة الثانية ) " ويكون لذوى الشأن ولريئس هيئة مفوضى الدولة أن يطعن فى تلك الأحكام ( أحكام مكمة القضاء الإدارى – المحاكم الإدارية ) خلال ستين بوماً من تاريخ صدور الحكم ) .
[18] ربما قيل أن المحكمة الإدارية العليا توسعت فى قبول الطعون بحيث تشمل الأسباب القانونية والواقعية معاً ، ومع تأييدنا لهذا التفسير المحقق مصلحة المتقاضين ، إلا أنه ، فى رأينا ، تم عبر إجهاد النص ، وكان الأفضل تقرير الشارع لذلك صراحة .
[19] نصت المادة 14 فقرة ثانية من القانون رقم 86 لسنة 1969 على أن تختص محكمة القضاء الإدارى بنظر " الطعون التى ترفع فى الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ، ويكون الطعن من ذوى الشأن أو من رئيس هيئة مفوضى الدولة .. " .
[20] وفقاً للمادة 250 من قانون المرافعات " للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون فى الأحكام الانتهائية – أياً كانت المحكمة التى أصدرتها .. " .
[21] طبقاً للمادة 13 من قانون مجلس الدولة " تختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى المسائل المنصوص عليها فى المادة 10 عدا ما تختص به المحاكم الإدارية .. كما تختص بالفصل فى الطعون التى ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ، ويكون الطعن من ذوى الشأن أو من رئيس هيئة مفوضى الدولة وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم " .
[22] تتشدد المحكمة الإدارية العليا فى تطبيق النص ، وبناء عليه رفضت الطعن على أحد أحكام محكمة القضاء الإ دارى كدائرة استئنافية مقدم من رئيس هيئة مفوضى الدولة لعدم اتصاله بحالة من حالتى الطعن فى الأحكام الاستئنافية ، إذ تأسس على وزن " المحكمة للدليل " ..
المحكمة الإدارية العليا – 24 /4 / 1984 – مجموعة الأحكام – ج 29 /2 – ص 1060 .
[23] ترجمة لذلك قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " الأصل هو عدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى فى الطعون المقامة أمامها فى أحكام المحاكم الإدارية ، واستثناء من ذلك فقد أجاز القانون لرئيس هيئة مفوضى الدولة وحده الطعن فى هذه الأحكام وبالتالى فإن الاختصاص بتقرير الطعن فى هذه الأحكام معقود لرئيس هيئة مفوضى الدولة فقط دون غيره من أعضاء هيئة مفوضى الدولة وذلك لأن هذا الاختصاص لا يجوز التفويض فيه ومن ثم يتعين أن يكون تقرير الطعن موقعاً من رئيس هيئة مفوضى الدولة وبالتالى لا يجوز أن يقوم بتوقيعه أى عضو من أعضاء الهيئة نيابة عن رئيسها فإذا ما تم ذلك ووقع أحد أعضاء هيئة مفوضى الدولة على تقرير الطعن المقدم للمحكمة الإدارية العليا كان هذا التقرير باطلاً لصدوره ممن لا يملك الحق فى إقامة الطعن " .
المحكمة الإدارية العليا – 22 / 3 / 1997 – مجموعة الأحكام – ج 42 /2 – ص 681 .
[24] ربما ظُن أن الإنتقاص من حق التقاضى على النحو المشار إليه فى المتن يمكن مواجهته بطريق الطعن بعدم دستورية النص ، بيد أن المثلب المثار سببه التطبيق لا النص ذاته ، وقد جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا على عدم قبول الدعوى الدستورية فى مثل تلك الحالة .
واتفاقاً مع ذلك أعلن القاضى الدستورى فى حكم حديث نسبياً أن" الفصل فى دستورية النصوص القانونية المدعى مخالفتها للدستور ، لا يتصل بكيفية تطبيقها عملاً ، ولا بالصورة التى فهمها القائمون على تنفيذها ، وانما مرد الأمر فى شأن اتفاقها مع الدستور أو خروجها عليه إلى الضوابط التى فرضها الدستور على الأعمال التشريعية جميعها " .
المحكمة الدستورية العليا – 17 / 12 / 2022 – مجموعة الأحكام – ج 20 / 1 – ص 428 .
[25] طبقاً للمادة المشار إليها متناً " يعين فى أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول ( أجور ) كل من مضى على نقله على بند ( أجور موسميين ) على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة ، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف ، وتعاقده قبل 30 / 6 / 2016 " .
[26] يُعزى هذا الوضع – على الراجح – الى وجود عدد من الأعضاء بالمجكمة يسمح بتقسيمها إلى دائرتين ، وفى غياب التنسيق بين أحكام الدائرتين يتصور صدور أحكام متناقضة فى ذات الموضوع كما أبنا متناً .
[27] تعبيراً عن ذلك اورد تقرير هيئة المفوضين أن صاحب الشأن قدم طعناً " على حكم المحكمة الإدارية بالفيوم فى الدعوى رقم 1991 لسنة 8 ق.، حيث إنه تعاقد مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - جهاز مدينة الفيوم الجديدة للعمل بموجب عقد عمل مؤقت ( باليومية العارضة ) على بند 2/3 باب أول أجور موسميين ، رغم توافر كافة الشروط طبقاً لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2012م والمادة 73 من القانون 81 لسنة 2016م إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن ذلك دون مبرر قانونى ، وبجلسة 22 /10 / 2023 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإدارى ، فأقام الملتمس التماسه على سند من القول أن زملائه كانوا قد أقاموا الطعون أرقام 142 ، 148 ، 150 ، 150 ، 151 لسنة 11 ق. س أمام ذات المحكمة ( محكمة الطعن ) ، وقضى لهم بذات الجلسة بإلغاء حكم المحكمة الإدارية والقضاء مجدداً بتثبيتهم على وظيفة دائمة ، وذلك على الرغم من تقديمه ذات المستندات التى قدمها زملاؤه ، وبالتالى فإنه قد صدرت أحكام متناقضة من ذات المحكمة حالت دون تساوى المراكز القانونية بينه وبين زملاؤه المذكورين ، الامر الذى حدا به إلى إقامة التماسه الماثل بغية القضاء بطلباته .. " .
تقرير هيئة مفوضى الدولة فى الالتماس رقم 630 لسنة 11ق.س – ص 1.
[28] يضاف لذلك توافر سبب من أسباب عدم الصلاحية فى أحد أعضاء المحكمة .
[29] انظر على سبيل المثال : المحكمة الإدارية العليا – 9 / 2 / 1988 – مجموعة الأحكام – السنة 33 – الجزء الأول – ص 856 ،
المحكمة الإدارية العليا ( دائرة توحيد المبادئ ) – 3 / 6 / 1990 – مجموعة الأحكام – السنة 35 – الجزء الأول – ص 5 .
[30] المادة 49 من القانون رقم 47 لسنة 1972 ، وفى نظرة نقدية للمبدأ انظر : فتحى فكرى – وجيز دعوى الإلغاء – 2018 – ص 400 وما بعدها .
[31] منشور فى الوقائع المصرية – الجريدة الرسمية للحكومة المصرية – العدد 13 بتاريخ 19 / 1 / 1952 .
[32] يجسد ضابط " تعذر تدارك النتائج " الاستعجال ، وأضاف القضاء لذلك ضابط الوسائل الجدية والتى تفيد رجحان قبول الطعن موضوعياً .
فى دراسة مفصلة لوقف تنفيذ القرارات الإدارية أنظر على وجه الخصوص : محمد فؤاد عبد الباسط – وقف تنفيذ القرار الإدارى – 1997 .
[33] تتعدد الأحكام فى هذا الصدد ، ونكتفى بمثال قدرنا تجسيده للمسألة ، حيث قضى بأن الدعوى الأصلية قد خلت من طلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى الصادر من رئيس جهاز الرياضة بعدم حل مجلس إدارة نادى .. وأن المدعيين طلبا لأول مرة بإلغاء هذا القرار دون طلب وقف تنفيذه بجلسة 10 / 3 / 1983 وبعد ان حجزت الدعوى للحكم فيها بجلسة 28/ 4 / 1983 قررت المحكمة اعادتها للمرافعة بجلسة 12/5 / 1983 المتضمن لأول مرة طلب وقف تنفيذ القرار السلبى المطعون فيه سالف الذكر ومن ثم يكون هذا الطلب افتقد شرط اقترانه الوجوبى بطلب الإلغاء المقدم من المدعين بجلسة 10/ 3 / 1983 الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول طلب وقف تنفيذ هذا القرار " .
المحكمة الإدارية العليا – 14 / 4 / 1984 – مجموعة المكتب الفنى – السنة 29 – ص 1013 .
[34] جدير بالتنويه أنه عند تقديم دعوى الإلغاء المقترنة بطلب وقف تنفيذ القرار يسدد المدعى رسوماً عن طلب وقف التنفيذ علاوة على تلك المقرر لدعوى الإلغاء .
[35] حري بالتسجيل " أن كل دائرة من دوائر المحكمة الإدارية العليا بها دائرة لفحص الطعون ولكل دائرة من دوائر المحكمة الإدارية العليا رئيسان أحدهما للدائرة الموضوعية والآخر لدائرة الفحص .. " .
محمد ماهر أبو العينين – الدفوع فى نطاق القانون العام – الكتاب الثالث - 2002 – ص 126 .
[36] انظر على سبيل المثال : المحكمة الادارية العليا – 18 / 2 / 1989 – مجموعة الأحكام - السنة 34 – الجزء الأول - ص 563 ، المحكمة الإدارية العليا – 2 / 2 / 2002 – مجموعة الأحكام– السنة 47 – ص 413 .
[37] كان تشكيل دائرة فحص الطعون موضع نقد مطول من البعض : " فالقانون حين جعل دوائر المحكمة الإدارية العليا تؤلف فى الأصل من خمسة مستشارين راعى فى هذا العدد ضمانة تبادل الرأى على نطاق واسع ليكون نضجه اقرب الى التحقيق ، كما راعى ان دوائر محكمة القضاء الإدارى تتألف من ثلاثة مستشارين ، فمن الطبيعى أن تكون دائرة فحص الطعون ، باعتبارها إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا ، اكبر عدداً من دوائر محكمة القضاء الإدارى ".
وأضاف هذا الرأى : " فتخفيض العدد إلى ثلاثة فيه انتقاص من ضمانة التعدد الملحوظ فى تكوين دوائر المحكمة الإدارية العليا . وهذا الانتقاص تبرز أهميته إذا علمنا أن دائرة فحص الطعون وهى ثلاثية قد تمنع وصول الطعن إلى الدائرة الخماسية ، وبالتالى يفقد الأفراد إحدى أهم ضمانات التقاضى " .
رفعت عيد – دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا - دراسة تحليلية نقدية – دون سنة طبع – ص 16 .
[38] لا يمنع ذلك من الطعن بالبطلان على أحكام دائرة فحص الطعون شأن الأحكام الأخرى ، ويعرض هذا الطعن على هذه الدائرة ، انظر فى تطبيق ذلك على سبيل المثال : المحكمة الإدارية العليا – 18 / 2 / 1989– مجموعة الأحكام - السنة 34 – الجزء الأول – ص 563 .
[39] تطبيقاً لذلك أعلنت المحكمة الإدارية العليا " ومن حيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن دائرة فحص الطعون محكمة ذات تشكيل خاص وولاية قضائية خاصة مميزة عن تشكيل وولاية المحكمة الإدارية العليا بدوائرها الموضوعية وما يصدر من دائرة فحص الطعون بالإحالة إلى المحكمة الإدارية العليا ، فإنه قرارقضائى بنص القانون ، بينما وصف القانون ما تقضى به من رفض للطعن ، بإجماع آراء أعضائها ، بأنه حكم ومن ثم فإن هذا الرفض يكون حكماً قضائياً صادراً من دائرة فحص الطعون بتشكيلها الخاص ، ويخضع هذا الحكم بالتالى لكل ما تخضع له أحكام مجلس الدولة من قواعد وإجراءات .
" ومن حيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من التأشيرة الثابتة على نسخة الحكم المطعون فيه الأصلية الممهورة بخاتم شعار الجمهورية أن الطاعن سبق أن أقام طعناً على ذات الحكم المطعون بالطعن رقم 3592 لسنة 32 ق. عليا ، وقد قضت دائرة فحص الطعون بجلسة 11 / 11 / 1987 بإجماع الآراء برفض الطعن ، وقد أصبح هذا الحكم حائزاً لقوة الشىء المقضى به ، ومن ثم لا يجوز قانوناً معاودة نظر ذات الموضوع من جديد ، ويتعين لذلك القضاء بعدم جواز نظر الطعن الماثل لسابقة الفصل فيه بالطعن رقم 3592 لسنة 32 ق. عليا " .
المحكمة الإدارية العليا – 2 / 2 / 2002 – سبق ذكره .
[40] اعتبر البعض أن ما ورد فى القانون من أن " تبين المحكمة فى المحضر بابجاز وجهة النظر " يفيد أن المشرع لم يوجب "على دائرة فحص الطعون أن تسبب حكمها بالرفض " ، مفضلاً " التسبيب المختصر فى هذه الحالة " .
سليمان الطماوى – القضاء الإدارى – الكتاب الثانى – قضاء التعويض وطرق الطعن فى الأحكام – 1996 – ص 578 .
وهذا الرأى لمس الحاجة للتسبيب ، وان كنا نختلف معه فى نطاق التسبيب ، فالرفض الغير قابل للطعن لا يكفى فيه التسبيب المختصر ، ويستلزم التسبيب الوافى كما أبنا فى المتن .
[41] فى منازعة عرضت على دائرة فحص الطعون نعياً على حكم لمحكمة القضاء الإدارى ، انتهت الدائرة لرفض الطعن بالعبارة الآتية : " ان الحكم المطعون فيه .. قد صدر صحيحاً وموافقاً حكم القانون وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة فى شأن المسالة المطروحة " ، وإزاء العمومية الواضحة لتلك العبارة طعن صاحب الشأن على حكم دائرة فحص الطعون بالبطلان ، إلا أن المحكمة الإدارية العليا رفضت الطعن معلنة ان تلك العبارة كافية " لحمل وجهة النظر على محملها الجلى غير العصى على كل متتبع لما يُقر من مبادئ بهذه المحكمة " .
المحكمة الإدارية العليا – 18 /2 / 2018 – الطعن رقم 16787 لسنة 59 ق. عليا – الدائرة الثامنة موضوع – منشور على شبكة الانترنت – موقع المركز الاستشارى القانونى – تاريخ الزيارة 19 يناير 2025 .
واعتبار مثل هذا التسبيب كافياً ومجزئاً يدفعنا الى التمسك بمطلبنا بتعديل النص فى حالة رفض الطعن ، على النحو المبسوط متناً .
[42] وفقاً للفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 263 من قانون المرافعات " وبعد أن تودع النبابة مذكرة برأيها يعين رئيس المحكمة المقرر ، وبعرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول لسقوطه ، أو لبطلان إجراءاته ، أو لإقامته على غير الأسباب المبينة فى المادتين 248 ، 249 أو على أسباب تخالف ما أستقر عليه قضاؤها أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت فى محضر الجلسة مع إشارة موجزة لسببه .. " .
[43] فضل البعض اطلاق اصطلاح الطعن التنسيقى على فرضى الاحالة للدائرة المعنية ، وايضاحاً لذلك أفاد أنه يبين من الفقرة الأولى من المادة 54 مكررا " أن المشرع قد حدد حالتين للإحالة هما :
(أ) صدور أحكام تتضمن مبادئ متعارضة من دائرة واحدة أو أكثر .
(ب) إذا رأت إحدى دوائر المحكمة أن الحاجة ماسة للعدول عن مبدأ قررته أحكام سابقة .
" فالحالة الأولى تدخل فى نطاق التنسيق . أما الحالة الثانية فتواجه الظروف المتغيرة . ومن المسلمات أن القانون الإدارى قانون مرن لأنه قانون المرفق العام ، الذى يقوم على أساس مبدأ التغيير والمطابقة ، لمواجهة الظروف المتغيرة . وهكذا يكون المشرع قد وضع نظاماً للتنسيق المسبق بين مختلف دوائر المحكمة .. " .
سليمان الطماوى – المرجع السابق – ص 594 .
[44] جابر جاد نصار – دائرة توحيد المبادئ – 2002 – ص 54 .
[45] لايعنى ذلك جمود المبادئ التى تقررها دائرة توحيد المبادئ ، حيث يمكن لتلك الدائرة اعادة النظر فيما صدر عنها من مبادىء ، وهناك أكثر من سابقة فى هذا الصدد منها أن قانون لجان التوفيق رقم 7 لسنة 2000 ينص على الإعفاء من اللجوء للجان التوفيق بالنسبة لطلبات الغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ ، وطرح التساؤل حول اعفاء طلبات الإلغاء المقترنة بطلبات وقف التنفيذ ، حتى لو تعلقت بقرارات لا يجوز وقف تنفيذها والمشار اليها فى الفقرة الثانية من المادة 49 من قانون مجلس الدولة ( قرارات التعيين والترقية ومنح العلاوات والاحالة إلى المعاش أو الاستيداع أو الفصل بغير الطريق التأديبى والقرارات النهائية للسلطة التأديبية ) .
وفى البداية – أخذاً بظاهر النص - خلصت دائرة توحيد المبادىء إلى أن الإعفاء من اللجوء للجان التوفيق يسرى بغض النظر عن تعلق النزاع بقرار يجيز القانون طلب وقف تنفيذه من عدمه ( المحكمة الإدارية العليا ( دائرة توحيد المبادىء ) - 10 / 5 / 2008 – مجموعة المبادىء القانونية التى قررتها الدائرة فى 30 عاماً ( منذ انشائها إلى نهاية أغسطس 2015 ) – ج2 – ص891 .
وكان مبعث هذا القضاء - على الأرجح - تفادى عدم قبول الطعون لعدم سبق اللجوء للجان التوفيق .
من باب تيسير التقاضى ، ولكن فى 2011عدلت الدائرة عن القضاء السابق ، بحصر الإعفاء حال الطعن على القرارات التى يسمح القانون بوقف تنفيذها.
المحكمة الادارية العليا ( دائرة توحيد المبادىء ) – 1 /1 /2011– المجموعة السابقة – ج 2 ص 1010 .
وكان فى خلفية هذا القضاء أن المبدأ السابق يضع إعمال النص القانونى فى يد المتقاضى ، لا وفقاً لما أورده النص القانونى .
وحرى بالاشارة أن بعض الفقه تنبأ بامكانية عدول دائرة توحيد المبادئ عن ما سبق وقررته انطلاقاً من عدم دائمية الاجتهادات البشرية .
مصطفى أبو زيد فهمى – القضاء الإدارى ومجلس الدولة – قضاء الإلغاء – 1999- ص 338 .
[46] سليمان الطماوى – المرجع السابق – ص 595 .
[47] المحكمة الإدارية العليا ( دائرة توحيد المبادئ ) – 13 / 6 / 2009 – مجموعة المبادئ الصادرة من دائرة توحيد المبادئ منذ انشائها وحتى نهاية سبتمبر 2011 – ص 46 .
[48] لعله من المفيد الاشارة إلى أن الطعن طرح على المحكمة الإدارية العليا كقاضى أول وأخر درجة طبقاً للمادة 104 من قانون مجلس الدولة ، قبل أن يقضى بعدم دستوريتها فيما تتضمنته من قصرالاختصاص بنظر الطلبات والمنازعات المتعلقة برجال مجلس الدولة على درجة واحدة ، تأسيساً على الإخلال بالمساواة وتكافؤ الفرص ، بالنظر لتمتع رجال القضاء العادى منذ سنوات بضمانة التقاضى على درجتين .
( حكم المحكمة الدستورية العليا – 3 / 11 / 2018 المنشور بمجموعة الأحكام الصادرة عن المكتب الفنى للمحكمة – الجزء 17 المجلد الأول – ص 176 ) .
وداعى تلك الاشارة بيان النظرة الضيقة للمشرع ، إذ كان عليه عندما وفر ضمانة التقاضى على درجتين لرجال القضاء العادى بالقانون رقم 142 لسنة 2006 ألا يقصرها عليهم ويمدها لسائر أعضاء الجهات والهيئات القضائية .
[49] المقصود حكم دائرة توحيد المبادىء الصادر فى 1 / 4 / 1989 والمنشور فى مجموعة المبادىء التى قررتها دائرة توحيد المبادىء منذ انشائها وحتى اول فبراير سنة 2001 – ص 140 .
[50] المحكمة الإدارية العليا ( دائرة توحيد المبادىء ) – 3 / 6 / 1990 – مجموعة المبادىء التى قررتها دائرة توحبد المبادىء منذ انشائها وحتى اول فبراير 2001 – ص 161 .
[51] وفقاً لصدر المادة المشار إليها " التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى ، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايأ .. " .