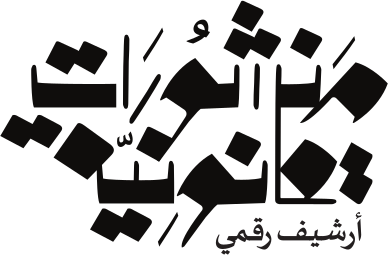في تطور مفهوم النص الدستوري في قضاء المحكمة الدستورية العليا
* الكاتب: المستشار الدكتور محمد عماد النجار - نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا
** عُرضت هذه الورقة في ندوة نظمتها وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، مساء الأحد 24 نوفمبر 2019، بالقاعة الشرقية بالتحرير، بعنوان "القضاء الدستوري المصري في نصف قرن - تطور مبادئ الحقوق والحريات وأشكال الرقابة"
في تعظيم دور الملكية في المجتمع
نشأ القضاء الدستوري المصري منذ سنة 1969 في حقبة ساد فيها الفكر الإشتراكي في مصر ، فمنذ سنة 1961، شهدت البلاد موجة تحول إلى النظام الاشتراكي ، وجرى تأميم العديد من أدوات الانتاج ، بل وبعض ادوات الملكية الخاصة التي رُئي أنها تمثل خطرا على التوجه الاشتراكي السائد في ذلك الوقت. وعندما تمت صياغة الدستور المصري لسنة 1971، فقد تم توثيق المذهب الاشتراكي كأحد الركائز الاساسية في المجتمع . وكان للتأثير الاشتراكي على الاقتصاد الدور الكبير ، فنصت المادة الأولى على أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي واشتراكي يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة. كما نصت المادة الرابعة على أن: الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي القائم على الكفاية والعدل بما يحول دون الاستغلال ويهدف إلى تذويب الفوارق بين الطبقات . كما نصت المادة (24) على أن : "يسيطر الشعب على كل أدوات الإنتاج، وعلى توجيه فائضها وفقاً لخطة التنمية التي تضعها الدولة. " كما نصت المادة (30) على أن: "الملكية العامة هي ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام. ويقود القطاع العام التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية في خطة التنمية.
ومن جماع هذه النصوص يتبين أن الاشتراكية في ظل أحكام ذاك الدستور غدت اساسًا اقتصاديا حاكما للمجتمع.
وفي غضون التسيعينيات اتجه المجتمع المصري بخطوات متواكبة ناحية الاقتصاد الحر، فيما عرف في ذاك الوقت بالانفتاح الاقتصادي. وبدت الأحكام المتعلقة بالاشتراكية غريبة عن التوجه المجتمعي الجديد ، ومن ثم فقد أعيدت مناقشة جدوى بعض الآثار الاقتصادية المترتبة على الحقبة الاشتراكية . وكانت أهم المشاكل التي تخلفت عن تلك الحقبة كيفية تسوية الأموال التي تم تأميمها أو وضعها تحت الحراسة بحسبانها من رؤوس الأموال المستغلة التي لا تتفق مع التوجهات الاشتراكية المدعومة من نصوص الدستور.
في مصادرة الملكية
حفلت التشريعات المختلفة في حقبة الخمسينيات والستينيات بقوانين الإصلاح الززراعي التي كانت الدولة بموجبها تنزع ملكية الأراضي الزراعية التي تزيد عن الحد الأقصى للتملك ، وتعيد توزيعها على صغار المزارعين ، وقد كان النزع يتم في الغالب مقابل تعويض قانوني يقدره المشرع . إلا أن بعض القوانين تضمنت مصادرة للملكية الزراعية بغير تعويض. وقد عرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا فقضت بعدم دستورية نزع الملكية بغير تعويض ، واقرت بحق الملاك في الحصول على التعويض مقابل هذا النزع. وقد أكدت المحكمة أن سلطة المشرع في التنظيم ليست مطلقة وإنما ترتهن بوجوب التعويض عن كل مساس بها إذ المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العيا "إن الدساتير المصرية المتعاقبة قد حرصت جميعها منذ دستور سنة 1923 على النص على مبدأ صون الملكية الخاصة وحرمتها باعتبارها فى الأصل ثمرة النشاط الفردى، وحافزه على الإنطلاق والتقدم، فضلاً عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التى يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى. ومن أجل ذلك، حظرت تلك الدساتير نزع الملكية الخاصة جبراً عن صاحبها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض. ([1])
في التعويض عن التأميم والحراسة
شهدت القوانين اعتبارًا من السبعينيات اتجاهًا محمودًا نحو تصفية الأوضاع المتعلقة بالحراسة بموجب قوانين تجيز دفع تعويضات بحدود قصوى للخاضعين للحراسة حال إذا ما تم التصرف في المال الخاضع للحراسة للغير حسن النية . وقد كانت هذه الحدود القصوى لا تعبر حقيقة عن قيمة الضرر الذي تعرض له الخاضعون للحراسة ، كما لا تعبر عن القيم الحقيقية للمال الخاضع للحراسة ، لاسيما مع تغير الأسعار وانخفاض قيمة العملة ، فقد عرض الأمر على المحكمة الدستورية ، وأقرت المحكمة مبدأ أساسيًا في الرد العيني للمال الخاضع إذ الملكية لا تنزع إلا للمنفعة العامة فقط، فإذا تعذر الأمر وجب التعويض الكامل الذي يعادل قيمة الضرر الفعلي، فأقرت المحكمة حق من خضع للتأميم في الحصول على تعويض عادل لا يتقيد بالحدود القصوى للتعويض التي دأبت القوانين آنئذ على النص عليها ([2]) .
في تحرير العلاقة الإيجارية
إلا أن المشكلة الأكبر حقيقة كانت تتعلق بتحرير العلاقات الإيجارية بين المالك والمستأجر، فقد كانت القوانين السائدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ، وأكدها تبني النظام الإشتراكي في ستينيات القرن الماضي، تقضي بتثبيت قيمة الأجرة ، ووضع ضوابط قانونية لتقديرها لا تتقيد بالاتفاق المبرم بين المالك والمستأجر ، وتقرير الامتداد القانوني لعقود الإيجار رغما عن المالك . وقد افرز هذا الوضع آثار غير عادلة إذ استمر عقد الإيجار لعقود طويلة بالأجرة المتعاقد عليها بعد تخفيضها -بموجب القيود القانونية الملزمة لطرفي العلاقة في تقديرها-، دون زيادة رغم تغير الأوضاع الاقتصادية، وانخفاض قيمة العملة . ومع الانفتاح الاقتصادي زاد الانخفاض في قيمة العملة لحدود كانت ابعد من تصورات المتعاقدين . ومع ذلك ظلت هذه القوانين السارية تجبر المالك على تجديد مدة العقد إلى آجال غير محددة ، وتقضي بتوريثه إلى اسلافه، وأصهاره ، والمساكنين معه من غير حد اقصى.
وفي تسعينيات القرن الماضي عرضت هذه المنازعات على المحكمة الدستورية العليا . وقد تبنت المحكمة اتجاهًا واضحًا للتوفيق بين التسليم بالتوجه الاشتراكي السائد في احكام الدستور الذي كان يسبغ سندا دستوريًا على هذا التنظيم، وبين توكيد حقوق الملكية التي قدم الدستور سندًا راسخًا لها . وقد راعت المحكمة في قضائها اعتبار تعاظم هذه المشكلة، وضخامة أعداد من تنطبق عليهم أحكامها ، فقد كانت المحكمة حريصة كل الحرص على عدم احداث انهيار في هذا التنظيم ، وانما العمل على الحد من غلوائه كلما سمح الواقع بذلك. ويمكننا تلخيص مذهبها في النقاط الآتية:
أولا: المزاوجة بين المذهبين الرأسمالي والاشتراكي
أكدت المحكمة على أن الدستور أخذ بموقف متوسط بين المذهبين الشيوعي والرأسمالية يسمح بتقييد الملكية، فقضت بأن الملكية فى إطار النظم الوضعية التى تزاوج بين الفردية وتدخل الدولة لم تعقد حقاً مطلقاً، ولا هى عصية على التنظيم التشريعى ، وإنما يجوز تحميلها بالقيود التى تقتضيها وظيفتها الاجتماعية ، وهى وظيفة يتحدد نطاقها ومرماها على ضوء طبيعة الأموال محل الملكية ، والأغراض التى ينبغى توجيهها إليها، وبمراعاة الموازنة التى يجريها المشرع ويرجح من خلالها ما يراه من المصالح أولى بالرعاية وأجدر بالحماية على ضوء أحكام الدستور ([3]) .
ثانيًا : وأن شرعية تدخل المشرع بالتنظيم رهن بوجود ضرورة اجتماعية تبرر هذا التدخل ، فإذا انتفت هذه الضرورة غدا تقييد حق الملكية غير دستوري :
وتطبيقا لذلك قضت المحكمة الدستورية العليا بأن " الحماية التى كفلها الدستور للملكية الخاصة تمتد إلى كل أشكالها، وتقيم توازنًا دقيقًا بين الحقوق المتفرعة عنها، والقيود التى يجوز فرضها عليها، فلا ترهق هذه القيود تلك الحقوق بما ينال من محتواها أو يقلص من دائرتها، ولذا لم يجز الدستور المساس بالملكية إلا استثناءً، باعتبارها في الأغلب الأعم من الحالات ثمرة جهد صاحبها، حرص على إنمائها وصونها، آملاً أن يتفيأ ثمارها، متطلعًا أن تكون ردءًا له وذويه في يومه وغده، مهيمنًا عليها ليختص دون غيره بغلتها، ولذا كان لزامًا أن توفر الحماية بوجه عام للأموال بما يعينها على أداء دورها، ويكفل حصد نتاجها، ويقيها تعرض الأغيار لها سواء بنقضها أو بانتقاصها، فلم يعد جائزًا أن ينال المشرع من عناصرها ولا أن يغير من طبيعتها، أو يتدخل بتنظيم أوضاع أموال معينة على نحو يودى ببعض أجزائها، أو يقيد مباشرة الحقوق التى تتفرع عنها في غير ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية ، ودون ذلك تفقد الملكية ضماناتها الجوهرية، ويكون العدوان عليها غصبًا أدخل إلى مصادرتها."([4])
ثالثًا : اتجاه المحكمة إلى القضاء بعدم دستورية بعض صور الامتداد القانوني لعقد الإيجار .
ويمكن التدليل على هذا التوجه بالأحكام الآتية :
(أ) عدم دستورية الامتداد القانوني للأصهار:
قضت المحكمة بناء على ذلك بجلسة 18/3 / 1995، في القضية رقم 6 لسنة 9 ق دستورية بعدم دستورية ما تضمنته المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من استمرار عقد إيجار المسكن - عند ترك المستأجر الأصلى له - لصالح أقاربه بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة الذين أقاموا معه فى العين المؤجرة مدة سنة على الأقل سابقة على تركه العين.
(ب) عدم دستورية الامتداد القانوني لصالح الشريك غير المتعاقد في العين المؤجرة لنشاط تجاري:
كما قضت بجلسة 6 يوليو سنة 1996، في القضية رقم 4 لسنة 15 ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر الأصلى للعين التى كان يزاول فيها نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً، فى مباشرة ذات النشاط بها بعد تخلى هذا المستأجر عنها.
(ج)عدم دستورية الامتداد القانوني لعقد ايجار الأقارب نسبًا بشرط الإقامة سنة:
كما قضت بجلسة2 أغسطس سنة 1997 في القضية رقم 116 لسنة 18 ق بعدم دستورية ما نصت عليه المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن "وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة، يشترط لاستمرار عقد الإيجار، إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل"
(د) وفي تطور آخر أكدت المحكمة أنها متمسكة بالامتداد القانوني في حدود ضيقة .
فقد أرادت المحكمة أن تؤكد على حق المشرع في أن يقرر امتداد عقد الإيجار إلى حدود لا تكون مؤبدة بغير حدود، فقضت بأن " ولئن كان الدستور قد كفل حق الملكية الخاصة، وحَوّطه بسياج من الضمانات التى تصون هذه الملكية وتدرأ كل عدوان عليها، إلا أنه فى ذلك كله لم يخرج عن تأكيده على الدور الاجتماعى لحق الملكية، حيث يجوز تحميلها ببعض القيود التى تقتضيها أو تفرضها الضرورة الاجتماعية وطالما لم تبلغ هذه القيود مبلغاً يصيب حق الملكية فى جوهره أو يعدم جُلّ خصائصه، إذ كان ذلك، وكان ما أملى على المشرع المصرى تقرير قاعدة الامتداد القانونى لعقد الإيجار، هو ضرورة اجتماعية شديدة الإلحاح تمثلت فى خلل شديد فى التوازن بين قدر المعروض من الوحدات السكنية وبين حجم الطلب عليها، وهو خلل باشرت ضغوطه الاجتماعية آثارها منذ الحرب العالمية الثانية، وكان تجاهلها يعنى تشريد ألوف من الأسر من مأواها بما يعنيه ذلك من تفتيت فى بنية المجتمع وإثارة الحقد والكراهية بين فئاته ممن لا يملكون المأوى ومن يملكونه، وهو ما يهدر مبدأ التضامن الاجتماعى، مما دعا المشرع المصرى إلى تبنى قاعدة الامتداد القانونى لعقد الإيجار، منذ التشريعات الاستثنائية لإيجار الأماكن الصادرة أثناء الحرب العالمية الثانية وحتى النص الطعين، كى يصون للمجتمع أمنه وسلامته محمولين على مبدأ التضامن الاجتماعى." ([5])
وخلصت المحكمة من ذلك إلى دستورية التشريع الذي يؤكد حق المستأجر الأصلى لعين النزاع في التمسك بالامتداد الذى قرره القانون لعقد الإيجار، فى مواجهة المالك دون التقيد بالمدة المتفق عليها فى العقد المبرم بينهما طالما أن هذا الامتداد لم يصل إلى حد التأبيد.
(هـ) المحكمة تقضي بعدم دستورية الامتداد القانوني لعقود ايجار الأشخاص المعنوية:
وأخيرًا قضت المحكمة ، بعدم دستورية الامتداد القانوني المؤبد لعقود ايجار الأشخاص الاعتبارية عندما تعرضت لصدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، في مجال سريانها على عقود ايجار المبرمة لصالح هذه الأشخاص ، فقضت بعدم دستورية ما تضمنه هذا النص من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى، مراعاة لأعتبار أن الشخص المعنوي لا يموت في الظروف الطبيعية، بل تستمر حياته حتى بعد وفاة مالكيه. ([6])
والخلاصة فإن المحكمة حتى في ظل عمل دستور 1971 في صورته الأولى التي سيطر عليها النزعة الاشتراكية، تمسكت بحماية الحق الملكية الخاصة ، وقامت بضبط نطاق المذهب الاشتراكي، والتوفيق بينه وبين قواعد صون الملكية الخاصة استجابة للتطور الاجتماعي الذي اتجهت إليه الدولة.
(و) دور القطاع العام في الاقتصاد الاشتراكي
قام الاقتصاد في ظل الحقبة الاشتراكية معتمدًا على القطاع العام الذي قاد قاطرته في شتى المجالات الانتاجية والتجارية. بيد أن مشاكل الإدارة أثرت على حسن أدائه ، وبلغت المشكلة ذروتها في مطلع التسعينيات من القرن الماضي، الأمر الذي ترتب عليه أن فقد هذا القطاع العريض جدواه ، وأصبح غير قادر على الاستمرار بالحيوية ذاتها ، وقد سارعت الحكومة ببيع جانب من القطاع العام إلى القطاع الخاص ، ومحاولة إدخال قدر من التطوير في إدارته ، وأثناء ذلك ثار الحديث الاجتماعي حول مدى دستورية القوانين التي قررت هذه التصرفات بالبيع . وقد عرض الأمر على المحكمة فقضت برفض دعوى عدم دستورية قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، واستندت المحكمة في ذلك إلى أن المادة (30) من الدستور التى تمنح القطاع العام دوراً تقدمياً يتحمل به المسئولية الرئيسية فى خطة التنمية، ويقود خطاها فى مختلف مجالاتها فإن هذه النصوص الدستورية لايجوز تفسيرها باعتبارها حلاً نهائياً ودائماً لأوضاع اقتصادية جاوز الزمن حقائقها، فلا يكون تبنيها والإصرار عليها، ثم فرضها بآلية عمياء إلا حرثاً فى البحر بل يتعين فهمها على ضوء قيم أعلى غايتها تحرير الوطن والمواطن سياسياً واقتصادياً. وأن قهر النصوص الدستورية لإخضاعها لفلسفة بذاتها، يعارض تطويعها لآفاق جديدة تريد الجماعة بلوغها، فلا يكون الدستور كافلاً لها، بل حائلاً دون ضمانها. ([7]) وهكذا فقد اتهجت المحكمة – في هذا الحكم على وجه الخصوص- إلى تفسير الدستور استهداًء بمذهب المدرسة التاريخية في التفسير، وهي مدرسة تقرأ النص القانوني في ضوء البيئة التي يطبق فيها ، وتقر بتطور أحكامه استجابة لظروف الواقع.([8])
بيد أن المحكمة توسعت في حماية الحق في الملكية على نحو لا ينفصل عن نصوص الدستور، وإنما يتبنى تفسيرًا موسعا للحق في الملكية الخاصة في ظل النظم الاشتراكية، وهو منهج املاه التطور السياسي والاقتصادي الذي ساد هذا العصر في المجتمع. والذي انتهى إلى تعديل الدستور سنة 2007، واستبعاد كل التأثير الاشتراكي من الدستور.
في حق التقاضي
الحق في الولوج للقاضي الطبيعي طلبًا للعدالة
شرعت المحكمة العليا في تفعيل الحق في التقاضي منذ باكورة احكامها. وكان الدلالة المطروحة لتفعيل هذا الحق هو تأمين حق كل مواطن في الولوج إلى قاضيه طلبًا للعدالة ، فإذا حظرت القوانين على المضرورين الولوج إلى القضاء فإن المحكمة كانت تفعل هذا الحق بقائها بعدم دستورية النص المانع من عرض الأنزعة على قاضيها . من ذلك قضاؤها بعدم دستورية المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 99 لسنة 1963 فيما نصت عليه من عدم سماع أى جهة قضائية أى دعوى يكون الغرض منها الطعن فى أى تصرف أو قرار أو تدبير أو إجراء أو عمل أمرت به أو تولته الجهات القائمة على تنفيذ جميع الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص أو الهيئات . ([9])
مفهوم التقاضي وحلقاته الثلاث
إلا أن المحكمة في مرحلة لاحقة طورت مفهوم حق التقاضي فجعلته يتضمن حلقات ثلاث: أولها حق كل إنسان في الولوج إلى القضاء، وثانيها حقه في أن يجد قاض مؤهل علميًا ، ومحايد قادر على الفصل في الخصومة القضائية في موعد مناسب وفق الأسس المسلم بها في الأمم المتحضرة، وثالثها حقه في أن يوفر له القانون في ختام مطاف الخصومة حلًا عادلًا ومنصفًا يحقق له الترضية القضائية.
وهكذا فقد قالت المحكمة إن "حق التقاضى يفترض ابتداء وبداهة تمكين كل متقاض من النفاذ إلى القضاء نفاذاً ميسراً لا تثقله أعباء مالية ، ولا تحول دونه عوائق إجرائية ، وكان هذا النفاذ- بما يعنيه من حق كل شخص فى اللجوء إلى القضاء وأن أبوابه المختلفة غير موصدة فى وجه من يلوذ بها، وأن الطريق إليها معبد قانوناً- لا يتعدى كونه حلقة فى حق التقاضى تكملها حلقتان أخريان لا يستقيم بدونهما هذا الحق، ولا يكتمل وجوده فى غيبة أى منهما، ذلك أن قيام الحق فى النفاذ إلى القضاء لا يدل بذاته ولزوماً على أن الفصل فى الحقوق التى تقام الدعوى لطلبها موكول إلى أيد أمينة عليها تتوافر لديها- ووفقاً للنظم المعمول بها أمامها- كل ضمانة تقتضيها إدارة العدالة إدارة فعالة ، بما مؤداه: أن الحلقة الوسطى فى حق التقاضى هى تلك التى تعكس حيدة المحكمة واستقلالها، وحصانة أعضائها والأسس الموضوعية لضماناتها العملية ، وهى بذلك تكفل المقاييس المعاصرة التى توفر لكل شخص حقا مكتملاً ومتكافئاً مع غيره فى محاكمة من صفة وعلنية تقوم عليها محكمة مستقلة محايدة ينشئها القانون تتولى الفصل- خلال مدة معقولة - فى حقوقه والتزاماته المدينة أو فى التهمة الجنائية الموجهة إليه، ويتمكن فى كنفها من عرض دعواه وتحقيق دفاعه ومواجهة أدلة خصمه رداً وتعقيباً فى إطار من الفرص المتكافئة ، وبمراعاة أن تشكيل المحكمة ، وأسس تنظيمها وطبيعة القواعد الموضوعية والإجرائية المعمول بها فى نطاقها، وكيفية تطبيقها من الناحية العملية ، هى التى تحدد لتلك الحلقة الوسطى ملامحها الرئيسية . متى كان ماتقدم، وكان حق التقاضى لا تكتمل مقوماته أو يبلغ غايته ما لم توفر الدولة للخصومة فى نهاية مطافها حلاً منصفاً يمثل التسوية التى يعمد من يطلبها إلى الحصول عليها بوصفها الترضية القضائية التى يسعى إليها لمواجهة الإخلال بالحقوق التى يدعيها، فإن هذه الترضية - وبافتراض مشروعيتها واتساقها مع أحكام الدستور- تندمج فى الحق فى التقاضى باعتبارها الحلقة الأخيرة فيه، ولارتباطها بالغاية النهائية المقصودة منه برابطة وثيقة ، ذلك أن الخصومة القضائية لا تقام للدفاع عن مصلحة نظرية لا تتمحض عنها فائدة عملية ، وإنما غايتها اقتضاء منفعة يقرها القانون، وتتحدد على ضوئها حقيقة المسألة المتنازع عليها بين أطرافها وحكم القانون بشأنها. واندماج هذه الترضية فى الحق فى التقاضى ، مؤداه: أنها تعتبر من مكوناته، ولا سبيل لفصلها عنه، وإلا فقد هذا الحق مغزاه، وآل سراباً. ([10]) وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان إنكار الحق فى الترضية القضائية سواء بمنعها ابتداء، أو بإقامة العراقيل فى وجه اقتضائها، أو بتقديمها متباطئة متراخية دون مسوغ أو بإحاطتها بقواعد إجرائية تكون معيبة فى ذاتها بصفة جوهرية ، لا يعدو أن يكون إهداراُ للحماية التى يفرضها الدستور والقانون للحقوق التى وقع العدوان عليها، وإنكاراً للعدالة فى جوهر خصائصها وأدق توجهاتها، وبوجه خاص كلما كان طريق الطعن القضائى لرد الأمور إلى نصابها ممتنعاً أو غير منتج، وكان من المقرر أنه ليس لازماُ لإنكار العدالة وإهدار متطلباتها أن يقع العدوان على موجباتها من جهة القضاء ذاتها، ذلك أن السلطة التشريعية أو التنفيذية قد تفرض من العوائق ما يحول دون بلوغ الترضية القضائية ، سواء عن طريق حرمان الشخص من إقامة دعواه، أو من نظرها فى إطار من الموضوعية ، ووفق الوسائل القانونية السليمة ومن ثم لا يعتبر إنكار العدالة قائماً فى محتواه على الخطأ فى تطبيق القانون. وإنما هو الإخفاق فى تقديم الترضية القضائية الملائمة ، وهو ما يتحقق بوجه خاص إذا كانت الوسائل القضائية المتاحة لا توفر لمن استنفدها الحماية اللازمة لصون حقوقه، أو كانت ملاحقته لخصمه للحصول على الترضية القضائية التى يأملها، لا طائل من ورائها. وحيث إنه بغير اقتران الترضية القضائية بوسائل تنفيذها وحمل الملزمين بها على الرضوخ لها، فإن هذه الترضية تغدو هباءً منثوراً، وتفقد قيمتها من الناحية العملية ، وهو ما يفيد بالضرورة إهدار الحماية التى فرضها الدستور والمشرع- كلاهما- للحقوق على إختلافها، وتكريس العدوان عليها، وتعطيل دور القضاء المنصوص عليه فى المادة (65) من الدستور فى مجال صونها والدفاع عنها، وإفراغ حق اللجوء إليه من كل مضمون. وهو حق عنى الدستور بتوكيده فى المادة (68).
إذا حدد الدستور قاضيًا بعينه للمسألة كان هو القاضي الطبيعي لها
وفي تطور حديث قضت المحكمة بأن الدستور متى ناط بهيئة قضائية معينة الاختصاص بالفصل في منازعة بنوعها ، فإن هذه الهيئة تصبح هي القاضي الطبيعي لنظر هذه المنازعة، فإذا عاد واسند الاختصاص إلى هيئة أخرى فإن ذلك بعد عدوانا على مبدأ اختصاص القاضي الطبيعي بنظر هذه المنازعة ، وترتيبًا على ذلك قضت المحكمة الدستورية العليا بأن إذا: " كان المرجع فى تحديد بنيان الضريبة العامة على المبيعات وعناصرها ومقوماتها وأوضاعها وأحكامها المختلفة ، بما فى ذلك السلع والخدمات الخاضعة للضريبة ، والمكلفين بها والملتزمين بعبئها وقيمة الضريبة المستحقة ومدى الخضوع لها والإعفاء منها إلى قانون هذه الضريبة ، وإلى القرار الصادر من الجهة الإدارية المختصة تنفيذًا لأحكامه ، فإن المنازعة فى هذا القرار تعد منازعة إدارية بحسب طبيعتها ، تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقًا لنص المادة (174) من الدستور الحالى الصادر فى 25/12/2012 (ويقابلها المادة 190 من دستور سنة 2014). وإذ أسند النصان المطعون فيهما الاختصاص بالفصل فى تلك المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى ، فإن مسلك المشرع على هذا النحو يكون مصادمًا لأحكام الدستور الذى أضحى بمقتضاه مجلس الدولة ، دون غيره من جهات القضاء – وفى حدود النطاق المتقدم ذكره – هو صاحب الولاية العامة فى الفصل فى كافة المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعى ، والتى تدخل ضمنها الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب ." ([11])
في ضوابط التشريع الجنائي
أولا- الجريمة
لقد كان للمحكمة الدستورية وقفات عدة في سبيل ضبط شرعية النص الجنائي على احكام الدستور ، ولقد كان للمحكمة دور بارز في تقعييد الأحكام الضابطة لهذه النصوص بالنظر لخطورتها على الحرية الفردية ومساسها المباشر بحقوق الإنسان وكرامته . وسوف نبسط أهم هذه المبادئ على النحو الآتي:
وضوح القاعدة الجنائية وانتفاء غموضها
لعل من أهم واسبق الضوابط التي أوجبت المحكمة الدستورية العليا تحققها هي قاعدة وضوح النص الجنائي، وانتفاء عموضه ، فإذ كان النص الجنائي غامضًا أو متميعًا بحيث يصعب على المخاطبين بأحكامه الوقوف على دلالته ، فإنه يكون غير مستوف للضوابط الدستورية للقاعدة الجنائية . وقد قار هذا الاعتبار بصدد الجريمة المؤثمة بالمادة (5) من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم ، إذ كان مضمون النص الجنائي غير واضح، وغير محدد المعالم على نحو يتيح للمخاطبين به الكف عن موانعه، فقضت المحكمة بأن " الأصل وفقا لنص المادة (66) من الدستور هو أن يكون لكل جريمة عقوبة محددة ينص القانون عليها في صلبه، أو تقرر - علي الأقل - وفقا للحدود التي يبينها، كذلك، فإن من القواعد المبدئية التي يتطلبها الدستور في القوانين الجزئية، أن تكون درجة اليقين التي تنتظم أحكامها في أعلي مستوياتها، وأظهر في هذه القوانين منها في أية تشريعات أخري، ذلك أن القوانين الجزئية تفرض علي الحرية الشخصية أخطر القيود وأبلغها أثرا، ويتعين بالتالي - ضمانا لهذه الحرية - أن تكون الأفعال التي تؤثمها هذه القوانين محددة بصورة قاطعة بما يحول دون التباسها بغيرها، وبمراعاة أن تكون دوما جليلة واضحة في بيان الحدود الضيقة لنواهيها، ذلك أن التجهيل بها أو انبهامها في بعض جوانبها لا يجعل المخاطبين بها علي بينة من حقيقة الأفعال التي يتعين عليهم تجنبها، كذلك فإن غموض مضمون النص العقابي مؤداه أن يحال بين محكمة الموضوع وبين أعمال قواعد منضبطة تعين لكل جريمة أركانها وتقرر عقوبتها بما لا خفاء فيه، وهي قواعد لا ترخص فيها وتمثل إطارا لعملها لا يجوز تجاوزه، ذلك أن الغاية التي يتوخاها الدستور هي أن يوفر لكل مواطن الفرص الكاملة لمباشرة حرياته في إطار من الضوابط التي قيدها بها، ولازم ذلك أن تكون القيود علي الحرية التي تفرضها القوانين الجزائية، محددة بصورة يقينية لأنها تدعو المخاطبين بها إلي الامتثال لها كي يدفعوا عن حقهم في الحياة وكذلك عن حرياتهم، تلك المخاطر التي تعكسها العقوبة.ولقد كان غموض القوانين الجزائية مرتبطا من الناحية التاريخية بإساءة استخدام السلطة، وكان أمرا مقضيا أن يركن المشرع الي مناهج جديدة في الصياغة لا تنزلق إلي تلك التعبيرات المرنة أو الغامضة أو المتميعة المحملة بأكثر من معني والتي تنداح معها دائرة التجريم بما يوقع محكمة الموضوع في محاذير واضحة قد تنتهي بها - في مجال تطبيقها للنصوص العقابية - إلي ابتداع جرائم لا يكون المشرع قد قصد حقيقة إلي إنشائها، والي مجاوزة الحدود التي اعتبرها الدستور مجالا حيويا لمباشرة الحقوق والحريات التي كفلها، وهو ما يخل في النهاية بالضوابط الجوهرية التي تقوم عليها المحاكمة المنصفة وفقا لنص المادة (67) من الدستور، والتي عرفتها هذه المحكمة بأنها تعكس نظاما متكامل الملامح يتوخي بالأسس التي يقوم عليها صون كرامة الإنسان وحماية حقوقه وحرياته الأساسية، ويحول بضماناته دون إساءة استخدام العقوبة بما يخرجها عن أهدافها." ([12])
افتراض البراءة وعدم دستورية افتراض أي عنصر في الجريمة
تكليف النيابة العامة إثبات الدليل على الإدانة
شهدت الأنظمة الجنائية في العالم أجمع مع اتساع التجريم في مجال الجرائم التنظيمية درجة من الصعوبة في الإثبات ، الأمر الذي حدا بها إلى افتراض علم المتهم بعناصر الجريمة تيسيرًا على سلطة الاتهام في اقامة الدليل . ولقد كان الأمر في البداية قاصرًا على الجرائم البسيطة كمخالفات المرور ، التي لجأ المشرع فيها إلى مساواة العمد بالخطأ ، ثم افتراض العلم بعناصر الجريمة المختلفة. ومع التطور الصناعي لجأ المشرع إلى التوسع في التجريم مفترضا تحقق العلم بعناصر الجريمة المختلفة ، والقى على المتهم عبء النفي . إلا أن المحكمة الدستورية العليا بمصر وقفت لهذا المسلك التشريعي بالمرصاد . فحرمت على نحو قاطع
افتراض أي عنصر من عناصر الركن المعنوي ، وأوجبت دومًا أن تقوم النيابة العامة بواجبها في إثبات هذا الركن. من ذلك قضاءها بأن : " إفتراض براءة المتهم ، لا يعدو أن يكون إستصحاباً للفطرة التى جبل الإنسان عليها ، وشرطاً لازماً للحرية المنظمة يكرس قيمها الأساسية التى لا يتصور أن تنفصل الجماعة عنها . وهو كذلك وثيق الصلة بالحق فى الحياة ، وبدعائم العدل التى تقوم على قواعدها النظم المدنية والسياسية جميعها . ومن ثم كان أصل البراءة جزءاً من خصائص النظام الإتهامى Accusatorial system لازماً لحماية الحقوق الرئيسية التى كفلتها المادة 67 من الدستور لكل متهم ، مرددة بها نص المادة 11 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ، والفقرة الثانية من المادة 14 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية ، بما مؤداه أن هذه البراءة لا يجوز تعليقها على شرط يحول دون إنفاذ محتواها ، ولا تعطيلها من خلال إتهام يكون متهاوياً ، ولا نقضها سواء بإعفاء النيابة من إلتزامها بالتدليل على صحة إتهامها ، أو عن طريق تدخلها هى أو غيرها للتأثير دون حق فى مسار الدعوى الجنائية ومحصلتها النهائية . بل إن الإخلال بها ــ وبإعتبارها مبدأ بدهياً ــ An Axiomatic Precept يعد خطأ لا يغتفر A prejudicial Error مستوجباً نقض كل قرار لا يتوافق معها . إن أصل البراءة يعتبر بذلك جزءاً لا يتجزأ من محاكمة تتم إنصافاً باعتباره متسانداً مع عناصر أخرى تشكل مقوماتها ، وتمثل فى مجموعها حداً أدنى من الحقوق اللازمة لإدارتها ، ويندرج تحتها أن يكون لكل من المتهم وسلطة الإتهام ، الوسائل عينها التى يتكافأ بها مركزيهما سواء فى مجال دحض التهمة أو إثباتها ، وهى بعد حقوق لا يجوز الحرمان منها أو تهميشها سواء تعلق الأمر بشخص يعتبر متهماً أو مشتبهاً فيه . وقد أقرتها الشرائع جميعها ــ لا لتظل المذنبين بحمايتها ــ وإنما لتدرأ بمقتضاها وطأة الجزاء المقررة للجريمة التى خالطتها شبهة إرتكابها بما يحول دون القطع بوقوعها ممن أسند إليهم الإتهام بإتيانها ، إذ لا يعتبر هذا الإتهام كافياً لهدم أصل البراءة ، ولا مثبتاً لواقعة تقوم بها الجريمة ، ولا حائلاً دون التدليل عليها ، بل يظل هذا الأصل قائماً إلى أن ينقض من خلال حكم قضائى صار باتاً بعد أن أحاط بالتهمة عن بصر وبصيرة ، وخلص إلى أن الدليل على صحتها ــ بكل مكوناتها ــ كان نقياً متكاملاً ." ([13])
الركن المادي للجريمة
لقد خلصت المحكمة من نص المادة (66) من دستور 1971، المقابلة لنص المادة (95) من الدستور القائم التي تقضي بأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون ، إلى أن الدستور أوجب على المشرع عند النص على الجريمة أن يعين الركن المادي لها، بحيث لا يتصور وجود جريمة بغير ركن مادي ، هو الذي يعبر عن قوامها، وبدونه لا قوام لها إطلافًا ، ففي دعوى أثم فيها المشرع أفعال الغش الغذائي على التجار ولو تعذر عليهم العلم بمحتويات المادة المباعة ، وفي هذا تقول المحكمة : "إن الدستور -فى اتجاهه إلى ترسم النظم المعاصرة ، ومتابعة خطاها، والتقيد بمناهجها التقدمية - نص فى المادة (66)، على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذى ينص عليها، وكان الدستور قد دل بهذه المادة على أن لكل جريمة ركناً مادياً لا قوام لها بغيره، يتمثل أساساً فى فعل أو امتناع وقع بالمخالفة لنص عقابى ، مفصحاً بذلك عن أن ما يركن إليه القانون الجنائى ابتداءً -فى زواجره ونواهيه- هو مادية الفعل المؤاخذ على ارتكابه، إيجابياً كان هذا الفعل أم سلبياً، ذلك أن العلائق التى ينظمها هذا القانون فى مجال تطبيقه على المخاطبين بأحكامه، محورها الأفعال ذاتها، فى علاماتها الخارجية ، ومظاهرها الواقعية ، وخصائصها المادية ، إذ هى مناط التأثيم وعلته، وهى التى يتصور إثباتها ونفيها، وهى التى يتم التمييز على ضوئها بين الجرائم بعضها البعض، وهى التى تديرها محكمة الموضوع على حكم العقل لتقييمها، وتقدير العقوبة المناسبة لها. بل أنه فى مجال تقدير توافر القصد الجنائى ، فإن محكمة الموضوع لا تعزل نفسها عن الواقعة محل الاتهام التى قام الدليل عليها قاطعاً واضحاً، ولكنها تجيل بصرها فيها، منقبة من خلال عناصرها عما قصد إليه الجانى حقيقة من وراء إرتكابها. ومن ثم تعكس هذه العناصر تعبيراً خارجياً ومادياً عن إرادة واعية . ولا يتصور بالتالى وفقاً لأحكام الدستور أن توجد جريمة فى غيبة ركنها المادى ، ولا إقامة الدليل على توافر علاقة السببية بين مادية الفعل المؤثم، والنتائج التى أحدثا بعيداً عن حقيقة هذا الفعل ومحتواه
. A persons " intent in any regard is to be inferred from his conduct and ordinarily can be proven only by circumstantial evidence . Regardless of whether intent is general or specefic , intent is proven to the trier of facts by the conduct of the actor which represents an objective , tangible manifistation of behaviour assumed to be reflection of his or her mental state .
ولازم ذلك أن كل مظاهر التعبير عن الإرادة البشرية ـ وليس النوايا التى يضمرها الانسان فى أعماق ذاته ـ تعتبر واقعة فى منطقة التجريم ، كلما كانت تعكس سلوكاً خارجيا مؤاخذاً عليه قانونا ، فإذا كان الأمر غير متعلق بأفعال أحدثتها إرادة مرتكبها وتم التعبير عنها خارجياً فى صورة مادية لا تخطئها العين ، فليس ثمة جريمة .([14])
الرقابة الدستورية على الجرائم العمدية والجرائم غير العمدية
الجرائم العمدية
لم تقف المحكمة عند اعتبار تطلب الركن المادي ذو المظاهر الخارجية القابلة للتحقيق وتعيين الفعل المستوجب لتقديم المتهم للمحاكمة استنادًا إليه ، بل خطت خطوة أوسع في اتجاه تطلب الركن المعنوي في مجال الجرائم العمدية ، ففي قضية جوهرية تتعلق بمسئولية رئيس التحرير عن الجرائم التي تقع بطريق النشر ، وهي مسئولية افتراضية تقوم على أساس افتراض العلم في حقه بكل ما نشر بالجريدة، ومن ثم المسئولية عن كل جريمة تقع بهذا النشر ، قضت المحكمة بعدم دستورية هذا الافتراض ، وأوجبت تحقق العلم الفعل والإدراة الحقيقية طالما أن المشرع نظم هذه الجريمة ضمن الجرائم العمدية ، فقالت المحكمة : " الأصل فى الجرائم، أنها تعكس تكويناً مركباً باعتبار أن قوامها تزامناً بين يد اتصل الإثم بعملها [an evil - doing hand]، وعقل واع خالطها [an evil - meaning mind] ليهيمن عليها محدداً خطاها، متوجهاً إلى النتيجة المترتبة على نشاطها، ليكون القصد الجنائى ركناً معنوياً فى الجريمة [Mens Rea] مكملاً لركنها المادى [Actus Reus]، ومتلائماً مع الشخصية الفردية فى ملامحها وتوجهاتها. وهذه الإرادة الواعية هى التى تتطلبها الأمم المتحضرة فى مناهجها فى مجال التجريم بوصفها ركناً فى الجريمة ، وأصلاً ثابتاً كامناً فى طبيعتها، وليس أمراً فجاً أو دخيلاً مقحماً عليها أوغريباً عن خصائصها. ذلك أن حرية الإرادة تعنى حرية الاختيار بين الخير والشر. ولكلٍ وجهة هو مُوَلِّيها، لتنحل الجريمة -فى معناها الحق- إلى علاقة ما بين العقوبة التى تفرضها الدولة بتشريعاتها، والإرادة التى تعتمل فيها تلك النزعة الإجرامية التى يتعين أن يكون تقويمها ورد آثارها، بديلاً عن الانتقام والثأر المحض من صاحبها. وغدا أمراً ثابتاً -وكأصل عام- ألا يجرم الفعل ما لم يكن إرادياً قائماً على الاختيار الحر، ومن ثم مقصوداً. ولئن جاز القول بأن تحديد مضمون تلك الإرادة وقوفاً على ما هيتها، لا زال أمراً عسراً، إلا أن معناها - وبوصفها ركناً معنوياً فى الجريمة - يدور بوجه عام حول النوايا الإجرامية أو الجانحة felonious intent أو النوازع الشريرة المدبرة malice aforethought أو تلك التى يكون الخداع قوامها fraudulent intent أو التى تتمحض عن علم بالتأثيم، مقترناً بقصد إقتحام حدوده guilty knowledge، لتدل جميعها على إرادة إتيان فعل بغياً. ([15])
الجرائم غير العمدية
أما في مجال الجرائم غير العمدية ، فقد أوجبت المحكمة اتجاه الإرادة إلى الفعل دون النتيجة ، أو عدم توقع حدوث النتيجة كأثر للفعل رغم امكان توقع ذلك ، وأنه ولئن كانت تلك الشروط هي ما خلص إليه العلم الجنائي ، إلا أن المحكمة خطت خطوة جديدة ، باسناد هذه النتائح إلى نصوص الدستور، واعمال الرقابة الدستورية على النص الجنائي استنادًا اليها ، وفي هذا تقول المحكمة : " أن المشرع عمد أحياناً ـ من خلال بعض اللوائح ـ إلى تقرير جرائم عن أفعال لا يتصل بها قصد جنائى بإعتبار أن الإثم ليس كامناً فيها inherenly wrong mala in se ولا تدل بذاتها على ميل إلى الشر والعدوان ولا يختل بها قدر مرتكبها أو اعتباره وإنما ضبطها المشرع تحديداً لمجراها ، وحداً من مخاطرها وأخرجها بذلك عن مشروعيتها mala prohibita وهى الأصل وجعل عقوباتها متوازنة مع طبيعتها فلا يكون أمرها غلوا من خلال تغليظها ، بل هيناً فى الأعم وقد بدا هذا الاتجاه متصاعدا إثر الثورة الصناعية التى تزايد معها عدد العمال المعرضين لمخاطر أدواتها وآلاتها ومصادر الطاقة التى تحركها ، واقترن ذلك بتعدد وسائط النقل وتباين قوتها وبتكدس المدن وازدحام أحيائها وبغلبة نواحى الاخلال بالصحة العامة وبوجه خاص من خلال الاتصال بالمواد الغذائية سواء عند انتاجها أو توزيعها وتداولها أو بمراعاة نوعيتها ، وكان لازماً بالتالى ولمواجهة تلك المخاطر ـ أن بفرض المشرع على المسئولين عن إدارة الصناعة أو التجارة وغيرهم قيوداً كثيرة غايتها أن ينتهج المخاطبون بها سلوكاً قويماً موحداً ببذل العناية التى يتوقعها المشرع من أوساطهم ليكون النكول عنها وبغض النظر عن نواياهم ـ دالاً على تراخى يقظتهم ومستوجباً عقابهم . غير أن تقرير هذا النوع من الجرائم فى ذلك المجال ظل مرتبطاً بطبيعتها ونوعيتها ومنحصراً فى الحدود الضيقة التى تقوم فيها علاقة مسئولية بين من يرتكبها وخطر عام لتكون أوثق اتصالاً برخاء المواطنين وصحتهم وسلامتهم فى مجموعهم public welfare offenses وبإهمال من قارفها لنوع الرعاية التى تطلبها المشرع منه عند مباشرته لنشاط معين أو بإعراضه عن القيام بعمل ألقاه عليها بإعتباره واجباً وبمراعاة أن ماتوخاه المشرع من إنشائها هو الحد من مخاطر بذواتها بتقليل فرص وقوعها وإنماء القدرة على السيطرة عليها والتحوط لدرئها ولا يجوز بالتالى أن يكون إيقاع العقوبة المقررة لها معلقاً على النوايا المقصودة من الفعل ولا على تبصر النتيجة الضارة التى أحدثها foreseeability of the resulting harm ذلك أن الخوض فى هذين الأمرين يعطل أغراض التجريم ولأن المتهم ـ ولو لم يكن قد اراد الفعل كان بإستطاعته أن يتوفاه لو بذل جهداً معقولاً وفقاً للمقاييس الموضوعية عما يكون متوقعاً من الشخص المعتاد ordinary reasonable man وغدا منطقياً بالتالى أن يتحمل الأضرار التى أنتجها ، وأن يكون مسئولاً عنها حتى ما وقع منها بصفة عرضية أو مجاوزاً تقديره ولازم ما تقدم أن هذا النوع من الجرائم ـ وتلك هى خصائصها ـ يعد استثناء من الأصل فى جرائم القانون العام التى لا تكتمل مقوماتها الا بإعتبار أن القصد الجنائى ركن فيها . ذلك أن هذه الجرائم لها من الخصائص ما يشين مرتكبها ويتعين أن يكون قوامها تدخلاً إيجابياً مقترناً بالارادة الواعية التى تعطى العمل دلالته الإجرامية وبها يكون العدوان فى الأعم واقعاً على حقوق الافراد أو حرياتهم أو ممتلكاتهم أو حياتهم أو آدابهم public decency and morality ([16])
ثانيًا- العقوبة
شرعية الجزاء تناسبه مع الإثم
أوجبت المحكمة لشرعية الجزاء الجنائي من الناحية الدستورية أن يكون متناسبًا مع مقدار الإثم الجنائي، فعندما عرض عليها أمر جريمة الاتفاق الجائي كجريمة مستقلة تقوم بغض النظر عن اتمام الجريمة الجنائية من عدمه ، نظرت من بين عناصر التأثيم إلى خطورة الجزاء الجنائي ، وعدم تناسبه مع خطورة الفعل، وخلصت إلى أن : " قضاء هذه المحكمة جري علي أن شرعية الجزاء - جنائيا كان أم مدنيا أم تأديبيا - مناطها أن يكون متناسبا مع الأفعال التي أتمها المشرع أو حظرها أو قيد مباشرتها فالأصل في العقوبة هو معقوليتها فكلما كان الجزاء الجنائي بغيضا أو عاتيا أو كان متصلا بافعال لا يسوغ تجريمها أو مجافيا بصورة ظاهرة للحدود التي يكون معها متناسبا مع خطورة الأفعال التي اتمها المشرع فإنه يفقد مبررات وجوده ويصبح تقييده للحرية الشخصية اعتسافا متي كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة 48 من قانون العقوبات تقرر عقوبة السجن علي الاتفاق الجنائي علي ارتكاب جناية وكانت عقوبة السجن هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز ان تنقص عن ثلاث سنوات ولا أن تزيد علي خمس عشرة سنه إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا بينما هناك جنايات كثيرة حدد المشرع العقوبة فيها بالسجن مدة تقل عن خمس عشرة سنة كما تنص الفقرة علي أن عقوبة الاتفاق الجنائي علي ارتكاب الجنح هي الحبس أي وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه وحدها الأدني أربع وعشرون ساعة ولا تزيد علي ثلاث سنوات إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا بينما هناك جنح متعددة حدد المشرع العقوبة فيها بالحبس مدة تقل عن ثلاث سنوات وهو ما يكشف عن عدم تناسب العقوبات الواردة في الفقرة الثانية من النص المطعون فيه مع الفعل المؤثم ولا وجه للمحاجة في هذا المقام بأن الفقرة الرابعة من المادة 48 المشار إليها تقضي بأنه إذا كان محل الاتفاق جناية أو جنحة معينة عقوبتها أخف مما نصت عليه الفقرة السابقة فلا توقع عقوبة أشد مما نص عليه القانون لتلك الجناية أو الجنحة ذلك انما محل الاتفاق - كما سبقت الاشارة - قد يكون ارتكاب جناية او جنحة غير معينة بذاتها وعندئذ توقع العقوبات الواردة في الفقرة االثانية من المادة وحدها وهي تصل إلي السجن خمس عشرة سنة أو الحبس ثلاث سنوات - حسب الأحوال - ولا شك انها عقوبات مفرطة في قسوتها تكشف عن مبالغة المشرع في العقاب بما لا يتناسب والفعل المؤثم ." ([17]) وانتهت من ذلك إلى عدم دستورية نص المادة (48) من قانون العقوبات المؤثمة لهذه الجريمة.
تفريد العقوبة – عدم دستورية العقوبة ذات الحد الواحد
استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا على اعتبار العقوبة التي لا تتيح للقاضي التمييز بين مرتكبي الجريمة على أساس خطورتهم الإجرامية، وجسامة أفعالهم على تباينها هي عقوبة غير دستورية. إذ أنها توجب التسوية بين غير المتساويين ، وتحول دون تفريد العقوبة المستحقة لكل منهم. وقد حدث ذلك بمناسبة النظر في عقوبة جريمة البناء على أرض زراعية ، فقد أثم المشرع هذه الجريمة بالمادتين (152، 156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983، وحظر على المحكمة القضاء بوقف تنفيذ هذه العقوبة ، ورأت المحكمة في ذلك سببًا لعدم الدستورية ، وفي ذلك تقول : "إعتبار المتهمين نظراء بعضهم لبعض سواء فى نوع جريمتهم أو دوافعها أو خلفيتها ، لا يعدو أن يكون إخلالاً بشرط الوسائل القانونية السليمة التى لا يتصور فى غيبتها أن يكون للحق فى الحياة ، أو فى الحرية ، من قيمة لها إعتبارها ." ([18]) . وقد استقر هذا المبدأ في قضاء المحكمة الدستورية العليا حتى أنه عد من المبادئ الجوهرية لقضائها ([19])
تعدد الجزاءات بغير مبرر
كذلك فقد خلصت المحكمة إلى أن عدالة الجزاء توجب ألا تتعدد صور الجزاء على محل واحد بغير مبرر ، فقضت انطلاقًا من ذلك إلى أن "الأصل فى صور الجزاء ألا تتزاحم جميعها على محل واحد بما ينبو بها عن موازين الاعتدال ، وألا يتعلق جزاء منها بغير الأفعال التى تتخذ خواصها وصفاتها ، وبما يلائمها ، فلا يكون من أثره العدوان دون مقتض على حقوق الملكية الثابتة لأصحابها ، وكان ذلك مؤداه أن الجزاء لا يجوز أن يكون خطأ ، ولا فاسداً مغبة . بل ينبغى أن يوازن المشرع قبل تقريره ، بين الأفعال التى يجوز أن يتصل بها ، وأن يقدر لكل حال لبوسها ، فلا يتخذ من النصوص القانونية ما تظهر فيه مكامن مثالبها ، بل يبتغيها إسلوباً لتقويم أوضاع خاطئة وتصحيحها ." ([20]) وكان ذلك عقابًا على التهرب من أداء ضريبة المسارح والملاهي المقررة بالقانون رقم 221 لسنة 1951 إذ كان النص يعاقب على أفعال التهرب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها، إلا أنه أضاف إليه عقوبة إغلاق المحل مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما، ثم أضاف إليها التزام المخالف بأداء باقى الضريبة مع زيادة تساوى ثلاثة أمثالها تضاعف فى حالة العود. ([21])
دور المحكمة الدستورية العليا في تطوير الحقوق السياسية
لقد حرص الدستور على ضمان الحقوق السياسية ، فنصت المادة (5) من دستور سنة 1971، ([22]) على أن "يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية.
وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية وفقاً للقانون. ولا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية دينية أو أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل." ، كما نصت المادة (62) - على أن "للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفقاً لأي نظام انتخابي يحدده." ونصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أن " ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردي ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها، كما يجوز أن يتضمن حداً أدنى لمشاركة المرأة في المجلسين." ([23])
ويمكننا أن نلاحظ حرص المشرع الدستوري على إقرار أصل الحقوق السياسية التي يستوجبها أي نظام ديمقراطي في المجتمع الحديث من الحق في تكوين الأحزاب ، والحق في الانتخاب والترشح على أسس ديمقراطية.
أولا: تقييد سلطة المشرع في اختيار صورة النظام الانتخابي
وقد استقر القضاء الدستوري منذ نشأته على التسليم بسلطة المشرع التقديرية فى مجال تنظيم الحقوق ما لم تتصادم مع الضوابط التى وضعها الدستور. وأن للمشرع أن يتخير من البدائل المتاحة ما يراه أكثر ملاءمة ، وأوفق للواقع. وكان مؤدى استقرار هذه القاعدة أن يكون تنظيم المشرع لنظام الانتخابات أمر يدخل في نطاق السلطة التقديرية له. وهو يمارس عند اختياره بين البدائل المتاحة في النظم الانتخايبة المقارنة الحق في الاختيار الحر ، سواء اختار النظام الفردى أم نظام القوائم الحزبية طالما أن هذا التنظيم أو ذاك يعد من صور الاختيارات المتباينة التى تسود فى نظم الانتخابات العالمية.
ثانيًا - في حق المستقلين في الترشح
إلا أن الواقع السياسى المصرى فى فترة عمل دستور سنة 1971، شهد تقييدًا شديدًا لإجراءات إنشاء الأحزاب السياسية، الأمر الذى جعل الأحزاب المرخص لها لا تعبر عن حقيقة الرأى العام فى المجتمع، ولا تستوعب الاتجاهات الفكرية المختلفة الموجودة فى شرائحه الفكرية والسياسية، فضلا عن أن تضييقًا حدث على مكنة الأحزاب المصرح بها في اتصالها بالجماهير بما يؤثر على شعبيتها . ولقد لعب النواب المستقلون – غير المنتمين للأحزاب – دورًا بارزًا فى تنشيط العمل السياسى فى البرلمان وإنعاشه، والعمل على طرح الأفكار الشعبية غير الممثلة فى الأحزاب المرخص لها، وإذ عرض نظام الانتخاب بالقائمة على المحكمة الدستورية العليا وكان نظامًا يقوم بالأساس على الانتخاب بالقائمة إلا أنه يعطى المستقلين حق الترشح على (48) مقعد فقط فى دوائر شديدة الاتساع على مستوى الجمهورية، مقابل ما يزيد عن أربعمائة مقعد للقوائم الحزبية، ، فقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذا التنظيم لما اعتوره من إهدار حق المستقلين فى النفاذ إلى البرلمان، فقضت المحكمة فى القضية رقم 37 لسنة 9 قضائية "دستورية" بجلسة 19 مايو 1990 بعدم دستورية نص المادة الخامسة مكررًا من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 188 لسنة 1986 فيما تضمنته من أن يكون لكل دائرة كلية عضو واحد يتم انتخابه عن طريق الانتخاب الفردى. واستندت فى ذلك أن الدستور فى المادتين (40 ،62) منه نص على الحق في المساواة ، وحق كل مواطن في الانتخاب والترشح ، وأن إنكار حق المستقلين في الترشح وهم شريحة لا يستهان بها في المجتمع، أو تضييق فرصهم في التمثيل البرلماني من شأنه إهدار الحق في المساواة في فرص الترشح بين الحزبيين والمستقلين ، وأن الفرصة التى يوفرها النص المطعون عليه للمستقلين فرصة ضيقة لا تتعادل مع فرصة المرشح على القوائم. وقد ترتب على صدور هذا الحكم إبطال تكوين البرلمان "مجلس الشعب" ومن ثم حله وإعادة انتخابه على أسس تضمن مساهمة المستقلين.
وكان رائد المحكمة الدستورية العليا في هذا القضاء اتاحة الفرصة أمام جموع غفيرة من المواطنين لم تجد في الحياة الحزبية متنفسًا لأفكارها ، ولا سبيل للمشاركة السياسية إلا بتمكينها من الترشح وفقًا لنظام الفردي.
وقد كان لهذا القضاء أثر بالغ على الحياة السياسية ، وأقول عدم رضاء المؤسسات الحاكمة عن هذه النتيجة ، الأمر الذي أدى إلى ادخال تعديل على دستور سنة 1971 عام 2007 ، تضمن النص صراحة على أن "يجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردي ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها، كما يجوز أن يتضمن حداً أدنى لمشاركة المرأة في المجلسين." ([24])
ثالثًا - الإشراف القضائي على الانتخابات
فقد كان المجتمع المصرى إلى ما قبل سنة 2011 يئن من التلاعب فى العملية الانتخابية من قبل اؤلئك المنتدبين للإشراف على العملية الانتخابية، وقد كانت المادة (24) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية تنيط بوزير الداخلية تعيين أعضاء اللجان الفرعية بينما يتم تعيين رؤساء اللجان العامة من أعضاء الهيئات القضائية، وإذ طعن على هذا النص فى القضية رقم 11 لسنة 13 قضائية "دستورية"، فقضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 8 يوليو لسنة 2000 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (24) من ذلك القانون قبل تعديله بالقانون رقم 13 لسنة 2000 فيما تضمنه من جواز تعيين رؤساء اللجان الفرعية من غير أعضاء الهيئات القضائية مستندة فى ذلك إلى نص المادة (88) من الدستور التى أوجبت الإشراف على العملية الانتخابية من قبل أعضاء الهيئات القضائية، بحسبان أن عبارة الإشراف تتسع لمعنى الإشراف القريب وليس الإشراف من بُعد. وقد ترتب على هذا الحكم حل مجلس الشعب وإعادة الانتخابات تحت إشراف رجال القضاء، ، وقد شهدت هذه الانتخابات درجة غير مسبوقة من النزاهة خلال هذه الفترة الزمنية نتيجة استئثار رجال القضاء بالإشراف على العملية الانتخابية كلها. ولم تستطيع الحكومات في تلك الحقبة التاريخية الخروج من تبعة هذا الحكم إلا بتعديل الدستور سنة 2007 وإلغاء شرط الإشراف القضائى على الانتخابات.
ولعل هذه الاحكام تعكس مدى تأثير الظروف الاجتماعية المحيطة بتطبيق النص القانونى، فى تفعيل النص الدستورى على نحو يحقق المصلحة العامة ويوطد الحقوق الدستورية.
في الرقابة على المعاهدات الدولية
فقد كان دستور سنة 1971 ينص في المادة (151)، على التمييز بين المعاهدات التي لا يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة أو التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الموازنة منه على استئثار رئيس الجمهورية بابرامها ، ويكتفى في هذا الشأن بابلاغ مجلس الشعب بها ، وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة. وعلى خلاف ذلك فإن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة أو التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها.
وفي ظل هذا الدستور قضت المحكمة الدستورية العليا بأنه وإن كانت نظرية "الأعمال السياسية" - كقيد على ولاية القضاء الدستورى- تجد فى ميدان العلاقات والاتفاقيات الدولية معظم تطبيقاتها بأكثر مما يقع فى المجال الداخلى، نظراً لارتباط ذلك الميدان بالاعتبارات السياسية وسيادة الدولة ومصالحها العليا، لتسلم من حيث المبدأ بامتناع رقابة المعاهدات الدولية باعتبارها من اعمال السيادة. ([25])
ولقد صدر دستور سنة 2014 ، ونص في المادة (151) على تنظيم إبرام المعاهدات الدولية ، وأنه وإن اسند الاختصاص في ابرام المعاهدات كأصل عام إلى رئيس الدولة ، إلا أن الدستور ميز بين أنواع ثلاثة، أولها يتطلب موافقة البرلمان عليها ، وهي المعاهدات التي لا تخالف الدستور ولا تتعلق باحكام السيادة ولا تنطوي على تنازل عن اقليم الدولة. أما معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة فقد استوجب الدستور دعوة الناخبين للاستفتاء عليها ، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، أما النوع الثالث فقد حظر الدستور إبرامه بصورة مطلقة وهو متى كانت المعاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن اى جزء من إقليم الدولة. فصار هناك ثلاث احكام للمعاهدات ، المحظور منها وهو ما انطوى على ما يخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.
وقد عرض أمر معاهدة سياسية في دعوى تنازع بين أحكام القضاء المدني والإداري ، فقضت المحكمة بعدم جواز تدخل القضاء برقابة المعاهدات الدولية قبل التصديق عليها اعمالا للنصوص القانونية التي تدخلها في أعمال السيادة. إلا أنه متى نُشرت المعاهدة وفقًا للأوضاع المقررة فى الدستور، وأصبح لها قوة القانون، جاز مراقبتها قضائيًّا من قبل المحكمة الدستورية العليا من وجهين، الأول : رقابة استيفائها للشروط الشكلية المقررة فى الدستور، الثانى: الرقابة الموضوعية للمعاهدة، وهى رقابة تجد موجباتها فى نص الفقرة الأخيرة من المادة (151) من الدستور، التى حظرت مخالفة المعاهدة لأحكام الدستور كافة، وهذه الرقابة القضائية على المعاهدات، من وجهيها، هى رقابة دستورية لا مشروعية، وهى، بهذه المثابة، منوطة استئثارًا بالمحكمة الدستورية العليا، لا تشاركها فيها جهة قضائية أخرى أيًّا كانت، وذلك متى اتصلت الدعوى الدستورية بها طبقًا لأحكام قانونها. ([26]) هكذا اسبغت المحكمة رقابتها على المعاهدات بعد ابرامها، لبيان مدى توافقها واحكام الدستور متخطية بذلك نظرية أعمال السيادة في مجال تطبيقها على المعاهدات.
هوامش:
([1]) حكم المحكمة المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 25 يونيو سنة 1983 ، في القضية رقم 3 لسنة 1 قضائية "دستورية" حيث قالت المحكمة "وحيث إن الدساتير المصرية المتعاقبة قد حرصت جميعها منذ دستور سنة 1923 على النص على مبدأ صون الملكية الخاصة وحرمتها باعتبارها فى الأصل ثمرة النشاط الفردى ، وحافزه على الإنطلاق والتقدم، فضلاً عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التى يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى . ومن أجل ذلك، حظرت تلك الدساتير نزع الملكية الخاصة جبراً عن صاحبها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون - المادة (9) من كل دستور سنة 1923 ودستور 1930 والمادة (11) من دستور سنة 1956 والمادة (5) من دستور سنة 1958 والمادة (16) من دستور سنة 1964 والمادة (34) من دستور سنة 1971-كما نص الدستور القائم صراحة على حظر التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض المادة (35). بل أنه إمعاناً فى حماية الملكية الخاصة وصونها من الاعتداء عليها بغير حق حظر هذا الدستور المصادرة العامة حظراً مطلقاً، كما لم يجز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى المادة (36).
لما كان ذلك، وكان استيلاء الدولة على ملكية الأراضى الزراعية الزائدة على الحد الأقصى الذى يقرره القانون للملكية الزراعية يتضمن نزعاً لهذه الملكية الخاصة بالنسبة للقدر الزائد جبراً عن صاحبها، ومن ثم وجب أن يكون حرمانه من ملكه مقابل تعويض، وإلا كان استيلاء الدولة على أرضه بغير مقابل مصادرة خاصة لها لا تجوز إلا بحكم قضائى وفقاً لحكم المادة (36) من الدستور.
([2]) من ذلك حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 16 مايو سنة 1981 ، في القضية رقم 5 لسنة 1 قضائية "دستورية" حيث قالت المحكمة : إن جميع الدساتير المصرية المتعاقبة حرصت على تأكيد حماية الملكية الخاصة وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء وفى الحدود وبالقيود التى أو ردتها، فنصت المادة الخامسة من دستور سنة 1958 على أن الملكية الخاصة مصونه ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون، وهو ما رددته المادة (16) من دستور سنة 1964 والمادة (34) من دستور سنة 1971، كما لم تجز المادة (35) من دستور سنة 1971 التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض.
ولما كانت أيلولة أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة إلى ملكية الدولة طبقاً للمادة الثانية من القرار بقانون رقم 150 لسنة 1964 لا تعد من قبيل نزع الملكية للمنفعة العامة الذى لا يرد إلا على عقارات معينة بذاتها فى حين شملت الأيلولة إلى ملكية الدولة أموال وممتلكات من فرضت عليهم الحراسة بما فيها من منقولات، ولم تتبع فى شأنها الإجراءات التى نصت عليها القوانين المنظمة لنزع الملكية والتى يترتب على عدم مراعاتها اعتبار الإجراء غصباً لا يعتد به ولا ينقل الملكية إلى الدولة ، وكانت هذه الأيلولة لا تعتبر تأميماً ذلك أنها تفتقر إلى أهم ما يتميز به التأميم وهو انتقال المال المؤمم إلى ملكية الشعب لتسيطر عليه الدولة بعيداً عن مجال الملكية الخاصة بحيث تكون إدارته لصالح الجماعة ، بينما امتدت الحراسة - وبالتالى الأيلولة إلى ملكية الدولة - إلى كافة أموال وممتلكات من فرضت عليهم الحراسة بما تشمله من مقتنيات شخصية يستحيل تصور إدارتها لصالح الجماعة ، كما أن المادة الرابعة من ذات القرار بقانون رقم 50 لسنة 1964 تنص على تسليم الأراضى الزراعية التى آلت ملكيتها إلى الدولة إلى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى لإدارتها".......... حتى يتم توزيعها وفقاً لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952" بشأن الاصلاح الزراعى ، وبالتالى فإن مآل هذه الأراضى أن تعود إلى الملكية الخاصة لمن توزع عليهم ولا تبقى فى ملكية الشعب لتحقق إدارتها ما يستهدفه التأميم من صالح عام. لما كان ذلك فإن أيلولة أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة إلى ملكية الدولة التى تقررت أول الأمر بالقرار بقانون رقم 150 لسنة 1964 على ما سلف بيانه، تشكل اعتداء على الملكية الخاصة ومصادرة لها بالمخالفة لحكم كل من المادة (34) من الدستور التى تنص على أن الملكية الخاصة مصونة ، والمادة (36) منه التى تحظر المصادرة العامة ولا تجيز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى .
لما كان ما تقدم وكان القانون رقم 69 لسنة 1974 وضع لحمايتها ضوابط وقواعد محددة ، الأمر الذى يحتم إخضاعهما لما تتولاه هذه المحكمة من رقابة دستورية ، وكان القانون رقم 52 لسنة 1972 الذى نص على تسوى وضاعهم برد بعض أموالهم عيناً أو ثمن ما تم بيعه منها وذلك فى حدود مبلغ ثلاثين ألف جنيه للفرد ومائة ألف جنيه للأسرة ، فإنه يكون بما نص عليه من تعيين حد أقصى لما يرد من كافة الأموال والممتلكات التى فرضت عليها الحراسة قد انطوى على مخالفة لأحكام دستور سنة 1971 الذى لا يجيز تحديد حد أقصى إلا بالنسبة للملكية الزراعية طبقاً للمادة (37) منه الأمر الذى يتضمن بدوره مساساً بالملكية الخاصة بالمخالفة لحكم المادة (34) من الدستور سالف البيان.
كذلك الحكم الصادر بجلسة 5 /3/ 1994، في الدعوى 98 لسنة 4 ق دستورية حيث قضت بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 141 سنة 1981 فيما تضمنته من النص على " وبالنسبة للأشخاص الذين غادروا البلاد مغادرة نهائية ولم يعودوا إلى الإقامة فيها خلال المدة المنصوص عليها في القانون رقم 69 لسنة 1974 المشار اليه ، فيعوضون عن تدابير الحراسة طبقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1971 وفي الحدود المنصوص عليها فيه.
كما قضت بجلسة 06/06/1998 ، في الدعوى 28 لسنة 6 ق دستورية أولا : بعدم دستورية مانصت عليه المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 سنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى ، من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه ، وفقا لأحكام هذا القانون الحق فى تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض ، وأن تقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة بها الأرض ، وبسقوط المادة (6) من هذا المرسوم بقانون فى مجال تطبيقها فى شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية • ثانيا : بعدم دستورية مانصت عليه المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 سنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه تنفيذا لأحكام هذا القانون الحق فى تعويض يقدر وفقا للأحكام الواردة فى هذا الشأن بالمرسوم بقانون رقم 178 سنة 1952 المشار إليه وبمراعاة الضريبة السارية فى 9 سبتمبر سنة 1952 ، وبسقوط المادة الخامسة من هذا القرار بقانون فى مجال تطبيقها فى شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية.
([3]) حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 27/5 / 1992، في القضية رقم 25 لسنة 11 قضائية "دستورية " الجزء الخامس المجلد الأول ص 364.
([4] ) حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 105 لسنة 24 قضائية "دستورية "بجلسة 7/3/2004 الجزء الحادي عشر المجلد الأول ص485 .
([5]) حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 3 / 11 / 2002، في القضية رقم 105 لسنة 19 ق بدستورية المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981.
([6]) حكم المحكمة الصادر بجلسة الخامس من مايو سنة 2018م في القضية رقم 11 لسنة 23.
([7]) حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 1 /2/ 1997، في القضية رقم 7 لسنة 16 قضائية دستورية .
([8]) والحق أن هذا الحكم لا يمكن اعتباره كاشفا عن مذهب مستقر للمحكمة في التفسير، وإنما هو في حقيقة الأمر كان خروجا على مذهب المحكمة المسقر على تفسير النصوص الدستورية في ضوء مضمونها الحقيقي باعتبار الإرادة المستخلصة من عباراتها.
([9]) حكم المحكمة العليا الصادر بجلسة 3 / 7 /1976 في القضية رقم 5 لسنة 5 – دستورية.
([10]) حكم المحكمة الصادر بجلسة 3 إبريل سنة 1993م في القضية رقم 2 لسنة 14 قضائية دستورية. وجلسة 15 مايو سنة 1993 القضية رقم 15 لسنة 14 قضائية "دستورية "
([11]) حكم المحكمة الصادر بجلسة 7 / 4 / 2013، في القضية رقم 162 لسنة 31 قضائية دستورية.
[12] حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 2 / 1 / 1993، في القضية رقم 3 لسنة 10 قضائية دستورية. ج 5 / 2 ص 103.
([13]) جلسة 03 / 01 / 1998 الدعوى رقم 29 لسنة 18 قضائية ج 8 صفحة رقم 1042
([14]) حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 02 / 12 / 1995 في القضية رقم 28 لسنة 17 قضائية “ دستورية” الجزء 7 صفحة رقم 262.
([15]) حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 3 يوليو سنة 1995، في القضية رقم 25 لسنة 16 قضائية "دستورية" الجزء 7 صفحة رقم 45. وكذا حكمها الصادر بجلسة 01 / 02 / 1997، في القضية رقم 59 لسنة 18 قضائية “ دستورية" الجزء 8 صفحة رقم 286.
([16]) حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 3 يوليو سنة 1995، في القضية رقم 25 لسنة 16 قضائية "دستورية" الجزء 7 صفحة رقم 45. وكذا حكمها الصادر بجلسة 01 / 02 / 1997، في القضية رقم 59 لسنة 18 قضائية “ دستورية" الجزء 8 صفحة رقم 286.
([17]) القضية رقم 114 لسنة 21 قضائية “ دستورية” الحكم الصادر بجلسة 02 / 06 / 2001 ، الجزء 9 صفحة رقم 986.
([18]) القضية رقم 37 لسنة 15 قضائية “ دستورية” الحكم الصادر بجلسة 03 / 08 / 1996 ، الجزء 8 صفحة رقم 67.
([19]) يراجع على سبيل المثال حكم المحكمة الصادر بجلسة 8 نوفمبرسنة 2014، في القضية رقم 196 لسنة 35 قضائية دستورية، الجزء 15 /1 ص 330. وكانت الدعوى تتعلق بحرمان المحكمة الجنائية في جرائم حيازة وإحراز السلاح بدون ترخيص من استخدام قواعد الرأفة المنصوص عليها في المادة (17) من قانون العقوبات.
[20] - جلسة 06 / 06 / 1998، القضية رقم 152 لسنـــة 18ق " دستورية "–الجزء الثامن ص 1365.
[21] وعين الأمر في العديد من الأحكام ، يراجع على سبيل المثال الحكم الصادر بجلسة 5 / 3 / 2016، في القضية رقم 289 لسنة 24 قضائية "دستورية".
([22] ) معدلة طبقاً لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذي أجرى في يوم 22 من مايو سنة 1980 ، وكان النص الأصلي عند صدور الدستور يجري على أن :
" الاتحاد الاشتراكي العربي هو التنظيم السياسي الذي يمثل بتنظيماته القائمة على أساس مبدأ الديمقراطية تحالف قوى الشعب العاملة من الفلاحين والعمال والجنود والمثقفين والرأسمالية الوطنية. وهو أداة هذا التحالف في تعميق الديمقراطية والاشتراكية، وفي متابعة العمل الوطني في مختلف مجالاته، ودفع هذا العمل الوطني إلى أهدافه المرسومة.
ويؤكد الاتحاد الاشتراكي العربي سلطة تحالف قوى الشعب العاملة عن طريق العمل السياسي الذي تباشره تنظيماته من الجماهير، وفي مختلف الأجهزة التي تضطلع بمسئوليات العمل الوطني.
ويبين النظام الأساسي للاتحاد الاشتراكي العربي شروط العضوية فيه وتنظيماته المختلفة، وضمانات ممارسة نشاطه بالأسلوب الديمقراطي، على أن يمثل العمال والفلاحون في هذه التنظيمات بنسبة خمسين في المائة على الأقل."
([23] ) الفقرة الثالثة مضافة بموجب إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور الذي جرى بتاريخ 26/3/2007 .
([24] ) معدلة طبقاً لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذي أجرى في يوم 26 من مارس سنة 2007 . وكان النص قبل تعديله يجري على أن :
" للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني."
(([25] يراجع على سبيل المثال حكم المحكمة الصادر بجلسة 19 / 6 / 1996 في القضية رقم 10 لسنة 14 قضائية دستورية .
([26]) حكم المحكمة الصادر بجلسة 3/ 3/2018، في دعوى التنازع رقم 12 لسنة 39 قضائية .