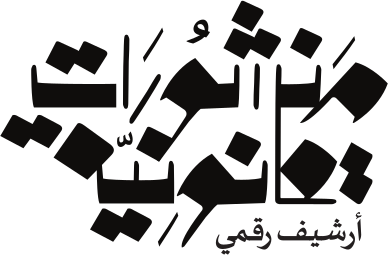"نظرية كل شيء".. طارق البشري منظرًا للتيار الوطني الديمقراطي المحافظ
* الكاتب: عمرو عبدالرحمن - مسئول البحوث بوحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة
أبعد من حديث التحولات… مقدمة:
برحيل الأستاذ طارق البشري، يفقد التيار الوطني الديمقراطي المحافظ في مصر أهم منظريه السياسيين والقانونيين منذ ثورة يوليو ١٩٥٢ بلا منازع، وهو منظر عبّر عن الأفكار الأساسية لهذا التيار، وتناقضاتها، بوضوح مذهل، كما أورث هذه التناقضات لطيف واسع من الجماعات التي تأثرت به خلال فترة حكم مبارك وحتى ثورة ٢٠١١. وهذه الرؤية المحافظة للوطنية والديمقراطية ليست محض توفيق بين نزعات مختلفة قام عليها مفكر يساري سابق تحول للمعسكر الإسلامي. فمسار الرجل الفكري لا يمكن اختزاله في هذه الثنائيات والانقطاعات الدرامية التي يصورها الكثير من نقاده ومناصريه، بل إن عناصر الاستمرارية في فكره أكثر بكثير من عناصر القطيعة، ويمكن اكتشاف بذور آرائه اللاحقة، بعد تحوله الإسلامي، بسهولة في كتاباته اليسارية السابقة على هذا التحول.
وهنا نشدد أن إحجام الصفحات المقبلة عن تناول تقييم البشري نفسه لمساره الفكري، والذي عبر عنه بعبارات القطيعة والتحول، ليس مردّه الاستهانة بتأملات الرجل أو التعسف في تأويلها على غير ظاهرها. ولكنني أحجم عن ذلك لاعتبارين منهجيين. الأول، هو أن هذه المقالة ليست بسيرة ذاتية فكرية للراحل، فتلامذته المباشرين ومن اقتربوا منه - ولم أكن منهم مع الأسف - أولى بذلك. ولا يمكن أن يتصدى من لم يعرف مفكرًا عن قرب للتعليق على تقييم هذا المفكر لتجربته الشخصية في جوانبها الفكرية والشعورية. ولا يمكن الاستعاضة عن هذه المعرفة الشخصية بحوارات مسجلة أو وثائقيات تتسم بالاجتزاء بحكم طبيعتها. الاعتبار الثاني، والأهم، أن المنتج الفكري - كما سنحاول التوضيح - ليس محض انعكاس لما يجول في عقل أو خاطر المفكر الفرد، وليس تعبيرًا مباشرًا صافيًا عن تجربته الشعورية، ولكنه لحظة من لحظات تشكل خطابات اجتماعية، أي أطر مفاهيمية لإدراك الظواهر الاجتماعية وفهمها وتفسيرها والحكم عليها. وهي عملية تمتد في الزمان بشكل سابق ولاحق على عمل المفكر الفرد، و تتداخل في إنتاجها، كأي عملية إنتاج، عوامل متعددة تتجاوز إرادته. ويصبح للمنتج الفكري، والحال كذلك، حياة خاصة به بمجرد خروجه للنور يمكن تتبعها بوضع النص في سياقه الاجتماعي والفكري التاريخي، وفهم الإشكاليات التي تكوّن للتعاطي معها، والموقع الاجتماعي الذي احتله المفكر الفرد لمقاربة هذه الإشكاليات.
وفيما يخص السياق التاريخي، فالبشري هو ابن مرحلة التحرر الوطني في طورها الناصري بامتياز. تحددت الخطوط العريضة لفكره بالتفاعل مع الإشكاليات التي تبلورت خلال هذه المرحلة، سواء خلال فترة النجاحات الأولية للنظام الناصري مع حرب السويس ١٩٥٦ أو بعد هزيمته العسكرية والسياسية في ١٩٦٧. وعلى وجه التحديد، فقد تراكم إنتاج البشري للإجابة على سؤالين أساسيين، وهما على الترتيب: كيف يمكن إبداع ثقافة وطنية جامعة تدعم من الاستقلال القانوني و السياسي؟ وكيف يمكن استعادة جهاز الدولة لدوره المفترض في التعبير عن وحدة الأمة حديثة الاستقلال بعد أن وجهته الفئات الحاكمة عقب هزيمة ١٩٦٧ وجهة بعيدة عن هذا الهدف؟ وهو قد قارب كلا السؤالين من خلال موقع مرصود للمثقف، تبلور بدوره خلال نفس الفترة، ويرتسم حول حدين: إما مثقف عضوي[1] يسهم بشكل فني، لا سياسي، في إدارة المصالح في المجتمع (قاضيًا، وإداريًا، ونقابيًا، وبالطبع مسئولًا في تنظيم أوحد…إلخ)، أو مثقف عام يعبر عن مصالح وأهداف الشعب الموحد بلا وسيط تنظيمي كذات متعالية فوق الطبقات والانقسامات السياسية الضيقة، ولا تتبع إلا ما يمليه عليها ضميرها (كاتبًا ومعلمًا وواعظَا…إلخ). ينظر المثقف في الحالتين للمعضلات الكبرى بعين الدولة سواء كجهاز يتعاطي مع المجتمع ككتلة واحدة من المصالح الاقتصادية القابلة للتوفيق، أو كمثال متخيل لوحدته الوطنية التي لا تعرف التناقضات الصراعية؛ وفي الحالتين، يدين المثقف بفهمه لموقعه ودوره لتوسع جهاز الدولة واستقلاله النسبي الطارئ في مواجهة الطبقات الاجتماعية.
تصورات البشري المحافظة، والحال كذلك، لم تتطور كانقطاع أو تحول، ولكنها تشكلت بالأحرى للدفاع عن مشروع الدولة ذاك في مواجهة كل من التحول اليميني الفج في السبعينيات - وما أدى إليه من هيمنة فئات رأسمالية تابعة على جهاز الدولة - وردود الأفعال الجذرية على هذا التحول والتي سعت لتجاوز مشروع الدولة الوطنية الحديثة بالمجمل باتجاه تصورات بديلة عن الاجتماع السياسي. بعبارة أخرى، البشري هو أحد أصوات المعارضة الوطنية المحافظة الساعية لحفظ تماسك الدولة الوطنية، واستعادة استقلاليتها النسبية في مواجهة الطبقات، وقدرتها على التعبير عن الغالبية العظمى، وذلك عبر مقرطة آليات عملها ومصالحتها على ما تراه تلك الأصوات ثقافة هذه الغالبية المحكومة بالتاريخ الإسلامي.
وهذا الصوت ما كان يمكن أن يتصدى لبلورته إلا مثقف كالبشري جمع في تكوينه جناحي التصور الرسمى المهيمن عن دور المثقف. فهو من زاوية أولى -وبحكم عمله القضائي- مثقف عضوي ينتمي لجهاز الدولة لا يمكن أن يفكر خارج إطاره، وهو من زاوية ثانية مثقف وطني عام تشرّب تصورًا للوحدة الوطنية متعالٍ على الانقسامات الطبقية والسياسية، بما يضمن له تلقائيًا سلطة النطق بصوت الجماعة الوطنية ككل، وشرعية النقد لمديري جهاز الدولة وخصومهم على حد سواء. ومن داخل هذا الموقع المركب تكثّفت جملة من التناقضات التي تخللت مقاربات الرجل لمسألتي الوطنية والديمقراطية، فانتهت به إلى الاستبعاد من حيث أراد الإجماع، وإلى استدعاء آليات الدولة السلطوية لصياغة مضمون وحدود الحريات من حيث أراد تقييد هذه الآليات.
سنحاول في الصفحات القادمة استعراض تطور فكر البشري كمسار متصل، وتقديم قراءة نقدية لأطروحاته الأساسية في ضوء افتراضنا المذكور أعلاه عن تعبيره عن التيار الوطني الديمقراطي المحافظ. سنبدأ بشرح مفهومنا عن موقع المثقف الوطني الذي شغله البشري، وأوجه اختلافه عن غيره من فئات المثقفين في المجتمع الرأسمالي بشكل عام وفي مصر. ثم نتعرض للسياق التاريخي الاجتماعي الذي ظهر فيه إنتاج البشري بهدف استكشاف أثره الممتد على فكره، ونركز هنا خصوصًا على فكرة الثقافة الوطنية كإشكالية مهيمنة على منتج الكثيرين غيره من اليمين واليسار في هذا الوقت، وأوجه تميز طرحه بشأنها. سننتقل بعد ذلك إلى استعراض رؤيته لمضمون هذه الثقافة الوطنية ومحورية الخبرة التاريخية الإسلامية في تشكيلها، ومنهجه المطروح للعمل السياسي والتجديد القانوني كآليات لاستنبات العناصر الوطنية والديمقراطية من داخل هذه الثقافة، وفرض هيمنتها على جهاز الدولة الحديث. بعد ذلك، سنحاول بلورة نقدنا الأساسي لأطروحات البشري عبر إبراز تناقضاتها الداخلية التي وسمت كل من رؤيتها التاريخية ومنهجها المقترح للتجديد، مع التركيز على إسهامه في بلورة الأفق الفكري لثورة يناير كلحظة تكثفت فيها تناقضات أطروحاته. ونختتم بوضع مجمل إنتاج البشري في مقارنة سريعة مع إنتاج مجايليه من اليسار الوطني أو خلفائه من مثقفين إسلاميين جُدد سعوا للبناء على أطروحاته وتجاوزها في نفس الوقت.
عن المثقفين عمومًا، والمثقف الوطني خصوصًا:
بدأ البشري عمله على خلفية سيادة تصور للإنتاج الثقافي يمكن وصفه بالوطني الإدماجي.
تشكل هذا التصور مع بداية ستينيات القرن الماضي بعد تحطيم سلطة كبار ملاك الأرض، والرأسماليين المرتبطين بهم، ومجالهم السياسي السابق الذي تم تحميله قسمًا كبيرًا من المسئولية عن الفشل في إنجاز الاستقلال السياسي الكامل والبدء في عملية تنمية تضع مصر في مصاف الدول الناهضة. جرى ذلك بإلغاء الأحزاب وإصدار قوانين العزل السياسي وتأسيس محاكم الثورة وتهميش دور السلطتين التشريعية والقضائية، ثم في مرحلة لاحقة بدمج جميع المؤسسات المدنية العامة من نقابات واتحادات عمالية وجمعيات أهلية في أجهزة هرمية موحدة الهدف منها توحيد الجمهور، بعد إقصاء من كانوا سببًا في شرذمته، وحلّ تناقضاته بشكل تصالحي تحت قيادة مُركّزة بالكامل في مؤسسة الرئاسة.
وسرى على مجال الإنتاج الثقافي بالطبع ما سرى على باقي المجالات من دمج، سواء في الجامعات أو عبر تأميم الصحافة و دور النشر و شركات الإنتاج الفني. والدور الذي أوكل للمثقفين في الدعاية الرسمية للنظام مع بداية الستينيات هو إبداع ثقافة وطنية جديدة، أي جملة من المبادئ الموجهة والأخلاقيات التي تدعم جهود نخبة الحكم الجديدة في سبيل الاستقلال والتنمية، و تعبر عن حالة الوحدة المفترضة المعادية للاستعمار الغربي، قديمه وجديده، ولوكلائه السابقين واللاحقين.
كما أن هذه الثقافة الجديدة كانت مطلوبة كذلك لمواجهة “دعاة الانقسام الداخلي” من اليمين الديني، أو اليسار الماركسي. فكلا التيارين اعتُبرا دخيلين على حالة الوحدة الشعبية الجديدة: الأول بسبب إحيائه لنعرات طائفية موغلة في القدم تجاوزها المجتمع، والثاني بسبب غربة أفكاره المتعلقة بالصراع الطبقي عن تاريخ و ثقافة الأغلبية العظمى من الشعب. تحول المثقف إذن في هذا التصور لوكيل حصري لنخبة الحكم الوطنية، يدين لها بالمساحة المتاحة لعمله، كما يعمل بشكل فني ووطني متجرد - لا حزبي ولا طبقي - ولا يطرح إلا ما يراه حقيقة فنية مصدرها العلم، أو رؤية مخلصة غير منحازة تُستنبط من استقراء وقائع التاريخ.
يتحدث ميثاق العمل الوطني الاشتراكي مثلًا الصادر في ١٩٦٢، والذي يمكن اعتباره البيان الأكثر تعبيرًا عن رؤية النخبة الحاكمة في هذه المرحلة عن الحاجة لثقافة وطنية جديدة، في صدر مقدمته يقول “فإن الشعب المصرى تحت ظروف هذه المعارك الثورية المتشابكة المتداخلة كان مصراً على أن يستخلص للمجتمع الجديد الذى يتطلع إليه علاقات اجتماعية جديدة؛ تقوم عليها قيم أخلاقية جديدة، وتعبر عنها ثقافة وطنية جديدة”. ويفصلّ في الباب الخامس تحت عنوان “الديمقراطية السليمة” تصوره عن إمكانية وضرورة الحلول السلمية للمتناقضات بين صفوف الشعب، فيقول “إن إزالة هذا التصادم يفتح الطريق للحلول السلمية أمام صراع الطبقات. إن إزالة التصادم لا يزيل المتناقضات بين بقية طبقات الشعب، وإنما هو يفتح المجال لإمكانية حلها سلمياً؛ أى بوسائل العمل الديمقراطى، بينما بقاء التصادم لا يمكن أن يحل بغير الحرب الأهلية، وما تلحقه من أضرار بالوطن؛ فى ظروف يشتد فيها الصراع الدولى، وتعصف فيها عواصف الحرب الباردة”.كما يستفيض في بابه الثامن عن التطبيق الاشتراكي ومشاكله في شرح تصوره لدور المثقفين كوكلاء لرؤية النخبة الحاكمة سواء كمديرين ومنفذين أو كدعاة ومفكرين ونقاد. يقول في هذا المقام مثلًا “إن فلسفة العمل الوطنى يجب أن تصل إلى جميع العاملين فى الوطن فى كافة المجالات، بل ويجب أن تصل إليهم بالطريقة الأكثر ملاءمة بالنسبة لكل منهم، إن ذلك يكفل دائماً أن يكون الفكر على اتصال بالتجربة، وأن يكون الرأى النظرى على اتصال بالتطبيق التجريبى، إن الوضوح الفكرى أكبر ما يساعد على نجاح التجربة، كما أن التجربة بدورها تزيد فى وضوح الفكر وتمنحه قوة وخصوبة تؤثر فى الواقع وتتأثر به، ويكتسب العمل الوطنى من هذا التبادل الخلاق إمكانيات أكبر لتحقيق النجاح، وإنه لمن ألزم الأمور هنا تشجيع الكلمة المكتوبة لتكون صلة بين الجميع يسهل حفظها للمستقبل، كما أنها تستكمل حلقة هامة فى الصلة بين الفكرة والتجربة”. [2]
هذا الفهم لطبيعة الإنتاج الثقافي، ودور المثقفين، قديم بالطبع وسابق على ثورة يوليو. وهو نتاج توحيد نزعتين فكريتين نشآ وتطورا بالارتباط مع نشأة العلاقات الرأسمالية وتطور الدولة الحديثة. النزعة الفكرية الأولى هي النزعة الوطنية التي ترى في المصريين أمة، أو جماعة متميزة تاريخيًا بالمعنى الثقافي عن غيرها من الجماعات، خصوصًا تلك التي انتمت للحيز السياسي العثماني، ومن ثم يحق لها الاستقلال بحكم نفسها جريًا على المبدأ السائد في العالم في هذا الوقت. والنزعة الثانية هي النزعة العلموية التي ترى في المجتمع بناء ناتج عن عمليات موضوعية يمكن عزلها و فهمها بدقة، ومن ثم التحكم فيها بمنطقها على النحو الذي يقضي علي الأزمات الاجتماعية التي يواجهها البشر في هذا الحيز.
تغذى بالطبع كل تيار من الآخر: فاعتمد التصور الثقافي للجماعة الوطنية المصرية على إنجازات علماء التاريخ واللغات والقانون، وفي مرحلة لاحقة علماء الاجتماع، بينما قدم التصور الوطني لأصحاب النزعة العلموية مادتهم إن جاز التعبير، أو الحيز الذي يتطابق مع النظريات العلمية السائدة في وقت كان يتم التعامل فيه مع العالم كجسم مشكل حصرًا من وحدات من الجماعات القومية. وبينما تُرك التعبير السياسي المنظم عن النزعة الوطنية للأحزاب والجماعات السياسية، بقيت النزعة العلموية تتطور وتهيمن ببطء وثبات على الجامعات ومؤسسات الإدارة.
ومع نهاية عقد العشرينيات، وظهور أزمات المجال السياسي التعددي الهش الذي أفرزته ثورة ١٩١٩، بدأت تتداخل كلا النزعتين مولدة موقفًا جديدًا وطنيًا مجردًا يتحسس تجاه الحزبية، بل يحملها المسئولة عن الحيلولة دون تدفق النزعة العلمية في أوصال الدولة وانتشال المجتمع من تخلفه. هكذا ظهرت الدولة المستقلة عن المجال السياسي كمثال تطمح إليه طائفة من المثقفين تكبر مع الوقت دون الاهتمام بالضرورة بكيفية تحقيق هذا الهدف. فعمل أسلاف المثقف الوطني الأوائل مثلًا تحت إمرة عدد من أشد الحكومات استبدادية، كما عملوا مع بعض الحكومات المنتخبة ديمقراطيًا،[3] والمعيار الوحيد الموجه لخياراتهم كان هو قدرة هذه الحكومات على التمايز عن أنواء المجال السياسي، وإتاحة الفرصة للمثقف المخلص الذي لا يدين برأيه إلا لضميره وعلمه ووطنيته. وهذا الموقع الجديد سمح بتمازج جماعات قادمة من خلفيات اجتماعية متباينة في فئة اجتماعية متميزة. لا يدين هذا المثقف بموقعه لحزب أو جماعة سياسية أو شركة أو صحيفة بقدر ما يدين بهذا الموقع لإمكانيات أتاحها جهاز الدولة، ومن ثم فمن الطبيعي أن ينتقل بسلاسة للوكالة لهذا الجهاز طالما تديره مجموعة تنأى به عن تجاذبات الصراعات الاجتماعية.
خصوصية التحول الذي أنجزته ثورة يوليو إذن لا تكمن في اختراع مفهوم الثقافة الوطنية أو المثقف الوطني من العدم، ولكنها تكمن في رفعه لمرتبة التعريف المحدِد للثقافة والمثقف، وضمان هيمنته الأخلاقية على ما سواه، وإتاحة الإمكانيات المادية اللازمة لتحققه على أرض الواقع. وسيادة هذا التصور يعد مسئولًا عن ميول مستمرة معنا حتى اليوم مثل الترفع على الحزبية، والاحتفاء الدائم بالاستقلالية كأحد معايير تقييم الإنتاج الفكري، حتى ذلك الذي يتعلق بكيفية تنظيم الحكم أو السلطة السياسية في المجتمع، وهو كذلك ما حكم على استراتيجيات المثقف الوطني المقترحة أن تخاطب دائمًا طرفًا آخر في قمة السلطة، سواء كان مهيمنًا أو مهمشًا، أو حتى متوهمًا، فالخيال هنا لا يتسع إلى ماهو أبعد من ذلك.
وبالتوازي، جرى استيعاب المثقف الديني التقليدي في حين توارى المثقف القائد أو “المُنظِم” - كما يسميه جرامشي. المثقف التقليدي، من جهة أولى، اعتمد في وجوده تاريخيًا على جماعات محلية قدمت الإمكانية المادية لعمله وظل اعتماده على السلطة السياسية بالغ المحدودية، في حين أن إنتاجه المعرفي كان يتشكل من داخل خيال لا يعترف بالحدود القومية الجديدة ويمتد في زمانه الخاص من نقطة ظهور الوحي وحتى اللحظة الراهنة. استوعبت الدولة هذا المثقف داخل أجهزتها من خلال مسار طويل من التحديثات المؤسسية حتى أصبح المثقف الديني عمليًا في خدمة الدولة الحديثة وتصورها المكاني عن الحيز الجغرافي لسلطتها والزماني لتاريخ جماعتها المحكومة. وتمحور دوره الجديد حول الإسناد الشرعي لأفعال الدولة - في حقلي القانون والفتوى - أو المساهمة في الضبط الأخلاقي العام، أو إنتاج المعرفة اللازمة لذلك، من داخل حقل تخصصه. والمرحلة الناصرية مثلت بالطبع قمة هذا التوجه الاستيعابي مع قوانينها المتعاقبة “لإصلاح الأزهر” التي أتمت عملية إدماجه الكامل تحت سلطة الفئات الحاكمة الجديدة وقلصت من استقلاليته المالية والإدارية.
المثقف المنظِم، في المقابل، لا يمكن أن يحيا إلا في مجال عام وسياسي مفتوحين. فهو لا يتحدث بلغة الحقائق الفنية أو التاريخية، ولكن يصك رؤاه بشكل منحاز علنًا في سياق صراعات الهيمنة في المجتمع المدني. يسعى المثقف المنُظِم لبلورة هويات وأخلاقيات و مشاريع سياسية أو فكرية لطبقات، أو تحالفات اجتماعية بعينها، داخل جسم الجماعة الوطنية- مشاريع تتجاوز المصالح الاقتصادية الضيقة وتستهدف السيطرة على سلطة الدولة تحت راية رؤيتها الخاصة للمصلحة الوطنية العامة.[4] ومن هذا الموقع المنحاز يحكم المثقف على ما يقدم نفسه للفكر “كحقائق” ويوظفها في مشروعه - فالحقيقة لديه ليست نقيض الانحياز أو الهوى، ولكنها لحظة في تشكيل وتدعيم هذا الانحياز.
وبالطبع، تتشابه أدوار المثقفين - الوطني والقيادي- أخذًا في الاعتبار طبيعة النشاط المنتج نفسه واستحالة وجود موقف غير منحاز اجتماعيًا، أو غير متورط في دعم هيمنة طبقة أو تحالف اجتماعي بعينه. الموقف الوطني المجرد مثلًا لقادة حركة الظباط الأحرار بُنى على تصور عن مكونات بعينها للجماعة الوطنية واستبعاد أخرى. ولكن الفارق بين مثقفنا الوطني والمثقف المُنظِم هو تحديدًا في الوعي بالانحياز، وإعلانه، والانطلاق منه بما يترتب عليه من اختلافات حاسمة في الرؤى ونمط الممارسة.
هذا الدور التنظيمي، أو القيادي، للمثقف قديم كذلك قدم الحداثة الرأسمالية في مصر، وتوزع على مجمل التيارات الفكرية والسياسية من اليمين لليسار، وصعد نجمه خصوصًا مع تفاقم أزمة النظام البرلماني الهش التي تحدثنا عنها في بداية الثلاثينيات. إلا أن شروط إنتاجه قد تآكلت مع إنجاز قدر ظرفي ومؤقت من استقلال جهاز الدولة النسبي عن الطبقات الاجتماعية بعد يوليو ١٩٥٢ و إغلاق المجال العام والسياسي وإلحاق مجال الإنتاج الثقافي بالكامل بالجهاز الأيديولوجي للدولة.
الثقافة الوطنية بين اليمين واليسار:
عمر استقلالية جهاز الدولة قصير بحكم التعريف. فلا يمكن لجهاز الدولة الإداري والأيديولوجي أن يبقى معلقًا في الفراغ طويلًا، فهو محكوم بأن تتجاذبه المصالح الاجتماعية المتبلورة سريعًا في حركتها. وداخل مؤسسات النظام الإدماجية ذاتها تبلور اليمين واليسار مرة أخرى. فالجماعات المحافظة التي ورثتها هذه المؤسسات من عالم ما قبل ١٩٥٢ أعادت تنظيم نفسها بهدف كبح الميل التحديثي والاشتراكي للنظام، وحماية رأس المال الخاص في التكوين الاجتماعي الجديد، والدفاع عن الأبنية التقليدية في المجتمع كالأسرة والدين. وهذه الجماعات قدمت مفهومًا للثقافة الوطنية يركز على القيم التقليدية الموروثة بوصفها الوحيدة القادرة على دعم الاستقلال.[5] وتشكل اليسار في المقابل لدفع هذا الميل التحديثي والإشتراكي في مواجهة القوى التقليدية والرأسمالية الكبيرة.[6] في هذا السياق مثلًا، حاول أنور عبد الملك، أحد أهم المفكرين الماركسيين الوطنيين في هذا الوقت، أن يبلور مقاربة يسارية لمفهوم “الثقافة الوطنية” المطلوبة. الثقافة الوطنية لدى عبد الملك ليست هوية موروثة يجب أن ترعاها الدولة الجديدة كما ذهب اليمين؛ فصفة “الوطنية” الملحقة بمفهوم الثقافة عند أنور عبد الملك ليست صنو “التقليدية” أو “المحلية”، ولا يمكن الكشف عنها تلقائيًا في ماضي الجماعة الوطنية. ولكنها بالأحرى بناء جديد تُسطصفى عناصره من خلال القراءة النقدية للتراث بعد تنقيته من عناصر الخمول والركود والاستسلام للأمر الواقع، ثم تتركب هذه العناصر التقدمية في صيغة جديدة موجهة للسلوك باتجاه أهداف الاستقلال والتنمية الوطنية والتحرر الفردي.[7]
واللافت أن كلا الميلين لم ينازعا النظام مفهومه الرسمي عن الثقافة ولا طابعه الإدماجي، ولا سعيا للتعبير عن رؤاهما بصورة تنظيمية مستقلة على الرغم من انحيازاتهم الاجتماعية الواضحة. بل على العكس، حرص كلا الطرفان، بدوافع مختلفة، على الإبقاء على الطابع الإدماجي بوصفه الأكثر ملائمة لفرض رؤاهما على الحلقة الضيقة القابضة على سلطة الدولة مباشرة، ووظفا ذات اللغة الوطنية المجردة في التعبير عن انحيازاتهم. فكان أن استمر التصور العام للمثقف، والوحدة الشعبية، كرخصة تسمح بشرعية الحديث في الشأن العام، وكحجاب يموه على حقيقة الانحيازات الاجتماعية للمتحدث. وفي حالة اليسار تحديدًا، سواء أتى من خلفيات تنظيمية سابقة في وجودها على النظام الجديد أو تشكل من داخله، فقد عكست رؤاه تفاؤلًا بأن التناقضات الرئيسية في صفوف الشعب، وبين الشعب ودولته، في طريقها للحل أخيرًا. كان الانطباع العام الذي يمكن استخلاصه من كتابات المنظرين اليساريين في هذا الوقت هو أن الخطوة الأهم على هذا الطريق قد تم إنجازها مع تأميم القناة في ١٩٥٦ وأن الدولة الوطنية قد بدأت في العودة إلى حاضنها الطبيعي، وأن النقد هدفه هو توجيهها في الاتجاه المنطقي يسارًا والحفاظ على السلطة الجديدة من الاختطاف مرة أخرى.
في هذه الدوائر اليسارية، وبالتفاعل مع أطروحاتها، ظهرت أولى كتابات البشري في مجلة الطليعة - المنبر الرسمي المعتمد لليسار - أو مجلة الكاتب، كمعلق شاب مع بداية الستينيات من القرن الماضي. ومن بين هذه الزمرة من الكتاب اليساريين، كان البشري هو الأقرب لصفة المثقف الوطني الذي بشّر به الميثاق أكثر من غيره. فهو ابن لعائلة من المتعلمين متوسطة الحال راكمت القدر الضئيل من مدخراتها من خلال العمل في جهاز الدولة سواء في مؤسساته الدينية أو القضائية، كما تلقى تعليمه في جامعاتها المدنية الوطنية خلال نهاية الأربعينيات. وتفتح وعيه بالطبع على تفكك وانهيار النظام البرلماني الهش، ولكنه كذلك لم ينتم لتنظيمات حزبية، على ما نعلم، أو يتجه للكتابة الصحفية في الصحف المحسوبة على أحزاب وتيارات هذه الفترة، بل باشر عمله في مؤسسة القضاء مباشرة بعد تخرجه.
ألقت الباحثة آنجيلا جيورداني الضوء بشكل مفيد على كتابات البشري الأولى ويمكن الرجوع لتحليلها للاستزادة.[8] تذهب جيورداني أن إسهام البشري - مثل أنور عبد الملك - في الجدل حول الثقافة الوطنية أتى من طريق البحث التاريخي الذي يسعى للكشف عن عناصر الثقافة الوطنية الجديدة اللاواعية في تاريخ النضال الوطني نفسه ثم إعادة بناءها بشكل واع للمساهمة في الحاضر. يفترض البشري في هذه الكتابات أن جماعة وطنية قد تشكلت بالفعل مع نهاية القرن التاسع عشر ولكنها ظلت محرومة من التعبير السياسي المستقل ومن السيطرة على جهاز الدولة الذي ظل استعماريًا في بنيانه. وهذا الحرمان لم يختلف البشري في تفسيره عما ورد في ميثاق العمل الوطني باعتباره ناتجًا عن سيطرة أقلية احتكارية تدين بوجودها للاستعمار على هذا الجهاز. أما عناصر ثقافتها الوطنية الجديدة فقد تراكمت عبر النضال الشعبي الهادف للاستقلال والذي حملت رايته جماعات سياسية مختلفة، ومتناقضة في بعض الأحيان، ولكنها ساهمت جميعًا في إضافة لبنات لبناء تلك الثقافة الجديدة سواء عبر الإصلاح الديني، أو الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط، أو إنجاز الدستور وتوحيد النظام القانوني الحديث، وأخيرًا تمصير الاقتصاد وتسخيره لخدمة مصالح الأغلبية. هذه العناصر تحولت، وفقًا لتعبير البشري، لمكون من مكونات “تراث المصريين”.[9] والمفارقة أن أحد إشاراته المبكرة لمفهوم التراث كان بالإحالة لمؤسسات حديثة بالكامل. بعبارة أخرى، نظر البشري لمسار الحركة الوطنية منذ الحركة العرابية وحتى يوليو ١٩٥٢ بوصفه جملة محطات متكاملة تفضي إلى بعضها البعض في سبيل تشكيل إرادة وطنية جامعة تسعى لانتزاع جهاز الدولة وتوجيهه لمصلحة الأمة الآخذة في التشكل.
وهنا يسير البشري على الخطى الناصرية التي رأت في نفسها استئنافًا لما انقطع من ميراث الحركة الوطنية.[10]
يمكن القول أن ملامح الطريق الذي سار عليه البشري في تحولاته اللاحقة قد ارتسمت في هذه الكتابات. فافتراض وحدة الجماعة الشعبية واغتراب الفئات الحاكمة - وخصومها من الإسلاميين واليسار الماركسي - يعد مقدمة طبيعية للبحث عن الملامح الثقافية الموحدة لهذه الأغلبية الشعبية العابرة للتيارات، والتحزبات الفكرية، والتي تميزها عن ثقافة الأقلية. كما أن التركيز على ملامح التواصل والتلاقي في تاريخ الحركة الوطنية يقود تلقائيًا للبحث عن الأهداف النهائية لهذه الحركة والتي تشكل إجماعًا يصلح كأساس لبناء التوافقات والجسور بين التيارات الفكرية المختلفة. وفي كل الأحوال، يُشكل المثقف محتوى الثقافة الوطنية الجديد من خلال قراءته النقدية والانتقائية للتاريخ، ولا يكشف له هذا المحتوى عن نفسه بشكل تلقائي. بعبارة أخرى، اتخذ البناء الفكري للبشري تصميمه الأساسي خلال تلك المرحلة بالارتكاز على ثنائيات أساسية بين جماعة شعبية موحدة و أقلية مغتربة، وبين ثقافة وطنية وثقافة تابعة أو وافدة، وبين اشتراكية عربية أصيلة وأخرى مستوردة. وما حدث بعد ذلك هو استصحاب البشري لهذه البنية الفكرية مع تبديل محتواها على ما سنرى.
مدافعًا عن الدولة في مواجهة خصومها وحكامها:
مع تباطؤ النمو الاقتصادي في منتصف الستينيات ثم الهزيمة العسكرية المدوية في يونيو ١٩٦٧ وما أعقبها من تزايد نفوذ الاتجاهات اليمينية للنظام واحتلالها موقعًا شبه مهيمن، تفجرت موجة احتجاجات طلابية واسعة تبلورت عبرها بذور التيارات الفكرية التي ستهيمن على المجال الفكري والسياسي المصري حتى يناير ٢٠١١. وقوام هذه الكتلة الغاضبة في هذه الفترة أتى من عناصر تودع الشباب وأخرى تخطو أولى خطواته. وتشكل من داخل هذه الكتلة يسار ويمين جديدان إن جاز التعبير. سعى اليسار، من جانب أول، لتجاوز الأفق السياسي الضيق للناصرية الذي ردّه للجذور الاجتماعية لقيادتها سواء كانت بورجوازية صغيرة أو بورجوازية بيروقراطية. ووفقًا لتحليله، حكم هذا الطابع الاجتماعي لنخبة الحكم الناصرية، مع تجريد الطبقات الشعبية من أي إمكانيات للفعل السياسي المستقل، على هذه القيادة بالعودة السريعة لطريق التراكم الرأسمالي الهامشي والتابع بوصفه معبرًا عن مصلحتها الأصلية.[11] في المقابل، فردّة فعل يمين السلطة الذي سعى للشطب الكامل والسريع على سياسات الستينيات التقدمية كجزء من تحالفه الاجتماعي الدولي الجديد، وجدت صداها السياسي خارج أروقة الدولة.
فظهرت الجماعات الإسلامية الجديدة التي تسعى لقطيعة مماثلة ليس فقط مع تاريخ الناصرية ولكنها تمد الخط على استقامته باتجاه قطيعة كاملة مع تاريخ التحديث المصري بوصفه تاريخ اغتراب الأمة عن عقيدتها والذي لولاه لما ظهرت الناصرية من الأصل، ثم عادت لتوجه سهام نقدها للجناح اليميني المهيمن نفسه أخذًا في الاعتبار انتماءه في التحليل الأخير لمسار التحديث العلماني حتى ولو عارض الناصرية واحتضن الخطاب الديني المحافظ.
اختلف اليسار واليمين في كل شيء تقريبًا ولكنهما تقاطعا في جذرية طرحهما حيث كانت الأبواب والقنوات مسدودة تقريبًا أمام كلا الفريقين للتأثير على رأس السلطة من داخل مؤسسات النظام، فكانت الانتفاضة الجماهيرية الديمقراطية هي طريق الفعل المفترض لدى الجماعات الماركسية أو الناصرية الجديدة، في حين أن “الدعوة”، أو إعادة بناء عقيدة المسلمين من جذورها ثم فرضها على جهاز الدولة من خارجه، كانت طريق الجماعات الإسلامية.
في هذا السياق، عاد البشري للكتابة المكثفة للتعاطي مع جمهور جديد وأسئلة إضافية تدور كلها حول مكمن الخلل في هذا المشروع الناصري. سال حبر كثير خلال هذه الفترة بالطبع للإجابة على هذا السؤال، ولكن المميز في البشري أن بحثه لم يقده إلى أي رؤية خلاصية كالرؤية القطبية، على سبيل المثال، والتي أقامت تعارضًا كاملًا بين كافة مؤسسات الدولة الوطنية الحديثة وبين الإسلام كعقيدة. كما لم يقدده بحثه إلى السعي لتجاوز الحيز الوطني لصالح عروبة سياسية متجاوزة للقطرية، أو الإطاحة الثورية بسلطة الفئات الحاكمة وبناء دولة جديدة تختلف في آليات عملها عن النمط البورجوازي المهيمن، وذلك بالرغم من خلفيته اليسارية. وكذلك لم يقده بحثه بالطبع للالتقاء مع يمين النظام وتحالفاته الرجعية المسئولة عن الأزمات الاجتماعية والسياسية لمرحلة السبعينيات من وجهة نظره.
بالعكس؛ كان البشري في كتاباته خلال هذه الفترة - ربما بحكم بعده عن المنظمات السياسية الجذرية التي ظهرت في هذا الوقت - مخلصًا للفهم الذي ساد خلال الحقبة الناصرية عن ثورة يوليو وإصلاحاتها بوصفها إنجازًا تاريخيًا في التحليل الأخير لا يمكن التضحية به، كما ظل مخلصًا كذلك للخطوط العامة لتحليله حول مسار الحركة الوطنية وأعدائها من الطبقات الاحتكارية التي تدين بوجودها للغرب، والتي بدا له أنها في طريقها للتمكن من سلطة الدولة في هذا الوقت.
إجابة البشري على سؤال الخلل في مشروع التحرر الوطني الناصري هي ببساطة في غياب الطابع الديمقراطي عن الحكم. وفرضيته الأساسية هنا أن المطلب الدستوري، أو الديمقراطي العام، كان لصيقًا بالمطلب الوطني منذ لحظة الميلاد بوصف الآليات الديمقراطية هي الشرط الوحيد لتشكل إرادة وطنية صريحة لا يجري اختطافها أو ادعاء الحديث باسمها. ومن هنا كانت عودته الدائمة لتاريخ ١٩٤٦ - عام إعلان اللجنة الوطنية العليا للطلبة والعمال لمواجهة حلف مصري بريطاني جديد - كعام فاصل في تاريخ النضال الوطني المصري اندغمت فيه المطالب الوطنية بالمطالب الديمقراطية مع وعي أعمق بكثير من لحظة ١٩١٩ بالطابع الاجتماعي الأقلوي والمغترب للفئات الحاكمة جميعها. ومن هنا كذلك يمكن فهم كتابه عن “الحركة السياسية المصرية”[12] بوصفه استعراضا لتاريخ ارتباط المطالب الوطنية بالمطالب الديمقراطية بوصفهما جناحي الإرادة الوطنية العامة، وأن غياب أحدهما عن الآخر يعني هزيمة الإثنين معًا. فلا ديمقراطية تحت الاستعمار، أو في ظل هيمنة وكلائه الذين سيصبغون الحكم بصفة أقلوية بالضرورة، ولا استقلال وطنيا قابلا للاستمرار بدون الآليات التي تُمكّن الجماعة الوطنية من التعبير عن مطالبها وإلا انتهى الاستقلال في هذه الحالة إلى حكم أقلية جديدة تدين للاستعمار بوجودها.
ومن هنا كذلك كان البشري دائمًا حتى بعد ما يوصف بتحوله “الإسلامي” - وسنأتي لهذه النقطة لاحقًا - مقدرًا بشكل كبير لتراث الوفد ليس بوصفه حزبًا ليبراليًا مثلًا أو بسبب زعامة سعد زغلول التاريخية، ولكن بوصفه التعبير الوحيد تقريبًا في تاريخ الحركة الوطنية الذي استطاع حتى معاهدة ١٩٣٦ تجسيد الهدفين معًا في سبيكة واحدة كجبهة شاملة لعموم المصريين بلا تفريق، وذلك قبل خضوع قيادته لسيطرة كبار الملاك مع بداية الأربعينيات. استعادة الآليات الديمقراطية بالتالي كان المخرج الأساسي لمأزق نظام ٢٣ يوليو الوطني في جوهره وضمانة لاستئناف مساره الصحيح من حيث المبدأ.[13]
البحث عن الأصالة، لا المثالية:
محاولة استعادة المسارين معًا، الوطني والديمقراطي، بعد الاستفادة من إخفاقات مشروعي الوفد وعبد الناصر، قادت البشري إلى اعتبار أن المشروع الوطني الديمقراطي يلزم أن ينطلق من واقع حياة الغالبية دون القطع الجذري معها وأن يتطور من داخلها، وواقع حياة الغالبية لديه تهيمن عليه الثقافة الإسلامية كإطار لإنتاج المعرفة والقيم الأخلاقية. فلا يمكن لمؤسسات وتقنيات هدفها تقييد سلطة الحكم، كالدساتير والقوانين والمحاكم وأجهزة الحكم والإدارة المحليين والبنوك المركزية والأجهزة الرقابية وغيرها الكثير، إلا أن تنبثق بشكل عضوي من ثقافة الجماعة المحكومة، وإلا تحولت هذه المؤسسات والتقنيات إلى أداة لتفتيت الجماعة في يد السلطة التي تسعى الجماعة لتقييدها. وهذا هو تحديدًا ما حدث في مصر وفقًا للبشري، حيث انتهت المؤسسات الحديثة إلى تدمير الأبنية التقليدية وخلع الأفراد من حيز التضامن التقليدي وتذريرهم دون أن تمكّنهم من صياغة إرادة عامة مستقلة في المقابل، وذلك تحديدًا بحكم غربتها عن الإطار الثقافي الذي يحيا عبره المصريون.[14]
انحياز البشري هنا لفكرة الثقافة الإسلامية - كغيره في هذا الوقت مع نهاية السبعينيات كمنير شفيق وعادل حسين ومحمد عمارة - يأتي بوصفها ثقافة الجماعة الوطنية المعطاة والتي لا يمكن لأي مشروع وطني ديمقراطي إلا أن يتأثر بها إن أراد تعبئة الغالبية الساحقة من جمهور هذه الجماعة لحماية الاستقلال الوطني. ومن هنا بدأ البشري في بلورة ثنائيته الشهيرة عن الوافد والموروث كصدى متأخر لثنائية الشعب الموحد والأقلية الاحتكارية المغتربة التي نجدها في كتاباته المبكرة. وأصلّ لفكرته عن هذه الثنائية بشكل صافي في المقدمة الجديدة لكتابه عن الحركة السياسية في مصر، و في عمله الموسوعي عن “المسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية”.[15] الوافد -من أفكار ومؤسسات وأخلاقيات- لدى البشري مرتبط تاريخيًا ارتباطًا وثيقًا بتشكل الأقلية القابضة على سلطة الدولة تحت رعاية الاستعمار البريطاني ثم الأمريكي الجديد، في حين أن الموروث هو الإطار الرمزي الذي تحيا عبره الغالبية العظمى من الناس في مصر وهو محكوم بالتاريخ الإسلامي كما انتهى إلينا عشية التحول الرأسمالي ونشأة الدولة الحديثة.[16]
وعلى العكس من مجايلين يساريين كُثر، لم يبحث داخل هذا التاريخ عن إمكانيات مجهضة لرؤى أكثر تحررًا أو عدالة، ولم يره كتاريخ انحطاط للمسلمين كما ذهب كثير من المفكرين السلفيين العقلانيين أو الوطنيين الليبراليين مع نهاية القرن التاسع عشر، ولم يره تاريخا لاغتراب المسلمين عن جوهر التصور الإسلامي للكون والإنسان والمجتمع والذي تحقق فقط على يد الرسول وخلفائه الأربعة، كما في الرؤى القطبية أو السلفية الأخرى. البشري عمليًا لم يشغل باله كثيرًا بالحكم على السائد من أطروحات في هذا التاريخ. كل ما كان يعنيه أن مجتمعات المسلمين كانت تتطور وفقًا لمنطقها الخاص دون هيمنة من خارجها، وأن تطورها هذا قد أنتج علاقات اجتماعية وأشكال من التنظيم “أصيلة” وليست “مثالية” بالضرورة. وهي أشكال قابلة للإصلاح والتطوير باتجاه وطني وديمقراطي بشرط فهم منطقها الداخلي وتصوراتها التي تراكمت عن الفرد والجماعة والقانون والأخلاق. ولهذا فهو في عودته لتاريخ مجتمعات المسلمين السابق على الاستعمار، يتحرك في استشهاداته بحرية تامة ما بين حقب شديدة الاختلاف وآراء شديدة التباين تشمل التقليديين من المتمذهبين وبعض أهل التصوف، بل وبعض الأئمة الذين خرجوا على ما يفترض أنه إجماع سني بالكامل. الجامع بين هؤلاء جميعًا هو “الأصالة”، أي أنهم جميعًا لم ينطلقوا في اجتهاداتهم إلا للاستجابة لأسئلة طرحها عليهم واقع المسلمين كما أبدعوه وليس واقعًا آخر فُرض عليهم. الموروث إذن، لو جاز لنا إعادة صياغة وتبسيط رؤية البشري المركبة، ليس جوهرًا منسيًا تراكمت عليه الانحرافات في مجالات العقائد والعبادات والمعاملات كما في عرف الرؤية السلفية، ولا هو مجموعة من الأفكار البالية من مخلفات التاريخ التي تركتها الفئات الحديثة خلفها على أطراف وهوامش المجتمع الجديد. الموروث بالأحرى هو مجموع القيم والمؤسسات والأعراف التي تنظم حياة الناس اليومية في الحاضر والتي يلجأ لها الناس بشكل تلقائي، أو عضوي، كموجه للسلوك ومرجع في أحكامهم و تعاملاتهم، وهو في نظره ما زال حيًّا وقابلًا للتجديد، وإن كان محاصرًا بشكل يكبل إمكانياته.[17]
و”التجديد” خصص له البشري قسمًا مهمًا من كتاباته، وهو يشير لديه للعملية التي تستهدف رفع التراث من مرتبة الواقع المعاش بشكل تلقائي ولاواعي إلى مرتبة التقنيات والمؤسسات الحاكمة للمعاملات. جمع البشري مقالاته العديدة في هذا الموضوع في كتاب من أهم أعماله على الإطلاق بعنوان “الوضع القانوني المعاصر بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي”، وهو مخصص بالكامل لتتبع حركة التجديد في الحقل القانوني والهادف لنقل الشريعة من المجال الأخلاقي المحض الموجه للسلوك الشخصي، والتعاملات بين الأفراد، إلى مجال القانون الحاكم. وهو يرى أن التجديد بهذا المعنى في الحقل الفقهي والقانوني لم ينقطع منذ بداية القرن التاسع عشر، حيث تصدى له عدد من الفقهاء والمفكرين القانونيين من مختلف المذاهب الفقهية والمدارس القانونية والمعسكرات الفكرية والسياسية. فهو مثلًا، بالرغم من اختلافه الواضح مع التصلب السلفي في مجال العقيدة، يمتدح باستفاضة سعي محمد بن عبد الوهاب لمواجهة هيمنة الخرافات والفكر المستكين على الطرق الصوفية، كما يقدر بشدة دعوته لعدم التقيد الجامد بالمذاهب الفقهية المعروفة في المجال السني. وفي المقابل، يمتدح كذلك عددًا من الفقهاء الصوفيين المجددين، خصوصًا من تنبه منهم لخطورة الهيمنة الأجنبية على عملية التشريع مع بداية القرن العشرين. بل هو ينفتح حتى على عدد من الفقهاء الزيديين، كالإمام الشوكاني، ويحاول التعريف بمجهوداتهم. وكذلك يقدر بشدة سعي عدد من الفقهاء القانونيين المنتمين لما يسميه بالتيار العلماني الوطني لاستنباط المفاهيم والقواعد القانونية الحديثة من داخل مذاهب الفقه الإسلامي، وعلى رأسهم بالطبع عبد الرزاق السنهوري، على الرغم من اختلافه العميق معه في خلاصاته.[18]
وعلى هذا المنوال، وتأثرًا بالسنهوري على وجه التحديد، يدعو البشري في مقال بالغ التعقيد لاستئناف التجديد في الحقل القانوني من خلال ما أسماه “تقنية الإسناد الشرعي”.[19] فالبشري بحكم عمله القضائي الطويل حاز قدرا من الحصافة والدقة ليدرك أن العديد من أحكام المذاهب الفقهية لا زالت قائمة في التشريع المصري، ليس فقط في مجال الأحوال الشخصية ولكن كذلك في مجال القانونين المدني والتجاري. علاوة على أن ما استٌحدث من قواعد في مجالات القانون الإداري والدستوري، من تأمينات اجتماعية وحقوق للعاملين وترتيبات إدارية ومؤسسية، لا تخالف الشرع في شيء، بل هي لديه من الإنجازات الكبرى للحركة الوطنية التي ينبغي العض عليها بالنواجز. ولكن ما ينقص هذه التقنيات والمؤسسات، ويجعلها غريبة في عين الجمهور، هو الإسناد الشرعي، أو الشرعية باختصار.[20] فهذه التقنيات تقدم للناس كمجرد تعليمات هابطة عليهم من مصدر بعيد متعال وهو الدولة، ولا تقدم بوصفها نابعة من شريعتهم التي يجلّونها. واللغة القانونية التي تصيغ هذه القواعد جافة وغريبة على روح الناس. وبالتالي، فإذا استطاع الفقيه والقاضي والمحامي والمفكر القانوني إيجاد الرابطة بين هذه التقنيات وبين أصول ومقاصد الشريعة الإسلامية، وأن يعيد صياغتها في لغة تنتمي لثقافة الناس، سيساهم في حلّ معضلة الشرعية بما يُكسب هذه المؤسسات حيوية مفقودة، ويحولها لمنتج وطني عام يجب الحفاظ عليه والدفاع عنه.[21]
رؤية البشري للتجديد وضعته في خلاف ليس فقط مع الجماعة القانونية التي تتعامل مع التشريع والتقاضي كمسائل فنية لا مجال فيها للتأصيل النظري أو الشرعي، ولكنها كذلك وضعته في خلاف فرعي مع منظري الحركة الإسلامية الذين رفعوا شعار استعادة الشريعة منذ منتصف السبعينيات. فبينما يقدر البشري شعبية الحركات الإسلامية، وقدرتها على النفاذ السلس لجمهور الجماعة الوطنية، لا يشاركها نزوعها لإسقاط حقب تاريخية كاملة من تاريخ مسيرة التجديد القانوني، والتي تصدى لها كما قلنا علمانيون وطنيون كالسنهوري. ونلمح في كتاباته نقدًا مبطنًا للرؤية القطبية مثلًا التي ناصبت تاريخ المسلمين العداء بوصفه محض جاهلية ممتدة.[22] والأهم، وفقًا للبشري، أن رؤية القطيعة تلك تقود الحركة الإسلامية للتعلق بالدولة المغتربة بوصفها الكيان الوحيد القادر على تنفيذ برنامجها الدعوي بحكم ما تحتكم عليه من أسباب القوة المادية. هذا التناقض بين رؤية الحركة الإسلامية للدولة بوصفها مسئولة عن خلع المسلمين من تراثهم، وبين سعيها للسيطرة على -أو التعاون مع- جهاز الدولة بوصفه الوحيد القادر على رد الجماعة الوطنية لتاريخها، لن يعني في الممارسة، وفقًا للبشري، إلا تمكين نفس الدولة السلطوية من مزيد من التسلط على المجتمع باسم الشريعة هذه المرة. والبشري في مقاله المذكور عن “الإسناد الشرعي” بعلن بوضوح أن الدعوة لتطبيق الشريعة إن لم تقترن مع مجهود عملي لمقرطة مؤسسات الحكم الحديثة القائمة فلن تنتهي إلا لتقديم غطاء شرعي للسلطوية العلمانية نفسها. بل إن مجهود المقرطة ذاك سابق لديه على تطبيق الشريعة بوضوح. ويضرب مثالًا ذكيًا بانتشار الحجاب في هذه الفترة. فيقول إن الحجاب كواجب شرعي على كل مسلمة لو كان فُرض بشكل قانوني لما انتشر، بل لواجه معارضة شرسة بوصفه أمرًا آتيًا من مصدر خارجي وهو الدولة.[23]
في المقابل يطرح البشري استراتيجية بديلة لدعاة تطبيق الشريعة، تشبه في الواقع استراتيجيات الحركة الإسلامية على المستوى النظري، وهي ما يسميه باستراتيجية “التخلل”. وفقًا لاستراتيجية البشري، يجب على الحركة الإسلامية أن تنفتح على اجتهادات التجديد المعاصرة سواء في الحقل الفقهي أو القانوني، وأن تقدمها لجمهورها وتجسدها فيما تنشئه من مؤسسات أهلية أو ربحية، كما في حالة البنوك الإسلامية مثلًا. عندها فقط ستتحول دعوة تطبيق الشريعة لمثال حيّ يفرض نفسه على الدولة ويحفزّ مديريها على الاقتداء بدعاتها.[24] بعبارة أخرى، فالبشري، المثقف العضوي القادم من داخل جهاز الدولة، يقترح على الحركة الإسلامية المساهمة في تثقيف مسئولي الدولة عمليًا بالبيان المباشر على الأرض بدلًا من مناصبتهم العداء، أو دعوة هؤلاء المسئولين إلى تبني تطبيق الشريعة وهم على ما هم عليه من تكوين علماني ونزوع فني محض. ومرة أخرى، هذا الطرح، المبدع بحق، ما كان يمكن أن ينجزه إلا مثقف خارج من رحم جهاز الدولة، ويعي بنيته وآليات عمله وتاريخه، وفي نفس الوقت على اتصال وثيق بالتيارات السياسية المختلفة بما يمكّنه من التفكير معها والتنظير لها.
وهكذا مع نهاية التسعينيات، يكتمل بناء البشري الفكري وتترابط جوانب مشروعه المختلفة ما بين التحليل التاريخي وصك المفاهيم الضرورية للتفسير وطرح الاستراتيجيات على الفاعلين الاجتماعيين. والخيط الرابط بين هذه الجوانب المختلفة هو الافتراض المؤسس أن وحدة عضوية قد حكمت تشكل الجماعات عبر تاريخ المسلمين، وأنها كانت قادرة على حل تناقضاتها وصراعاتها الداخلية وتصويب مسارها، وأن هذة الوحدة لم تعرف انفصالًا بين المصلحة والأخلاق ولا بين الأخلاق والقانون ولا بين الأخلاق والسياسة، قبل أن يفصمها التحول الرأسمالي إلي طبقات وتتغول عليها الدولة الحديثة بقانونها المغترب الذي يراه الناس هابطًا عليهم وليس نابعًا منهم. وكذلك فإعادة بناء هذه الوحدة أمر ممكن، بل إن الجهود في سبيل ذلك لم تنقطع، وتخللت النظم الحديثة نفسها في لحظات مفصلية من النضال الوطني الديمقراطي. ومن ثم فمجهود الفاعلين القانونيين والدينيين والسياسيين يجب أن ينصرف إلى تركيب عناصر هذه الوحدة مرة أخرى عبر مصالحة الدولة على موروث الجماعة، ورفع هذا الموروث نفسه من مرتبة "التلقائي" إلى مرتبة "المفاهيمي" في مشروع سياسي جديد يتسع للجميع. من هنا أيضًا يتضح معنى “المحافظة” في وصفنا لرؤية البشري، فالمحافظة هنا تشير لسعيه لربط لحظات تأسيس المشروع الوطني الديمقراطي بلا انقطاع، والدفاع عن المتحقق منه بالفعل في صورة مؤسسات أو قواعد، دون المغامرة بالتضحية بها في سبيل تصور مغاير يبدأ من نقطة الصفر.
وعلى العكس من المحافظة الليبرالية مثلًا - أو الوطنية السلطوية المهيمنة حاليًا في مصر - التي انطلقت من اليأس من المشروع الديمقراطي بشكل عام، والتحسس من أي أفكار شعبوية باعتبارها تهديدًا للتحديث، وعلى العكس من المحافظة الإسلامية التي تسعى لإعادة بناء منظومة قيم وعقائد المصريين على مثال ديني منضبط عبر أجهزة الدولة التعليمية والدعائية، كانت محافظة البشري في الحقيقة هي الأكثر عمقًا. فلا المحافظة الليبرالية/أو الوطنية التحديثية، ولا المحافظة الإسلامية، تتسع لمساهمة جماهيرية ديمقراطية فعّالة على النحو الذي تخيله البشري. على العكس، تقوم المحافظة الليبرالية على الاستبعاد الدائم للجمهور من دائرة المشاركة السياسية باعتباره جمهورا عاطفيا تحركه النوازع اللحظية بالضرورة، وتقوم المحافظة الإسلامية على الدعوة الفكرية أكثر منها على السياسة المنظمة لتنتج ثنائية مستعصية على الحل في تاريخ الحركة الإسلامية ما بين الجانب الدعوي والجانب السياسي.
والبشري وجّه نقده للإخوان المسلمين مثلًا عقب ثورة يناير تحديدًا من هذا الجانب، أي هيمنة الجانب الدعوي على خيالهم الذي سهّل انجرارهم لمعارك جانبية حول الهوية في حين أن المعركة الحقيقية كان يجب أن تتركز حول الديمقراطية والدستور وتوزيع السلطات.[25] كما أن خصوصية محافظة البشري يغفلها الباحثون الذين يستخدمون المفهوم الأوسع للوطنية/الإسلامية في تصنيف أعماله. فالتعبير هنا تتسع مدلولاته لتشمل نزعات محافظة داخل جهاز الدولة تناغمت مع المعسكر الرسمي المحافظ في العالم العربي - تحديدًا خليج السبعينيات والثمانينيات - وحتى نزعات شديدة الجذرية تناصب النخب الحاكمة وهذا المعسكر العداء. كما تمتد المدلولات عبر الزمان لتشمل مشاريع كسلفية الأفغاني ومحمد عبده الإصلاحية، أو كالحزب الوطني القديم، والتي تعاطت مع إشكاليات مختلفة تمامًا لتلك الإشكاليات التي تعاطى معها البشري. هذا بخلاف أن المفهوم يعدّ أكثر ملائمةً لمقاربة وتصنيف الأفكار الخاصة بالهوية الثقافية على عمومها بينما أن مشروع البشري تطور بالأساس كبحث في مسألة بناء الدولة الوطنية الديمقراطية، ومن هذا المنطلق تطرق للموضوع الثقافي أو سؤال الهوية.
محافظة البشري، في الحقيقة، أتت جزئيًا من طريق يمكن وصفه بطريق “هيجيلي”. فالبشري عبر رحلته الفكرية الطويلة كان يتبع - بشكل لا واع على الأرجح - رؤية هيجل للحقيقة كتشكيل يتكون عبر الواقع أو التاريخ، وأنها لم تهبط كاملة جاهزة في نص ديني ما، أو من خلال مصدر ميتافيزيقي متعالٍ، كما أنها لا تنبثق بشكل إرادي عن التأمل العقلي المحض.[26] ومن ثم اتسّم عمل البشري بالبحث خلف تناقضات الواقع عن الفكرة النهائية التي تكشف عن نفسها بشكل متدرج عبر تعرجات التاريخ المصري الحديث وتشكل حقيقته أو غايته، أي فكرة الدولة الوطنية الديمقراطية المتصالحة على تراث المصريين الثقافي. وهو يطرح تصوره عن هذه الدولة كتركيب لمجموعة من المفاهيم، أو العناصر، التي طرحت نفسها على الفكر كمتناقضات عبر سلسلة من اللحظات التاريخية: جهاز الدولة الحديث في مواجهة المجتمع، والوافد في مواجهة الموروث، والقانون في مواجهة الأخلاق، والوطنية في مواجهة الديمقراطية.[27] فكرة الدولة الوطنية الديمقراطية، بالنسبة للبشري، تتشكل كحل للتناقض بين هذه العناصر ودمجها في وحدة أرقي، ففيها ينحل التناقض بين الأمة وجهازها الإداري عبر الآليات الديمقراطية، وبين الرؤى الوافدة والموروثة عبر التجديد الفقهي المنضبط لا عبر القطيعة سواء كانت سلفية أو حداثية، وبين الوطنية والديمقراطية عبر إتاحة المجال للمجتمع الشعبي للتعبير عن مطالبه بحرية تنظيمية ستؤدي حتمًا لتشكل إرادة وطنية حرّة. ومن ثم تتحول هذه الدولة الجديدة - كدولة هيجل الدستورية - إلى مجال لحياة أخلاقية حقيقية لا يخضع فيها الإنسان إلا للمُثل المتشكلة جماعيًا بحرية. بعبارة أخرى، فدولة البشري المثالية، أو الغاية النهائية لمسار التحرر الوطني المصري، شبيهة بصورة دولة يوليو عن نفسها، بتوجهاتها الوطنية والاجتماعية التي عبر عنها الميثاق، ولكنها مطعمة بالديمقراطية السياسية، وبحرية واسعة للمجتمع الأهلي بثقافته الإسلامية، والتي ستتخلل جهاز الدولة تلقائيًا إذا أتيحت لها الفرصة. والطريق لإنجاز هذه الدولة لا يمكن أن يتصدى للسير فيه إلا تنظيمات سياسية وطنية جبهوية الطابع - كوفد ١٩١٩ والعشرينيات - يعكس برنامجها هذه النزعة التصالحية نفسها في التزام وطني وديمقراطي وثقافي عميق في آن واحد. البشري نجح إذًا في تركيب “نظرية كل شيء” التي تربط بين الإجابات التي قدمتها مختلف التيارات السياسية والفكرية لسؤالي الثقافة الوطنية وكيفية استكمال مشروع التحرر الوطني المصري في بناء نظري واحد.
عن سراب التطور العضوي: فاصل نظري
يمكننا الآن فحص مجمل إنتاج البشري الفكري في ضوء افتراضه الأساسي عن الوحدة العضوية للجماعة الوطنية وضرورة، وإمكانية، إعادة بناءها على أسس جديدة. ونتساءل: هل يمكن استعادة هذه الوحدة العضوية المتناغمة - علي افتراض تحققها تاريخيًا بالشكل الذي تحدث عنه البشري- في ضوء استمرار نفس الشروط التي أدت لفصمها ابتداءًا، أي هيمنة علاقات الإنتاج الرأسمالية والدولة الحديثة؟ وهل تستطيع المشاريع التي ترفع راية الأصالة، أو مشاريع البشري الجبهوية، أن تنجز هذه المهمة - على افتراض إمكانيتها - بحكم سعيها لتعبئة التراث الثقافي المشترك بين غالبية المصريين؟ وهل التجديد بالشكل الذي تصوره البشري كممارسة فكرية وسياسية وقانونية يمكن أن يمدّ هذه المشاريع بحلول وإجابات ناجعة تساعدها في إنجاز مهمتها؟
إجابتنا على هذه الأسئلة هي بالنفي: لا يمكن لمجتمع رأسمالي حديث، أيًا كان موقعه من التقسيم الدولي للعمل، خصوصًا مجتمعات الأطراف أو المستعمرات السابقة، أن يتطور بصورة متناغمة، أو متجانسة، باتجاه مصالحة جميع تناقضاته. وحيث أن المشاريع التصالحية أو التوفيقية، ومناهجها في التجديد، ستعتمد حُكمًا في زادها البشري و تمويلها وبناءها المؤسسي واستراتيجياتها على علاقات القوى القائمة في المجتمع، فإن أفقها الفكري ومحتواها سيتحددان بتوزيع القوى المختل الذي يسم هذه العلاقات. ومن ثم ستعود تلك المشاريع من حيث لا تدري لتسهم في إعادة إنتاج التناقضات الاجتماعية أو إفراز تناقضات جديدة. يقتضي حكمنا هذا تعريجًا سريعًا من أجل توضيح منطلقاته النظرية - والتي تخللت الأقسام السابقة على أية حال - قبل العودة لمناقشة أطروحات البشري.
نبدأ بالقول إن فكرة التطور العضوي التي يطرحها البشري بصياغات مختلفة في مواجهة التصورات العلمانية عن وجهة المشروع الوطني الديمقراطي المصري هي بدورها فكرة تنتمي لعالم الحداثة الرأسمالية الأوروبي، وتجد أهم تجلياتها النظرية في الكتابات القانونية تحديدًا، وشروحاتها المصرية، التي تشربها البشري خلال سني تكوينه الأولى وظل دائم الرجوع إليها.[28] هذه الكتابات تقدم رواية للتاريخ الأوروبي تتشكل فيها الدولة الحديثة في الغرب بشكل عضوي Organic متجانس مع كلية العلاقات الاجتماعية الصاعدة لتعبر عنها سياسيًا وثقافيًا وتضمنها في دساتيرها وتشريعاتها ونظمها الإدارية. والبشري عندما أسقط هذه التصور - الذي لم يهتم كثيرًا بمسائلته أو تأمله - على التاريخ المصري الحديث انتهى إلى تقديمه كتاريخ إجهاض، أو كبح، لتطور المجتمع الذاتي على يد الفئات القابضة على سلطة الدولة الحديثة منذ الاستعمار. البشري في النهاية، كخصومه العلمانيين، قرأ التاريخ المصري في مرآة التاريخ الأوروبي، ولكن بينما انتهى العلمانيون إلي ضرورة تحويل ثقافة المجتمع لتلائم النظم الوافدة، سار البشري في الاتجاه العكسي وهو ضرورة صبغ النظم الوافدة بثقافة المجتمع. وخلافه بالتالي مع الرؤى العلمانية الوطنية هو في التحليل الأخير خلاف في الخلاصات وليس في المنطلقات: وكأن البشري يحاجج خصومه بأننا إذا سرنا على نفس النهج فسننتهي بالضرورة إلى ضرورة إعادة تأسيس الدولة الحديثة من داخل الإطار الثقافي للمجتمع، وهو محكوم بالتاريخ الإسلامي كما قلنا.[29] ولكن في الحالتين لم يسائل أحد هذه القسمة الصافية بين ثقافة المجتمع (أو ثقافة الشعب في لغة البشري في مرحلته اليسارية) والدولة، كما لم يجادل أحد في ضرورة الوحدة بين الثقافتين كهدف نهائي، ولا في اعتبار أن الازدواجية -أو التوتر بينهما- هو محض خلل أو انحراف عن مسار مرجعي، هو المسار الأوروبي بطبيعة الحال. والدافع لتبني هذه الرواية الغربية في الحالتين، كما أشرنا مرارًا، كان هو وحدة السؤال الذي هيمن على خيال المثقفين الوطنيين من علمانيين أو باحثين عن الأصالة: كيف يمكن أن نتجاوز تناقضات الواقع وننشئ ثقافة وطنية خالصة تدعم الوحدة بين المجتمع ودولته.
لا يمكن بالتالي تقيييم فكرة التطور العضوي إلا بالفحص المدقق لنموذجها التاريخي المرجعي، الذي ألهم رؤية البشري وخصومه، أي تطور الدولة الحديثة في الغرب. والأدبيات التي يحيلنا إليها البشري لا تصلح منطلقًا لهذه المهمة أخذًا في الاعتبار اهتمامها بعقلنة ما انتهى إليها من أوضاع وإضفاء صفة الحتمية عليها أكثر من البحث وراء أصولها ومكامن العرضية فيها، أو استكشاف المسارات البديلة التي كان من الممكن أن تنتهجها تلك المجتمعات. في المقابل، فالمنهج المادي في التأريخ للتطور الرأسمالي في الغرب، والذي ظهرت بوادره الأولى عبر حجاج ماركس الطويل مع الرؤية الهيجلية، يعطينا رواية مغايرة، وكان حريًّا بمنظرٍ للأصالة أن يتأمل هذه الرؤية البديلة بدلًا من تبني الرواية الذاتية الأوروبية وإسقاطها على الواقع المصري بشكل آلي.
ينطلق هذا المنهج المادي من فهم للعلاقات الاجتماعية كعلاقات قوة بالأساس تتمفصل مع بعضها البعض لتنظيم نفاذ الأفراد للأدوات اللازمة لإعادة إنتاج وجودهم الاجتماعي (من آلات وتكنولوجيا ومعارف تطبيقية ونظرية)، ومن ثم تحديد مواقعهم في عملية إنتاج هذا الوجود ككل. وهي “علاقات قوة” بحكم أن هذا النفاذ و التوزيع - غير المتساوي بالضرورة - يتضمن جانبًا إكراهيًا بشكل حتمي، كما أنه يرتب قدرات متفاوتة لأطراف تلك العلاقات على التأثير في سلوك بعضها البعض.[30] والعلاقات الاجتماعية الرأسمالية، وفقًا لهذا المنهج، قد اعتمدت في نشأتها على تعميق النفاذ غير المتساو لأدوات الإنتاج، المعروف في كل المجتمعات الطبقية، إلى درجة غير مسبوقة، وذلك من خلال تدمير كافة أشكال المشتركات، أو أشكال الإنتاج التضامني، المعروفة في التاريخ السابق على الرأسمالية، وهو ما أدى بالتبعية لتعميق التفاوت في توزيع القوة أفقيًا ورأسيًا عبر كلية العلاقات الاجتماعية المشكلة لقوام المجتمع.[31]
علاقة الملكية مثلًا هي علاقة إنتاج اجتماعية وليست محض إعلان قانوني عن انتقال منقول، أو أصل، من شحص لآخر. فهي تنبني على تصور للعالم الخارجي كموضوع للاستحواذ والاستثمار سواء بشكل فردي أو جماعي، لا كمشاع أو مشترك معروض للانتفاع. كما أن موضوع الملكية هو إما أداة إنتاج قائمة بذاتها، أو موضوع يُمكّن صاحبه من الانتقال من موقع لآخر في عملية الإنتاج، كما في حالة الثروات التي تسمح للبعض بالعيش من ناتج قوة عمل الاخرين. وكذلك فهي علاقة قوة، أخذًا في الاعتبار أن الموضوعات التي تتحرك بين المراكز القانونية هي في التحليل الأخير تختزن فائض قيمة تم انتزاعه وتجريده من منتجيه، وفائض القيمة المختزن ذاك هو الذي يحدد القيمة التبادلية لموضوع الملكية بالتبعية. وأخيرًا فهي تمكّن حائزها من قدرة أعلي على التأثير في سلوك الآخرين. وما ينطبق على الملكية، ينطبق بصورة أوضح على علاقة العمل التي لا يمكن اختزالها لمحض علاقة تعاقدية حرّة يبيع بمقتضاها أحد طرفيها قوة عمله نظير مقابل مادي، ولكنها في جوهرها تتضمن تنارلًا عن فائض قيمة العمل في كليته مقابل الحصول على قدر ضئيل منه في هيئة أجر. وينتج هذا التنازل، أو الانتزاع بالأحرى، نفاذًا غير متساو لأدوات إنتاج الوجود الاجتماعي، كما أنه لا يمكن أن يقوم إلا بالإكراه المتمثل في التهديد بالبطالة. وكذلك فتعميم علاقة العمل “التعاقدية” يؤدي لتفاوت هائل في قدرة أطرافها على التأثير في سلوك بعضها البعض. بل حتى العلاقات التي تبدو للوهلة الأولى بعيدة عن محيط الإنتاج بالمعنى المباشر للكلمة، كالعلاقات بين الجنسين مثلًا، فهي تتضمن تقسيمًا اجتماعيًا للأدوار يصب في التحليل الأخير في توزيع متفاوت لإمكانيات النفاذ لأدوات إعادة إنتاج الوجود الاجتماعي ككل.
أما العلاقة بين هذه العلاقات الاجتماعية، من جانب، والنظم القانونية والسياسية والثقافية، من جانب آخر، فهي علاقة تمفصل أو تركيب Articulation. وككل عملية تمفصل فهي تتضمن تحولًا في طبيعة أطراف العلاقة بما يمكنها من أداء وظائفها المستحدثة، ولكنها لا تعني ذوبانًا لطبيعة تلك الأطراف المتميزة في طبيعة جديدة أو طمسًا للفروق بينهما. وبالتالي، فإذا كان محتوى الأبنية القانونية - السياسية يتحول عبر تمفصله مع العلاقات التي يسعى لتنظيمها إلا أن هذا لا يعني انبثاق هذه الأبنية عن العلاقات الاجتماعية بشكل آلي أو عضوي. ولكنها تتشكل من خارجها بصورة متزامنة، ويجري استدعاؤها بشكل دائم كوسيط ضروري بين أطراف العلاقات الاجتماعية. فهي تمدّ هذه الأطراف بإطارٍ مرجعي، أو لغة مشتركة، تسمح بصياغة الرغبات والتوقعات والإكراهات بين هذه الأطراف، وتحدد أفق خيالها، كما تحجب الجانب الإكراهي لهذه العلاقات و الناتج عن الخلل الفادح في موازين القوى بين أطرافها. استدعاء القانون الروماني، أوالجرماني، و الأفكار الجمهورية، مثلًا، في خضم الثورات البورجوازية الأوروبية لصياغة القوانين المدنية والقواعد الدستورية الجديدة لا يمكن اعتباره بأي حال من الأحوال تطورًا عضويًا أخذًا في الاعتبار أن النظام القانوني - السياسي المستدعى نفسه سابق في نشأته بألفية كاملة على الأقل على العلاقات التي أتى لتنظيمها، كما أن محتواه تشكل تاريخيًا للتعامل مع واقع مختلف تمامًا. ولكن هذه النظم والأفكار شكلت أفضل الإمكانيات المتاحة أمام طبقة صاعدة تطمح لتعميم تصورها عن العلاقات الاجتماعية والسيطرة على جهاز الدولة في آن واحد. مفاهيم العقد مثلًا، وسلطان الإرادة، والتصورات عن توزيع الأدوار الاجتماعي بين الجنسين أو الفئات العمرية، والعلاقة بين السلطات، والقواعد التمثيلية والإدارية، كلها أمثلة على مفاهيم مشتقة من هذه النظم القانونية العتيقة و لكنها تمفصلت تاريخيًا مع علاقات الإنتاج الرأسمالية وصبغتها بطابعها بقدر ما تشكل محتواها الجديد عبر هذا التمفصل.
وكما أن العلاقة بين حزمتىّ العلاقات لم تكن علاقة تطور عضوي فهي كذلك لم تكن بعد تأسيسها علاقة تناغم أو تجانس بأي حال من الأحوال. ولكنها كانت علاقة توتر دائم أنتجت المزيد من الصراعات، خصوصًا مع ظهور طبقات جديدة كفاعل مستقل وعلى رأسها الطبقة العاملة الصناعية التي سعى ممثلوها لاستخدام ذات القواعد القانونية والسياسية لتعديل أو قلب العلاقات الاجتماعية القائمة. ونتيجة لهذه الصراعات شهد العالم الغربي ثورات سياسية واجتماعية، وفترات طويلة من الارتداد الخشن عن النظام الديمقراطي استخدمت فيها الطبقات المسيطرة جهاز الدولة للتسلط على عموم الطبقات الاجتماعية في هيئة نظم سلطوية وشمولية مختلفة. هذا التوتر هو المسئول عن استقرار التمييز بين المجتمع المدني (محيط تشكل وتمثيل المصالح الفردية والاقتصادية، كالسوق والنقابات مثلًا) والمجتمع السياسي (محيط الروابط والهويات الجمعية و القانونية المصطنعة) في الفكر القانوني والسياسي، وما تبع ذلك من التفكير في أنسب الطرق لإدارة العلاقة بينهما بما يضمن عدم انهيار التوازن الهش بين المجالين مرّة أخرى.
لم تشكل روابط المجتمع السياسي إذن في أي لحظة من لحظات التاريخ الغربي إلغاءًا أو نفيًا أو رفعًا لتناقضات المجتمع المدني في وحدة الدولة الدستورية الأرقى - كما ذهب هيجل وتبعه البشري بشكل لا واع - بقدر ما أنها أعادت إنتاجها في الحقيقة، وذلك بحكم إبقائها على الأساس المادي المنشئ لها، أي علاقات الإنتاج الرأسمالية. بعبارة أخرى، هذه الازدواجية بين المجتمعين المدني والسياسي، من وجهة النظر المادية والتي تؤيدها وقائع التاريخ، تعد سمة كامنة في واقع الرأسمالية، وجدت لتبقى، وتجد أساسها في التوزيع المختل للقوة في المجتمع، لا في اغتراب ثقافة الحاكمين، أو ثقافة جهاز الدولة، عن ثقافة المحكومين.
ومن ثم، فما أنجزته مجتمعات المراكز الرأسمالية الغربية من درجة أعلى من الوحدة بين الثقافة والقانون، أو بين القانون والأخلاق، هي نتاج تاريخ طويل من صراعات القوى الاجتماعية، وتوازناتها، التي عبرت عن نفسها من خلال هذه الوحدة، ولكنها ليست نقطة نهائية بأي حال من الأحوال، إذ أنها قابلة للتأزم، أو الانهيار حتى، كما حدث ويحدث. كما أن المسار الذي سلكته هذه المجتمعات حتى تنجز تلك الوحدة ليس مسارًا حتميًا يجب أن تسير فيه المجتمعات الرأسمالية كافة، بغض النظر عن خصوصيات تكونها. وبالطبع من المفهوم أن تتفاقم الازدواجية بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي في المجتمعات التي اندمجت في النظام الرأسمالي عبر الاستعمار بحكم تفاقم الخلل في موازين القوى الاجتماعية لدرجات غير مسبوقة، ولكن لا يمكن تجاوز هذه الازدواجية، أو حتى تلطيف حدتها، في هذه المجتمعات بدون استهداف جذورها في علاقات الانتاج الرأسمالية نفسها.
وبالتبعية، فمشاريع استعادة وحدة الجماعة العضوية المفترضة، أو مصالحة تناقضاتها في وحدة جديدة، بما في ذلك المشاريع التي ترفع راية “الأصالة” أو “التراث” أو “الشريعة”، هي في جوهرها مشاريع هيمنة مصطنعة تسعى لتأسيس علاقات جديدة للتعامل مع واقع جديد. وبالتالي، وكأي مشروع هيمنة، ستخرج تلك المشاريع للوجود محددة بعلاقات القوى القائمة نفسها والتي ستسهم في رسم أفقها الفكري، و صبغ مضمونها، و حتى توفير شروط إنتاجها المادية من تمويل و تنظيم. ومع التسليم بالفعّالية الأيديولوجية لمشاريع الهيمنة تلك، وقدرتها على مخاطبة الحس الأخلاقي لغالبية الناس في ظل عالم مازال محكومًا حتى اليوم بالمبدأ القومي/ الثقافي في تنظيم هوياته السياسية، إلا أنه لا ينبغي الانزلاق إلى نفي الطابع المصطنع عنها وكونها متمفصلة مع توزيع بعينه لعلاقات القوى، أو الحكم عليها وفقًا لدعايتها عن نفسها كتعبير شفاف عن واقع المجتمع. والأهم، أنه لا ينبغي الانزلاق إلي الاعتقاد بقدرتها على تقديم الحلّ النهائي للانقسامات الاجتماعية التي تسعى لتنظيمها، بقدر ما أنها ستسهم في إعادة إنتاجها، أو ستفرز انقسامات جديدة تستدعي بدورها التوسط الخارجي، ومن ثم الانفصام بين القانون والأخلاق وبين الدولة والجماعة. تجاهل هذه الشروط إما سيحكم على الفكر بالعزلة مع تصوراته المثالية منبتّة الصلة بالواقع أو - وهو الأسوأ- سيؤدي لاستيعاب الفكر في مشاريع هيمنة قائمة بدون أن يدري، وبحيث يقتصر دوره على تقديم غطاءً شرعيًا لمشروع سلطوي قائم على النحو الذي انتقده البشري.
الموروث كواقع وأيديولوجيا:
نعود الآن لاستئناف مناقشة أطروحات البشري على هدي من الإطار النظري السابق. ونبدأ بأطروحته المركزية عن ضرورة الانطلاق من التراث كما انتهى إلينا لإعادة بناء وحدة الجماعة الوطنية العضوية بشكل “أصيل”. في الحقيقة، فتأريخ البشري نفسه لتطور الرأسمالية و جهاز الدولة في مصر يدعم من افتراضنا عن استحالة هذا التطور العضوي من قلب التراث. وهذا التأريخ يوضح كذلك أن كل المشاريع التي رفعت شعارات “الأصالة” كانت في جوهرها مشاريع للهيمنة الاجتماعية تسعى للتعاطي مع الواقع الجديد بالاعتماد على علاقات القوى الحديثة التي حددت أفقها ومحتواها.
فالرجل يُفصّل بشكل دقيق كيف استطاعت النخب الحديثة القابضة على سلطة الدولة أن تمد سيطرة جهازها الإداري على المؤسسات الخمس التي شكلت حياة المصريين الاجتماعية عشية التوغل الغربي، وهي العائلات الممتدة في الريف، وطوائف الحرفيين، ومؤسسة الوقف، والطرق الصوفية، والتعليم الديني الأزهري.[32] العائلات الممتدة في الريف، وطوائف الحرفيين في المدن، تم تفكيكها على مراحل متتالية عبر تحديث قوى الإنتاج وتعميم علاقات الملكية الخاصة والعمل المأجور، في حين تمت تصفية مؤسسة الوقف والاستيلاء على أموالها ثم نسيان ممارسة الوقف تقريبًا مع الستينيات. أما الطرق الصوفية فقد تم إخضاع بنائها المؤسسي، وآليات اختيار قادتها، وأنشطتها، لرقابة دائمة انتهت عمليًا بتحول الطرق لرديف لأجهزة الدولة المحلية سواء في مجال العمل الخيري أو الدعوي. الأزهر في المقابل، ومنذ نهاية القرن التاسع عشر، تحول سريعًا لساحة لفرض نفوذ المؤسسة الخديوية، فالملكية، باعتباره أحد آخر المساحات التي يمكن لتلك المؤسسة الهيمنة عليها، وذلك في ظل تواطؤ من كبار ملاك الأراضي وممثليهم السياسيين، وعجز لممثلي الفئات الجديدة من مهنيين وبورجوازية صغيرة على إنتاج، أو فرض، تصور بديل. وبالتالي، فكل محاولة لإصلاح الأزهر بالشكل الذي يمكّنه من التصدي لدوره التجديدي المفترض، تمت "فرملة" إيقاعها في ضوء الصراع بين قيادات الحركة الوطنية وبين المؤسسة الملكية. وانتهت العملية برمتها إلى هيمنة اتجاهات محافظة موالية للملكية، ثم الرئاسة، في صفوف العلماء الذين أصبحوا يدينون بشروط وجودهم، ونفوذهم، كفئة متميزة داخل البيروقراطية لرأس الدولة عمومًا. وعلى هذه الأرضية، جرى على الأزهر ما جرى للطرق الصوفية، أي التحول لمؤسسة بيروقراطية رديفة تتحكم في إنتاجها الفكري و الدعوى اعتبارات شرعية النخب الحاكمة.
أما فيما يخص محتوى الإنتاج المعرفي للمؤسسة، فقد تحول بشكل عميق، كما ألمحنا في بداية المقال، ليلائم احتياجات مؤسسات الدولة في تخريج عدد مهول من الدعاة والمعلمين و المفتين والقضاة الشرعيين، أو القضاة القادرين على التصدي لقضايا الأحوال الشخصية، وهو ما أدى لإعادة بناء النصوص المؤسسة للتقليد الأزهري بفصلها عن التقاليد الحاكمة لتلقيها وفهمها وتفسيرها. فتراث المذاهب مثلًا جرى ضغطه في عدد من النصوص المحورية المنتقاة عبر حقب تاريخية شديدة التنوع ليحصلها الطالب المتخصص في عدد محدود من السنوات، في حين جرى ترحيل البحث المدقق إلى مراحل الدراسات العليا جريًا على التقليد الأوروبي. وما جرى على نصوص المذاهب جرى على نصوص علوم العقيدة والحديث واللغة وأصول الفقه كذلك. فتحول التراث لحزمة من النصوص المفصولة عن سياقها والتي تُقدم عبر تقنيات في التدريس متطابقة مع تقنيات تدريس نصوص القانون الأوروبي مثلًا. وهذا أمر يختلف جذريًا عن التقليد القديم المعتمد على إدراج طالب العلم الشرعي في سلك كامل من الممارسات تعتمد على العلاقة المباشرة مع الشيخ /المعلم /المربي، وعلى العلاقة مع المحيط الاجتماعي من طرق وطوائف وعائلات ممتدة، وعلى مقاربة النص المؤسس، أو المتن، باعتباره مركزًا لشبكة أخرى من النصوص التي ترتبط بمنطق واحد عبر تاريخ المذهب. فلا سلك الممارسات المسماه بالتراثية أصبح موجودًا، بحكم تحديث النظم التعليمية، ولا النص أصبح منتميًا لعالمه أو شبكته الخاصة، بقدر ما أصبح مرتبطًا بشبكة جديدة من النصوص هدفها النهائي هو إنتاج عالم حافظ “للتراث” ومدافعًا عنه هكذا في كليته المصنوعة. وبالتالي، فلا المؤسسة المنتجة للمعرفة، ولا المعرفة نفسها، أصبحت تراثية بالمعنى المفهوم للكلمة، بقدر ما أصبحت تنتظم حول ممارسات وعلاقات حديثة بالكامل. [33]
أما الحركات الإسلامية التي رفعت راية الدفاع عن الموروث فقد ارتكزت منذ تشكلها بدورها على فئات حديثة كقطاعات واسعة مغتربة من بورجوازية المدن الصغيرة ومثقفيهم، بجانب قطاعات من الطبقة العاملة الحضرية. وهي فئات لم تجد مكانًا في المجتمع السياسي الذي تشكل بعد خفوت نجم ثورة ١٩١٩، واستقراره على معادلة مغلقة ما بين كبار الملاك، والقصر، وأحزاب الحركة الوطنية. والأخيرة بدأت بدورها في الخضوع لسلطة كبار الملاك منذ بداية الثلاثينيات، ومن ثم عجزت عن تطوير لغتها الوطنية الديمقراطية لتستوعب رغبات، وإحباطات، جديدة. ومن ثم فتوجه قطاعات كبيرة من هذه الفئات للمنظمات الإسلامية كان بهدف البحث عن إطار رمزي، أو لغة مختلفة، تساعد في بلورة رغباتها وحفظ احترام وتماسك مواقعها داخل محيط اجتماعي يتغير باستمرار.
وهذا المحيط، إن جاز تسميته، فالأوقع أن يوصف “بالشعبي” وليس بالتقليدي. فما كان يجمعه ليس إطاره الثقافي، أو علاقاته الاجتماعية العتيقة، بقدر أن ما كان يجمعه هو طرفيته ذاتها في علاقته بمراكز سلطة الدولة أو الثروة، والتي يمدها هو نفسه بأسباب حياتها. وهو محيط مُركّب من علاقات مختلفة، بعضها سابق على الدولة الحديثة بالطبع - كما في حالة الطرق الصوفية التي ذكرناها - ولكنها توظفه في إعادة إنتاج سلطتها. وهو كذلك محيط كان يموج بأنماط ثقافية وممارسات أخلاقية مختلفة لا يمكن جمعها تحت عنوان واحد، ومهمة الإسلاميين كانت بالتبعية هي تسييد تصور واحد من التصورات علي هذا المحيط الشعبي وليس التعبير الشفاف عنه بأي حال من الأحوال. الحملة مثلًا على الاختلاط، وزي وسلوك النساء المجافي “للاحتشام”، لا تعني إلا شيوع هذه الممارسات في المحيط الشعبي، وترسخها، على النحو الذي يجعل من مواجهتها همًّا دائمًا حتى في ظل موجات صعود النضال الوطني. فما الذي يجعل منتسبي الحركة الإسلامية مثلًا أكثر تعبيرًا عن واقع وحقائق الحياة اليومية في هذا المحيط من جمهور مدعويهم من ممارسي هذه “الرذائل” وغيرها؟! الفارق في الحقيقة، أن هذا الجمهور لم يتمكن من التعبير عن رغباته المتجددة بمقولات واضحة ومتماسكة، ولا أن يقدمها كنمط حياة جدير بالاحترام، أو يحقق الرضاء عن الذات. وهو ما يعني أن ما قدمته الحركة الإسلامية لهذا الجمهور كان مفهومًا خارجيًا، أو مصطنعًا، يمكّنهم من الانخراط في العلاقات الاجتماعية الحديثة بكرامة ونديّة، وليس تعبيرًا عن حقيقة حياتهم نفسها. وهذا النزوع التبشيري استمر مع الانبعاث الثاني للحركات الإسلامية في السبعينيات. فقد اعتمد هذا البعث بدوره على قطاع أكبر من المتعلمين تعليمًا عاليًا من فئات متوسطة دنيا خبروا اغترابًا مضاعفًا عن المجتمع السياسي في ظل سلطوية النظام الناصري وفشل مشروعه التنموي، وقادهم ذلك إلى بلورة رؤى خلاصية تتبنى قطيعة فكرية كاملة مع القائم من علاقات وتدرك مهمتها كسعي لإعادة بناء لعقائد المصريين من جذورها.
وما يميز سعي الإسلاميين التبشيري المعاصر عن ممارسات التربية والدعوة الأخلاقيتين فيما قبل الحداثة، هو تحديدًا اعتمادهم على شبكة واسعة من المؤسسات الاجتماعية الحديثة بالكامل في بنائها وإدارتها الداخلية من جمعيات، ومعاهد علمية مستقلة، وفي مرحلة لاحقة مؤسسات اقتصادية تستهدف تمويل أنشطتهم ودعم رفاه مموليهم الصغار في نفس الوقت. والممارسات بداخل هذه الشبكة هي بدورها ممارسات حديثة بالكامل سواء في طابعها الرأسمالي أو البيروقراطي. وبالتوازي، تميز هذا السعي التبشيري بما رصده، وانتقده البشري نفسه، من استدعاء دائم لآليات الدولة الحديثة السلطوية من تشريع وضبط بوليسي لتسييد رؤيتها الأخلاقية على محيطها الشعبي.
وبالتالي، فكما أن الكلية، أو المعهد الأزهري، هما أبعد ما يكونان عن موقع “قديم” أو “تراثي” أو “تقليدي”، فالجمعية الخيرية أو المستشفى أو البنك أو الشركة التي تنتظم في دعم أنشطة الإسلاميين هي أبعد ما تكون بدورها عن موقع قديم أو تقليدي أو تراثي. وفي هذه الدوائر المعقدة من علاقات السلطة وممارساتها يُنتج ما يسميه البشري “بالموروث”. إذن فالموروث ليس واقعًا قائمًا يتخلل حياة الغالبية من الناس وتتنكر له الدولة الحديثة. الموروث، بالأحرى، هو تكوين حديث من العلاقات والممارسات والأفكار يدين في تشكله الدائم لفعل “الوافد”، سواء كان مناهجًا للنظر والبحث، أو تشريعات وقوانين منظمة، أو قواعد لتقسيم العمل والإدارة. وخطاب التمسك بالموروث إذن هو بناء فكري حديث مكتمل التكوين يعتمد في إنتاجه وهيمنته على رؤوس أموال تراكمت بفعل التحول الرأسمالي للمجتمع، أو على جهاز الدولة البيروقراطي الحديث نفسه، ويسهم في بلورة مصالح وهويات شبكة واسعة من فئات اجتماعية حديثة يمكن تحديدها بدقة في إطار صراعات اجتماعية وسياسية ملموسة.
وهذا الموروث “المخترع” لا يشبه في الحقيقة، وفقًا لتأريخ البشري، شيئًا من السائد من أفكار ومؤسسات في بداية القرن التاسع عشر، فلا رؤية مسلمي اليوم للإسلام - بمن فيهم الأكثر تشددًا وتطرفًا - مشابهه لرؤية مسلمي القرن التاسع عشر، ولا يتلقى المصريون هذه الرؤية بشكل عضوي وتلقائي. العكس تمامًا هو الصحيح. هذا “الموروث”، سواء رُوج على يد دعاة الأزهر أو دعاة الحركة الإسلامية أو حتى مشايخ الطرق الصوفية، يجري تلقيه كشئ جديد تمامًا مخالفًا للسائد من قيم ومعتقدات. بل إنه لا يكتسب فعاليته الاجتماعية إلا لكونه مخالفًا للسائد. وخبرة التلقي هنا هي خبرة قطيعة بالأساس - فالرؤى السلفية في تلقيها هي تصحيح للعقيدة وبناء لها من جذورها، وفي المقابل فالرؤى الصوفية هي تصحيح للعقيدة وبناء لها من جذورها في مواجهة الرؤى السلفية نفسها، وهكذا. ومن ثم فالموقف من خطاب التمسك “بالموروث”، كخطاب أيديولوجي خارجي، لا يمكن اشتقاقه من دعايته عن نفسه كتعبير عضوي عن حياة المصريين، ولكنه يجب أن يتحدد وفقًا لحقيقته كأيديولوجية تعبر عن تحالفات اجتماعية بعينها - أيديولوجية لا يمكن رفضها أو قبولها أو تنقيحها إلا بفهم طبيعة هذه التحالفات نفسها.
التباسات ثلاثة:
العجز عن إدراك هذا الطابع المصنوع للخطابات التي رفعت شعار الأصالة والتراث، قاد البشري إلى ثلاثة التباسات رئيسية تتعلق برؤيته لتاريخ الحركة الوطنية المصرية، واستراتيجياته المقترحة لاستئناف مشروعها، ورؤيته لمضمون وحدود الحريات الديمقراطية اللازمة للتعبير عن الإرادة الوطنية.
بخصوص الالتباس الأول، فثنائية الوافد والموروث لدى البشري قد شوشت على إدراكه لخطوط الانقسام الحقيقية في تاريخ المشروع الوطني الديمقراطي المصري، والتي استكشفها هو نفسه بالفعل في كتاباته. فالمتتبع لتأريخه في الطبعة الأولى من “الحركة السياسية”سيرى ببساطة أن مشروع تأسيس جماعة وطنية مصرية قد انقسم سريعًا مع نهاية الحرب العالمية الأولى إلى يمين ويسار، وأن موضوعات الانقسام كانت دائمًا هي حدود الاستقلال الوطني وما إذا كان يمكن حصره في الاستقلال القانوني المتدرج وفقط، وحدود الحريات الديمقراطية في مواجهة الفئات الحاكمة القديمة والجديدة المتحلقة دائمًا حول المؤسسة الملكية، أو الرئاسة، أو قمة الهرم الإداري للدولة بشكل عام، وبالطبع مضمون السياسات الاقتصادية والاجتماعية ومدى انحيازها للأغلبية. وجهاز الدولة بالمعنى المؤسسي الذي يشرحه البشري جسّد في تطوره الاتجاهين معًا بوصفه جهاز مخترق بدرجات متفاوتة من قبل مختلف الفئات الاجتماعية الحاملة لتلك المشاريع. ويمكن الحكم بالتالي على توجهات هذا الجهاز بشأن القضايا الثلاث عبر خط الانقسام اليميني أو اليساري، كما يمكن الحكم بنفس المعيار على أطروحات التيارات الفكرية والسياسية، بما في ذلك دعاة الحداثة ودعاة الأصالة. فلدينا بالتالي حداثيون منحازون لليمين وحداثيون منحازون لليسار، وتراثيون منحازون لليمين وآخرون منحازون لليسار. وأصحاب أيديولوجية “الموروث” تحديدًا كانوا في المجمل على اليمين من خط الانقسام هذا (باستثناءات قليلة لا تشكل تيارًا يعتد به في الواقع ولا تستطيع التأثير في البناء القانوني أو السياسات العامة). ومن ثم فلا يمكن والحال كذلك أن يصبح الموقف من “الموروث” معيارًا قائمًا بحد ذاته للتصنيف يضاف إلى المعايير الثلاثة.
إقحام البشري لهذه الثنائية على معايير تصنيفه قاده كذلك لصك معايير جامدة للغاية في تقييم القوى التي تصدت لقيادة مشروع الاستقلال الوطني. فالتفتيش عن مشروع مناهض للاستعمار ومنحاز للديمقراطية ومتمثل لتراث الناس المتخيل في نفس الوقت جعله لا يخلع صفة الوطنية الديمقراطية الجامعة إلا على تكوينات محدودة ظهرت في لحظات تاريخية نادرة تقريبًا كالوفد ما بين ١٩١٩ ونهاية العشرينيات، وقيادة نظام يوليو ما بين العدوان الثلاثي وحتى منتصف الستينيات، وما دون ذلك هو انحراف أو تخبط. هدفنا هنا ليس محاولة توسيع معيار التقييم ليشمل قوى سياسية أخرى من عدمه، بقدر ما هو الاتفاق على معيار تقييم واقعي ومرن، ومؤسس على فهم عميق للجذور الاجتماعية للمشاريع المتصارعة. فالموقف من مشاريع الفئات الحاكمة لدى البشري لا ينبني على فهم معمق لجذورها الاجتماعية المتحولة، بقدر ما يُشتق من محاكمة مجردة لتوجهاتها في مرآة التاريخ الوطني الذي كشف عن حقيقته كاملة قبل قرن من الزمان تقريبًا. ومن ثم فسياسات السادات مثلًا أو مبارك وصولًا لمشروع التوريث يرفضها البشري كلها دون التفكير في الاختلافات العميقة بين هذه المشاريع المختلفة، بوصفها انحرافات عن الخط الوطني الديمقراطي وفقط.
الالتباس الثاني يتعلق بالاستراتيجية أو رؤية المستقبل. فتصور البشري عن محتوى الإجماع بين التيارات السياسية اللازم لتجاوز التضاد بين الدولة والأمة يتناقض مع منهجه المقترح لبناء هذا الإجماع نفسه. البشري يطرح في “تيار أساسي للأمة” تصوره عن عملية بناء الإجماع اللازم بوصفها عملية معقدة تتجاوز الحوار الفكري بين التيارات إلى المنافسة السياسية، سواء على صعيد السلطة السياسية في المجتمع أو داخل مؤسسات المجتمع المدني. وعبر هذه المنافسة، أو التجربة والخطأ، ستترسب حتمًا مقومات هذا الإجماع لتتشاركها وتعبر عنها مختلف المنظمات السياسية والمدنية في المجتمع. إلا أنه يعود ليستبق هذه العملية، ويستخلص محتوى هذا الإجماع من خلال قراءته لتاريخ مراحل التحرر الوطني ويعلنه في ثلاثة بنود أساسية، وهي الالتزام بما يسميه “استقلال الذات الحضارية” العقائدي والنفسي، والاستقلال السياسي في مواجهة الإملاء الخارجي، والاستقلال الاقتصادي متمثلًا في التنمية المعتمدة على الذات.[34] والقارئ هنا لا يسعه إلا التساؤل: هل هذه المقومات هي محض تنبؤ بنتيجة حتمية للمنافسة السياسية، أم أنها منطلقات ينبغي الاتفاق عليها كشروط قبلية لهذه المنافسة؟
في حالة كونها تنبؤ، فهو تنبؤ يصدر في الحقيقة عن فهم مثالي للممارسة السياسية - مستوحى من الأدبيات الليبرالية الغربية نفسها ما أسلفنا، وكذلك من قناعاته الناصرية السابقة - يرى أن الممارسة السياسية تنحو باتجاه الإجماع إذا أتيحت لها فرصة التطور الطبيعي بدون الكبح الاستعماري الخارجي. بينما أن الواقع يؤشر أن الممارسة السياسية في المجتمعات الرأسمالية هي ممارسات تدور حول علاقات قوى بهدف ترسيخها أو تعديلها أو قلبها، وهو ما يعني نزوعها الدائم نحو الاستقطاب أخذًا في الاعتبار الطابع الإكراهي الكامن في علاقات القوى الاجتماعية. وهذا الاستقطاب سيتعمق في حالتنا بحكم تحلل الأطر المرجعية السابقة على التحول الرأسمالي، وعوز الأطر الجديدة، من دساتير وسلطات تشريعية وقضائية، للشرعية اللازمة. ومن ثم فتأسيس ما يسمى بالإجماع، أو الحلول الوسط، هي إمكانية لا يمكن التنبؤ بمحتواها سلفًا بقدر ما أنها تتوقف على توازنات القوى كما أشرنا، وكذلك على محتوى المشاريع السياسية التي تتصارع والتي سيشكل الإجماع حلولًا وسطًا بينها.
أما إذا كانت هذه المقومات مطروحة كشروط قبلية للممارسة السياسية، أو التزامات متبادلة تعبر عنها صيغة ميثاقية ما، فهي تتجاهل أن المقومات الثلاثة المطروحة هي نفسها موضوعات الانقسام بين القوى السياسية القائمة. وهي قوى لم تتبلور إلا لاختلافها حول مضامين هذه المقومات، أي الاختلاف حول هوية هذه “الذات الحضارية” وتقييم تاريخها، وحول معنى الاستقلال الاقتصادي وما إذا كان إنجازه ممكنًا في ظل الارتباط بالسوق الرأسمالي العالمي أو اتباع السياسات الليبرالية في الداخل، وكذلك حول معنى الاستقلال السياسي وما إذا كان محصورًا في الكيانات الجغرافية التي أنشأها الاستعمار أم أنه يعد مرحلة من مراحل تأسيس كيانات أوسع عروبية كانت أم إسلامية. بعبارة أخرى، الاكتفاء بإعلان هذه المقومات كأرضية مشتركة لا يذهب بنا بعيدًا لأنه يتجنب تناول نقاط الاختلاف الأساسية بين هذه التيارات، ويصبح الأمر كما لو أنه محاولة غامضة لتحويل نقاط الاستقطاب بحد ذاتها لنقاط تجميع أو توافق.
غرض هذا الاستطراد ليس نفي إمكانية أي مشروع توفيقي، ينشأ على أرضية تصالحية بين التيارات الفكرية والسياسية الرئيسية، ولا أن هذا المشروع قد ينتج مع الوقت مضمونه الفكري الذي قد يتسع ويزداد عمقًا ليتحول لإجماع تتحرك في إطاره التيارات المختلفة ويفرض قيودًا على سلطة الدولة. ولكنه في الحقيقة محاولة لتنقية فكرة التوافق من أية أبعاد مثالية، أو ثقافية، عابرة للتاريخ تحولها لقدر ثابت للقوى السياسية المصرية، كما أنه محاولة لتوضيح فكرتنا أن مضمون هذا الإجماع لا يمكن التنبؤ به سلفًا، ناهيك عن تصميمه عبر قراءة التاريخ. التوافق في الحقيقة هو نقطة نهاية، يجب أن يتوفر عدد من الشروط الموضوعية حتى يمكن الوصول إليها، وعلى رأس هذه الشروط يأتي التبلور التنظيمي للقوى الاجتماعية والسياسية المختلفة ووضوح برامجها - على أرضية يمين ويسار - بدون حدود أو محاذير يضعها المفكرون، وبدون أوهام مسبقة عن إجماع محمول عبر التاريخ. أما البحث الدائم عن التوافق قبل تبلور أطرافه فيعني الحكم الدائم على الباحثين بالدوران في فلك الدعاية المجردة عبر المنابر الإعلامية دون نفوذ شعبي يذكر، وهو ما ينعيه البشري على دعاة “الوافد” من ليبراليين وقوميين ويساريين.[35]
وهذه هي ببساطة دروس التاريخ المصري الحديث نفسه. هذا هو ما حدث مثلًا في الفترة ما بين بداية القرن الماضي ونهاية الحرب العالمية الأولى، حيث تبلورت رؤى مكتملة لمسألة الاستقلال سواء على يد الحزب الوطني أو حزب الأمة، وظهر الوفد كتركيب بين الرؤيتين مع ثورة ١٩١٩. بل إن هذا تحديدًا هو درس التاريخ القريب كذلك. فخلال عقد التسعينيات، بعد استتاب الأمر لنظام مبارك بشكل كامل وتخلصه من تهديدات الجماعات الإسلامية المسلحة، وقبل ذلك من معارضته اليسارية أو القومية، لم يكن أمام أنصار رؤية البشري من بقايا هذه المعارضة لبناء الجبهة الجامعة إلا التحالف مع القوة الوحيدة التي احتفظت بنفوذ شعبي واسع، أي الإخوان المسلمين. ولكن هذه المحاولات افتقرت لأي دافع واقعي يشجع الإخوان على القبول طوعًا بتنازلات برامجية، ومن ثم التضحية بنفوذ سياسي متحقق بالفعل، للانضواء تحت راية مشروع آخر يجسد رؤية بديلة للوطنية والدين والتراث. في الواقع، كان التوجس أو عدم الاكتراث، وفي بعض الأحيان الرفض الصريح، هو موقف الإخوان من كل دعاوى العمل الجبهوي العميق، أي ذاك الذي يتجاوز البيانات المشتركة في الإعلام إلى فعاليات علي الأرض سيدفع ثمنها جمهور الإخوان وحدهم تقريبًا بحكم كونهم تيار الأغلبية. وبالتالي، ومن باب المفارقات التاريخية، أن دعوة البشري لجسر الفجوة بين الرؤية الإسلامية للتاريخ الوطني الحديث للمصريين والرؤية القومية واليسارية قد لاقت صدى أوسع بكثير لدى الأخيرين وهم من التيارات المصنفة “وافدة” فكريًا مقارنة بالتيار الإسلامي. فبينما انفتحت أصوات وازنة في أوساط المثقفين القوميين واليساريين على رؤية البشري لم تؤثر رؤيته إلا في هوامش التيار الإسلامي. ولا عجب في ذلك أخذًا في الاعتبار أن ما يطرحه البشري من رؤية توفيقية هي أنسب بطبيعة الحال لجماعات المثقفين المنخرطين في الدعاية الفكرية أو العمل المهني- أي أنسب لأقرانه من المثقفين الوطنيين وليس لمثقفي الإخوان المُنظّمِين الحركيين. وبالطبع كان هذا هو درس التاريخ الأكثر قربًا مع ثورة يناير ٢٠١١ وإن كنا سنتناول هذه المحطة في قسم منفصل.
الالتباس الثالث، والأخطر، يتعلق برؤية البشري لمضمون وحدود الحريات الديمقراطية. الحريات الديمقراطية لدى البشري، كما شرحنا سابقًا، هي ضرورة لتقرير الجماعة الوطنية لمصيرها وتشكيل إرادتها العامة، ولا يبدو أنها تتسع لما هو أكثر من ذلك على صعيد الحريات الشخصية مثلًا. نحن هنا لا ننقد رؤية البشري من خارجها؛ فالرجل لم يكن ملزمًا بطبيعة الحال أن يتبنى تصور خصومه ونقادّه لمضمون الحريات الديمقراطية. ولكننا فقط ننبه أن هذا المفهوم الضيق للحريات الديمقراطية الذي يحصرها في الجانب السياسي لن يتمكن من الإحاطة بقسم كبير من المطالب الاجتماعية للمنتمين لهذه الجماعة الوطنية والذين لن يجدوا مكانًا في ثنائياته، ومن ثم سيدفعهم ذلك، أراد البشري أم لم يرد، بعيدًا عن المشروع الوطني الديمقراطي الجبهوي.
فتاريخيًا كان من الواضح أنه مع كل مكسب عام يدفع باتجاه الاستقلال السياسي للجماعة الوطنية خطوة للأمام، تتحول بؤرة الصراع السياسي سريعًا لتتركز حول العلاقات الاجتماعية المشكلة لقوام هذه الجماعة. ويعود هذا التحول إلى فعل الحريات التنظيمية المكتسبة في سياق التعبئة الوطنية والتي تمكّن جماعات ضخمة لم يجر استدعاؤها سابقًا من أدوات الفعل السياسي، ومن ثم تسمح لها هذه الحريات الجديدة بمسائلة صفات التقليدية، أو الثبات، للسائد من علاقات اجتماعية، هذا بخلاف الشحنة الشعورية المصاحبة حتمًا لفكرة الاستقلال الوطني كقطع مع الماضي: فإذا كان الاستقلال تحررًا من الماضي وفتحًا جديدًا لآفاق غير مطروقة، فأثر الماضي في الحاضر سرعان ما يصبح عرضة للهجوم من أطراف مختلفة. على سبيل المثال، كل خطوة على سبيل الاستقلال السياسي في مجتمعات المستعمرات السابقة رافقها، أو أعقبها، صعودًا للحركات العمالية والفلاحية، وتمردات الشباب المتعلم، وظهورًا للحركات النسوية، ولاتجاهات أدبية وفنية طليعية غير مألوفة. وهذا الطيف الواسع من التحركات الشعبية اغتني من فكرة الاستقلال الوطني لصياغة هويته ورؤاه كتعبير عن حركة التاريخ السائرة حتمًا للأمام.
ومصر لم تكن استثناءً من ذلك، فموجات تكاثر الهويات و المطالب الديمقراطية، وتنوعها، وامتدادها خارج حدود الفئات العليا المغتربة عن المجتمع، لم تترافق فقط مع موجات السيطرة الاستعمارية على أجهزة الحكم والإدارة والتوجيه الفكري، ولكنها ترافقت في المقام الأول مع موجات مقاومة هذه السيطرة الاستعمارية وانتعشت تحت ألويتها. حدث ذلك في العقد الأول من القرن الماضي عقب تجاوز صدمة هزيمة الثورة العرابية وتمكّن الاحتلال البريطاني، وحدث ذلك عقب ثورة ١٩١٩ وانتزاع الدستور والاستقلال القانوني، وحدث ذلك عقب نهاية الحرب العالمية الثانية مع تصاعد موجة النضال ضد التبعية لبريطانيا، وبعد انتصار النظام الناصري السياسي في معركة السويس، وبالطبع مع يناير ٢٠١١. كل هذه التحركات، بتياراتها المتنوعة، لا يمكن جمعها أبدًا تحت راية واحدة هي راية “الوافد”، وإلا انتفت الفوارق مثلًا بين باشوات الأحرار الدستوريين المترفين ومناضلي الحركة الشيوعية، أو بين كبار الملاك في قيادة الوفد وبين مثقفي الطليعة الوفدية ذوي الميل الليبرالي الاجتماعي الذين امتدحهم البشري في أكثر من موضع.
بعبارة أخرى، فالموقف المناهض للأيديولوجية التقليدية أو التراثية، والذي رفعه دعاة التقدمية أو الحداثة، لم يكن في الغالب محض انحياز لوافد على يد الفئات الحاكمة، ولكنه موقف من العلاقات الاجتماعية التي تسعى الأيديولوجية التراثية إما لتثبيتها، أو اختراعها، بدعم من الفئات الحاكمة في الكثير من الأحيان. والشيء بالشيء يذكر، فشعبية دعاة “الموروث” السياسيين النسبية بدورها لا ترجع لكونهم أكثر “أصالة”. ولكنها ترجع لأن الممثلين السياسيين لهذه التيارات تحركوا على أرضية محروثة سلفًا في الدساتير والتشريعات والخطاب الأخلاقي الرسمي ومحتوى المناهج التعليمية، وهو محتوى تشكل بفعل تمسك الفئات الحاكمة منذ مطلع القرن الماضي في مناوراتها مع القوى الديمقراطية بتوظيف الدين في سعيها للشرعية كما أوضحنا. بالإضافة إلى ذلك، فمصادرة المجال العام لم تخضع شعبية دعاة الموروث للاختبار الجدي، وعندما انتفت الكوابح السلطوية بعد ثورة يناير ٢٠١١ رأينًا أن هذه الشعبية لم تصل في أي مرحلة لمرتبة الإجماع الوطني كما في حالة الوفد في العشرينيات والثلاثينيات، بل إن هذه الشعبية تآكلت سريعًا مخلفة استقطابا حقيقيا عصيًّا على الحلّ.
التجديد وحدوده:
بالرغم من ذلك، يبدو البشري، بحسّه المدقق، واعيًا في مواضع متفرقة من كتاباته للجذور الاجتماعية للافتات الوافد والموروث، وكونها تعبيرًا عن مشاريع للهيمنة، ويتعامل مع الاستقطاب بين التيارين كمعضلة حقيقية وليس كمحض عرض لاستعمار ثقافي. ولكنه -كما أوضحنا- يحيل أمر حلّ هذه المعضلات والاستقطابات بين الرؤى المختلفة بشأن العلاقات الاجتماعية لعملية التجديد الفقهي الكفيلة بمصالحة هذ الأقطاب جميعًا. ولكن من يقوم على أمر التجديد الفقهي في هذه الحالة؟ وما الضامن لقبول منتج هذا التجديد؟ هنا -مرة أخرى- يغيب التحليل الاجتماعي للشروط المطلوبة لعملية التجديد تمامًا، وتظهر العملية كما لو كانت نشاطًا فكريًا محضًا تعكف عليه مجموعة من المثقفين المماثلين للبشري نفسه في تكوينه كفقهاء وقانونيين وقضاة لا يحركهم إلا نزوعهم الفني، وضميرهم الوطني، وارتباطهم الشعوري بعقيدة وتاريخ المسلمين.
كي نتحاشى الحديث المجرد نعود للتاريخ مرة أخرى ونتساءل: ما الذي أكسب العلماء مكانتهم في المجتمعات السابقة على زمن الدولة الحديثة، وجعل دورهم مقبولًا من عموم الناس؟ الإجابة المرضية على هذا السؤال لن تبدأ في التبلور إلا بالبحث في طبيعة العلاقات الاجتماعية السائدة في هذا الزمان. يشير عدد من الدراسات التاريخية الحديثة[36] إلى جملة من الشروط الاجتماعية التي سمحت بحفظ مجال إنتاج المعرفة الدينية والقانونية بعيدًا عن تقلبات وتدخلات السلطة السياسية، خصوصًا بعد انهيار الإمبراطوريات الإسلامية الكبرى مع نهاية القرن العاشر الميلادي. يأتي على رأس هذه الشروط العجز المتأصل في أدوات هذه السلطة خلال هذا العصر، وعدم قدرتها على بسط نفوذها على أوجه الحياة الاجتماعية المختلفة بحكم تخلف قوى الإنتاج، وبحكم غربة الحكام الجدد -من عسكر تُرك بالأساس- عن الحياة الاجتماعية لمحكوميهم.
وفي حين تراكمت فوائض مالية هائلة في يد حكام وملّاك هذه الأزمان عبر الخراج والضرائب والتجارة العابرة للبحار، لم تؤد هذه الفوائض لتعميم علاقات الإنتاج الرأسمالية عبر استغلال عمل الآخرين، ومن ثم تجريدهم من أدوات الإنتاج وتعميق الانقسامات الطبقية بالتبعية. هذا العجز المتأصل أدى في المقابل لتنظيم مجتمعات المسلمين لمعاملاتها بدون تدخل كثيف من قبل هذه السلطات العاجزة والمفككة بالرغم مما تمتلكه من قدرة على البطش. وهذا الظرف الممتد لقرون هو ما سمح للشريعة أن تتحول لإطار رمزي لهذه المجتمعات المحلية ينظم تعاملاتها ويحلّ بذاته محلّ مؤسسة الخلافة كمجسد لوحدة المسلمين، كما سمح للمعرفة الدينية والقانونية أن تتطور دون تدخل يذكر من جانب السلطة السياسية، ومعها تبلور دور حملتها كممثلين طبيعين لهذا المجتمع ينأوا بأنفسهم عن صراعات الحكم طالما ظل الحكام محترمين لحيز سلطتهم.
أما الآن، فقد انتفت منذ قرنين تقريبًا من الزمان جميع الكوابح التي حالت دون تدخل الدولة الكثيف في تنظيم العلاقات الاجتماعية، وتمكّن رأس المال من إدراج حياة الناس بالكامل في دائرته، وتعمقت بالتالي انقساماتهم الطبقية بحكم مواقعهم من هذه العملية. واستعرضنا كيف أن البشري قد أرّخ لعملية التحديث وأثرها في المجال القانوني ومجال إنتاج المعرفة الدينية بشكل دقيق، وكيف أن العلاقات الاجتماعية التي أفرزت استقلال مجال إنتاج المعرفة الدينية والقانونية قد تحطمت تمامًا وتلاشى أثرها من ذاكرة الناس. بالتالي، فأي شبكة من المجددين (الفقهاء والقانونيين والحركيين) ستعتمد في حركتها الآن حُكمًا على مؤسسات حديثة: إما جهاز الدولة البيروقراطي نفسه، أو رأس مال خاص، خليجي أو محلي، يوظفها في خدمته بشكل مباشر، كما في حالة الدعوة للبنوك الإسلامية التي امتدحها البشري، أو مؤسسات مدنية أو أهلية تخرج بدورها من رحم فئات اجتماعية حديثة وتعتمد عليها في تمويلها وإدارتها (جمعيات، نقابات، مؤسسات تعليمية بديلة، شبكة مساجد… إلخ). ومضمون التجديد، أو الإسناد الفقهي، كما أوضحنا في القسم السابق، سيتحدد بدوره في ضوء شبكة المصالح الجديدة التي تسمح للمجددين بالإنتاج الفكري. باختصار، لا إمكانية للمثقف المجدد، سواء كان فقيهًا أو قانونيًا، أن يتحرك بمعزل عن واقع الانقسامات الطبقية في العالم الرأسمالي حيث لا وجود لجماعة شعبية موحدة تنظم نفسها ذاتيًا كما كان الحال في عالم ما قبل الدولة الحديثة.
البشري مثلًا عندما تعرض في كتابه سالف الذكر عن “الوضع القانوني المعاصر” لمسألة تنظيم الإنتاج الزراعي في ظل نهاية العائلة الممتدة كوحدة إنتاجية متكاملة، عبّر عن حيرته بوضوح حيث إن جميع البدائل الممكنة تضمنت، أو قد تتضمن، إجحافًا للفلاح الصغير أو المجرد من الملكية، سواء اتجهت السياسة العامة لإطلاق الملكية الزراعية، أو توجهت الدولة لتأميم الأرض، أو حتى شجعت التعاونيات، إذ أن الفلاحين الصغار سيعودون للاعتماد على البنوك مرة أخرى لتمويل مدخلات الإنتاج في كل الحالات.[37] وأحجم البشري عن تقديم حلّ واضح إقرارًا منه بأن أي حل سيكون منحازًا بالضرورة لمصلحة ما على حساب تصوره التوفيقي التصالحي. هذه الحيرة ضربت موقف البشري ونحن نتحدث عن مسألة لم تقع في قلب الصراع الفكري الإسلامي العلماني، فما بالك لو تطرق الحديث لمسائل كتنظم الأحوال الشخصية، أو قواعد الإرث، وكلها مسائل تقتضي انحيازًا لمواقع طبقية وتنتج مراكز قانونية متفاوتة القوة. ثم هناك الأسئلة الأكثر صعوبة، والمطروحة دائمًا على الفكر الدستوري والقانوني الحديث، والمتعلقة بحدود الحريات الشخصية والعامة، والقيود المشروعة التي تفرضها الدولة على هذه الحريات. هنا كذلك، ستخرج رؤية المجدد مصبوغة بانحيازاته الطبقية، وموقعه من شبكة الإنتاج الفكري، والتي ستحدد وجهة نظره حول هذه الحدود، ومثال رؤية الحركات الإسلامية لمسألة الحريات الشخصية في القسم السابق كاشف.
قد يعلق القارئ بألا مشكلة في تنوع اجتهادات المجددين تجاه هذه المسائل، وغيرها، طالما التزمت بالضوابط الأصولية المعروفة في استباط الأحكام الشرعية، بل على العكس، سيتحول هذا التنوع إلى مصدر حيوية إضافي للمجتمع الأهلي يضفي عليه طابعًا ديمقراطيًا عميقًا. لا مشكلة مبدئية لديّ مع هذا التحفظ، ولكن المشكلات ستكون لدى البشري نفسه على الأرجح.
المشكلة الأولى، أن هذا التنوع والانقسام يعني قبولًا ضمنيًا بانفصام الوحدة العضوية للجماعة الوطنية، وألّا إمكانية للتعبير السياسي الموحد عن مشروعها الوطني الديمقراطي كما ذكرنا في القسم السابق. بل إن عناصر الإجماع الوطني في هذه الحالة ستستمر في التآكل حتى تقتصر على حد أدنى رقيق من الاتفاقات الكبرى تشبه ما هو متعارف عليه في كافة الدول الحديثة، خصوصًا الديمقراطية منها. وحلّ الاستقطابات في هذه الحالة سيكون عن طريق الصراع السياسي بالضرورة على خطوط الانقسام يمين/يسار التي تحدثنا عنها.
المشكلة الثانية أن “تخلل” خلاصات التجديد المتنوعة للدولة، كما تمنى البشري، يعني بالضرورة تخلل صراعات المجتمع المدني المقنعة بقناع فقهي لجهاز الدولة، ومزاحمة بعضها البعض في التشريعات والسياسات. مصر نفسها تعد نموذجًا مثاليًا لدولة تتراكم في قوانينها، وسياساتها، وقواعد إدارتها، اجتهادات فقهية متناقضة تنتمي كلها لمجددي القرن الماضي دون حسم واضح، وتعبر كلها عن انحيازات اجتماعية مختلفة. وانحياز القابضين على سلطة الدولة لأي من هذه الاجتهادات في أي من المسائل، أو التوفيق بينها، لم يعن في أي لحظة حسمًا للصراع، أو حل للتناقضات في وحدة أرقى، بقدر ما كان بمثابة تسوية مؤقتة تسببت بدورها في المزيد من الاضطراب داخل الجسم التشريعي.
المشكلة الثالثة، والأخيرة، أن تلافى تحول “التخلل” إلى عامل إرباك وتناقض، كما هو الحال في الوقت الراهن، يقتضي بالضرورة إيجاد آلية سلطوية لتنظيم عملية الاجتهاد وتأسيس قواعد ومرجعيات للاختيار على أساسها. وهذه الآلية كانت ولا زالت، كما ألمحنا في القسم السابق، موكولة للأزهر بوصفه المؤسسة المنوط بها حصرًا تنظيم عملية إنتاج المعرفة الدينية الإسلامية. ولكن لا يختلف إثنان تقريبًا على أن الوضع الحالي لا يمكّن الأزهر من لعب هذا الدور بكفاءة نظرًا لافتقاره للاستقلال المادي والإداري، والتدخل الأمني الدائم في إدارة شئونه الداخلية، وعدم وضوح اختصاصاته وتضاربها في الكثير من الأحيان مع عدد من المؤسسات الدينية الأخرى. محاولة تجاوز هذا الوضع لن يكون إلا من طريقين. الطريق الأول، هو دعم استقلال الأزهر المادي والإداري بما يسمح له بتطوير عملية التعليم والإنتاج المعرفي بحرية، مع تقليص صفات الاحتكار و الإلزامية لآرائه في عملية التشريع أو الرقابة في ذات الوقت. هذا الترتيب قد يسمح للتعددية داخل، وخارج، الأزهر بالتعبير المتساوي عن نفسها، ويتيح للسلطات المدنية في المقابل مزيدًا من المرونة في التعامل مع منتجات هذه الحالة. هذا الطرح هو ما تبنته عدد من القوى الموصوفة بالمدنية - بل والأزهر نفسه في وثيقتيه الشهيريتين في ٢٠١١- عند الجدل حول الدستور خلال المرحلة الانتقالية الأولى، واتهمت هذه الأطروحات بالعلمانية والاغتراب في حينها.[38] الطريق الثاني، هو دعم استقلال الأزهر مع تدعيم الطابع الاحتكاري والإلزامي لاختصاصاته على النحو الذي يمكّن قيادته من حسم التضارب في الاجتهادات بنفسها. وهذا الترتيب يحول الأزهر عمليًا لمؤسسة دستورية تضطلع بأدوار محورية في عملية التشريع وصناعة السياسات العامة ولكنها لا تخضع للمتعارف عليه من قواعد الرقابة الديمقراطية، أللهم قواعد الإشراف الإداري العام التي تسري على أي مؤسسة عامة. والحل الثاني هو ما تبنته عموم القوى الإسلامية، والأزهر نفسه في مرحلة لاحقة، بل وقيادة نظام ما بعد يوليو ٢٠١٣، وعكسته دساتير ٢٠١٢ و٢٠١٤ في المواد ٤ و٧ على الترتيب.
البشري لم يعبر عن موقف واضح من الجدل حول الأزهر في دساتير ما بعد يناير، ولم يعلق على هذه المواد عندما تصدي بالتعليق على الدستورين.[39] ولكن سوابقه القضائية تؤشر بجلاء لانحيازه للخيار الثاني، أي دسترة ودعم سلطات الأزهر الرقابية. ففي فتواه الشهيرة[40] عن دور الأزهر في الرقابة على الأعمال الإبداعية التي تتناول “شئون الإسلام”، وصلاحيته في التوصية بمنعها، إبان رئاسته للجمعية العامة لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، ينحاز البشري بوضوح لضرورة رقابة الأزهر - بوضعه الحالي التابع والمفتقر للاستقلال والذي لا يستطيع فرض رؤاه إلا عبر الأجهزة الإدارية والقمعية الحديثة - باعتبار ذلك من مقتضيات الضبط الاجتماعي في الدولة الحديثة، أو للحفاظ على “النظام العام” للدولة.[41] فقد اعتبر الأزهر هنا محض مؤسسة بيروقراطية تكتسب دورها بحكم وجود نص دستوري - صاغته سلطة علمانية - يتحدث عن الشريعة كمصدر رئيسي للتشريع. هنا لم يستطع البشري الفكاك من أسر الرؤية الوضعية الغربية للقانون، فرفع الشريعة لمرتبة القاعدة القانونية الأم التي تتفرع منها القواعد الفرعية وتقوم على تطبيقها أجهزة الإدارة كما في حالة أي قانون وضعي - لا تلقي تلقائي أو عضوي، ولا موروث حيّ يتفاعل، بل قواعد قانونية آمرة مجردة يدركها الناس كأمر قادم من عالم آخر هابط على واقعهم وليقبلها من شاء ولا يسع الرافض إلا الامتثال. هنا يقع البشري تحديدًا فيما اعتبره خطأً قاتلًا لدعاة تطبيق الشريعة من الإسلاميين، أي توظيف المعرفة الفقهية في إضفاء طابع شرعي على مؤسسات الدولة السلطوية العلمانية.
مرة أخرى، لا نطالب البشري بتبني رؤية نقاده وخصومه حول مضمون وحدود الحريات الديمقراطية، ولكن ما يعنينا هنا هو توضيح استحالة الحلول النهائية للتناقضات بشأن هذا المضمون وهذه الحدود، وأن أي حلول لهذه التناقضات لن تكون إلا مرحلية ومنحازة ومستخدمة لآليات الدولة السلطوية طالما ظلت الدولة والمجتمع رأسماليين. والمثقف سيجد نفسه طرفًا في هذه الانحيازات شاء أم أبى، ووعى ذلك أم لم يعيه.
في محك الثورة:
مع العواصف الثورية في ٢٠١١، تجلت تناقضات رؤية البشري لمضمون واستراتيجيات المشروع الوطني الديمقراطي وتكثفت أكثر فأكثر. فالبشري عاد للتعليق السياسي المتواتر مع غزو العراق في ٢٠٠٣ وتصاعد مطالب التغيير الديمقراطي في صفوف النخبة السياسية المصرية بمعسكراتها المختلفة لتلافي مصير العراق الكئيب. وفي ٢٠٠٤، أطلق البشري رؤية للتغيير في مقاله ذائع الصيت “أدعوكم إلى العصيان”،[42] ثم فصّلها في عدد من المقالات جُمعت في كتاب ذي عنوان لافت وهو “مصر بين العصيان والتفكك”.[43] وهذه الرؤية تحولت عمليًا لما يشبه إعلان المبادئ التوجيهي لحركة كفاية، وهي التجمع الذي صاغ خيال وأفق كافة الجماعات المنخرطة في التعبئة ضد مشروع توريث السلطة لجمال مبارك.[44] و“كفاية”، كما هو معلوم، هي تجمع لمثقفين قوميين ويساريين، وبعض المثقفين الإسلاميين من دائرة البشري القريبة نفسها. المقالات تُسقط بوضوح رؤية البشري لمسار الحركة الوطنية المصرية ومعضلاته على السنوات الأخيرة من حكم مبارك، حيث رأت في سعيه لتوريث السلطة لولده قمة شخصنة السلطة العامة والتي تحول الدولة المفترض بها الرشادة والانضباط والتمثيل إلى مجرد مُلك خاص. مشروع التوريث لدى البشري ليس مشروعًا سياسيًا يعبر عن قوى اجتماعية بعينها، بقدر ما كان انحرافًا عن الإجماع الوطني، واستنساخًا لمشاريع تاريخية سابقة بلغت فيها الشخصنة والتبعية للغرب أوجها. ويتطلب هذا الموقف الدقيق، من وجهة نظره، عملًا وطنيًا شاملًا جبهوي الطابع يضم أطرافًا من خارج وداخل جهاز الدولة لإنقاذ هذه الدولة نفسها وإعادة جسر الفجوة بينها وبين الجماعة الوطنية. واختتم البشري مقاله بدعوة مبطنة - وفقًا لما سمحت به اعتبارات النشر - للقوات المسلحة للتدخل وحسم الأمر لمصلحة الرؤية الوطنية الشاملة أخذًا في الاعتبار أن الجيش ما زال أحد المؤسسات القليلة التي تحتفظ بميراث الدولة الوطني الحديث دون تلوث بأدران السوق أو الشخصنة. [45]
ولكن كرؤيته التصالحية في التسعينيات، كانت مشكلة هذه الرؤية - بعيدًا عن دقة حكمها على موقع الجيش أو على طبيعة مشروع التوريث الذي عزله البشري عن أي أصول اجتماعية - أنها لا يمكن أن تنتج ممارسة سياسية من الأصل بقدر ما تنتج ممارسة دعائية تعتمد في تحقيق أهدافها على تعاون قوتين لا يشاطران تلك الرؤية التصالحية الكثير من الود، وهما الجيش والإسلاميين. و هذا تحديدًا هو ما حدث خلال ٢٠١١ عندما أفضت ست سنوات من الدعاية، والتعبئة الجبهوية/اللاحزبية، إلى تهيئة المسرح للقوتين الرئيسيتين لتحديد مسار المرحلة الانتقالية. وعندما انقشع غبار الانتفاضة عن توازن القوى هذا، شرع البشري، خلال رئاسته للجنة المشرفة على تعديل دستور ١٩٧١، بتصميم مسار للانتقال السياسي يعتمد على التعاون الحصري بين الطرفين، دون مشاركة من أي قوة سياسية أو اجتماعية أخرى. وبالطبع، كان تعاون القوتين الإقصائيتين في ظل غياب أي عنصر خارجي وازن محكومًا عليه بالفشل المبكر وصولًا إلى تراجيديا ترشيح مرسي للرئاسة ثم تنحيته بعد عام واحد علي يد أقرب معاونيه من الجيش.
استمر البشري في الدفاع عن مساره باعتباره المسار الوحيد الممكن، وأخذ على كل نقاده من المعسكر غير الإسلامي تخوفهم من الاستحقاقات الديمقراطية، وهو التخوف الذي ألقى بهم لأحضان الجيش من وجهة نظره. ولكن فات البشري أن نقاده كانوا هم تاريخيًا الأكثر إخلاصًا لرؤيته للتغيير، وأنهم لم يفعلوا شيئًا أكثر من تبنيها بحذافيرها تقريبًا بشكل واع أو لا واع، فانتهى بهم الحال أسرى مناورات الإخوان والجيش. فما الذي فعلته “كفاية” إلا الدعوة الدائمة للعصيان السياسي متمثلًا في مقاطعة انتخابات ٢٠٠٥، وتطوير الفعاليات المعارضة باتجاه التظاهر في الشارع، والانفتاح على دعوة الجيش للتدخل لوقف مشروع التوريث؟! وما الذي قدمته كفاية على صعيد المضمون يخالف رؤية البشري الجبهوية التصالحية؟! بل إن حركة كفاية، وغيرها من الكيانات التي استنسخت أساليبها، تعرضت لنقد لاذع من عدد من الأصوات الليبرالية واليسارية نتيجة تنازلاتها الخطابية للتيار الإسلامي، وعدم فتحها أي ملف حساس يثير تخوف قطاعات واسعة في المجتمع، كالأقباط مثلًا، انتظارًا لرحيل مبارك. وبالمثل، ما الذي فعله محمد البرادعي تحديدًا - بوصفه النقيض الموضوعي لرؤية الجيش والإخوان خلال هذه الفترة - في عام ٢٠١٠ إلا تبني رؤية البشري، بشكل لا واع كذلك، بالتوجه القصدي للإخوان بوصفهم القوة الشعبية الأساسية، وتقديم مشروعه كجبهة وطنية ديمقراطية عريضة تتعالى على التحزب وتنفتح للجميع؟ بل إن البرادعي كان الأقرب حتى على مستوى الأفعال الرمزية لمخيال البشري، كما في حالة جمعه لتوكيلات شعبية على بيانه للتغيير أسوة بالفعل الذي أطلق ثورة ١٩١٩. في الحقيقة، فزع هذه القوى من تقارب الجيش والإخوان، واعتباره خيانة لفكرة الجبهة الوطنية الجامعة، كان نتاج رؤية تبناها البشري ودافع عنها وشكلت أفقه وأفق نقاده على حد سواء. ولكن بينما تفتحت عيون نقاده على الواقع سريعًا في خضم السيرورة الثورية، وأدركوا موازين القوى- وهو الإدراك الذي قاد الكثير منهم لمواقف مخزية في النهاية - ظل البشري أسيرًا لمفاهيمه وتصوراته المثالية عن قدرة الفكرة الوطنية الديمقراطية على فرض نفسها على الجميع بحكم قوتها وتماسكها المنطقي وحده.
وهكذا فشل البشري في نيل رضا الإسلاميين من رافعي راية التراث، وسقطوا بالنسبة إليه، بوصفهم مجرد جماعات دعوية قابلة للتلاعب بها، وفشل في نيل رضا القوى “المدنية”، وسقطوا بالنسبة إليه، بوصفهم مرتعبين من الديمقراطية ومن الشعب بالمجمل، وأصبح على الواقع أن يرتفع لمستوى رؤية المفكر وأن يتولى هو بنفسه حل تناقضاتها.
البشري في مرآة خلفائه ومجايليه:
النقد السابق لا ينفي أن عمل البشري يظل علامة متفردة في تاريخ التنظير السياسي والقانوني المصري الحديث، من حيث موقفه الصارم ضد الرؤي الخلاصية/العدمية يمينًا ويسارًا، والتي بلورت نفسها عبر نفي مراحل تاريخية كاملة من التاريخ المصري، فلا هي أنتجت فهمًا للتاريخ، ولا أنتجت أفكارًا أو مشاريع سياسية قابلة للحياة والتطوير. وللأسف، تنتعش مرة أخرى نفس الأفكار في صفوف المثقفين الإسلاميين تحديدًا تحت وطأة خبرة فشل الثورة المصرية والانقلاب على التجربة الانتخابية قصيرة العمر.
من جهة أولى، تتراجع مجموعات من المثقفين الإسلاميين إلي مربع الأفكار القطبية المألوف على اعتبار أن الدولة العلمانية، ونخبها السياسية والثقافية، قد كشفت عن وجهها السلطوي الحقيقي عند أول محك ديمقراطي، وأن الدولة والمجتمع الإسلاميين، والحال كذلك، لا يمكن أن يتجسدا إلا عن طريق المفاصلة الفكرية والشعورية الصارمة مع تاريخ الدولة والمجتمع الحديث في مصر. وتطرح تلك المجموعات استئناف النضال بنفس أساليب الحركة الإسلامية السياسية المعروفة منذ السبعينيات، أي بناء المنظمات السياسية العقائدية، سواء كانت سلمية أومسلحة، والتي تدرب وتنظم وتوجه منتسبيها لمشارب العمل الجماهيري في ضوء تقييمها المركزي للواقع.[46] خلاف هذه الأصوات مثلًا مع الإخوان المسلمين - وهو خلاف عميق ولا نقلل من شأنه - يتمحور حول سذاجة القراءة الإخوانية للحظة السياسية فيما بعد ٢٠١١، أو حول مدى إخلاص قيادة التنظيم للإطار العقائدي الإسلامي، ولكنه لا يمتد لمنطلقات الجماعة الفكرية نفسها.
في المقابل، تتجه أصوات من المثقفين الإسلاميين المستقلين، كالدكتورة هبة رؤوف عزت مثلًا أو المهندس أيمن عبد الرحيم، إلى قراءة تجربة فشل الديمقراطية المصرية، ومأساة الإسلاميين المعاصرة، كَعَرضٍ لمشكلة أعمق وهي استبطان الإسلاميين لمنطق الدولة الحديثة، وتقسيم العمل الرأسمالي، في عقائدهم وبرامجهم واستراتيجياتهم وبناء منظماتهم الداخلي. وهذا الاستبطان هو ما حكم على الحركة الإسلامية أن تواجه النخب الحاكمة في ملعبها، إن جاز التعبير، فكان محكومًا على سعيها بالفشل- إذ لا يمكن لأي منظمة مركزية مهما بلغت درجة تماسكها التنظيمي أن تفوق أجهزة القمع النظامية انضباطًا في بلد كمصر، ولا يمكن لأي برنامج سياسي، مهما بلغت درجة إبداعه، إلا أن يرتهن تنفيذه بتعاون النخب الحاكمة، أو الوصول للسلطة بالآليات المتعارف عليها في الدولة الحديثة وما تتسم به من شعبوية وتسطيح.[47]
بعبارة أخرى، تنطلق هذه الأصوات من أطروحة البشري العميقة بأن مطالبة الحركة الإسلامية لدولة سلطوية بتطبيق الشريعة لن تعني إلا إلباس هذه السلطوية لبوسًا شرعيًا. ولكن بدلًا من إدراك التباسات فكرة البشري، التي حاولنا توضيحها، ومد الخط على استقامته باتجاه تطوير إطار مفاهيمي وبدائل سياسية من داخل نفس أشكال التنظيم الاجتماعي القائمة، وما تفترضه من هويات ذاتية وجمعية، ترتد هذه الأصوات للخلف خطوتين عن رؤية البشري محاولةً إبداع مفاهيمها عبر استقراء تاريخ المسلمين السابق على الحداثة الرأسمالية، واعتبار هذا التاريخ كفيلًا بمدّ المثقف الإسلامي المعاصر بعدته المفاهيمية. يتحول مثلًا التنظيم الذاتي للجماعات البعيدة عن مراكز السلطة من عائلات ممتدة، والناتج عن عجز السلطة المركزية في هذا الوقت، إلى أرضية صالحة لبناء مفهوم شبكي ولامركزي للتنظيم الاجتماعي، أما مؤسسة الوقف مثلًا فتتحول إلى بديل لمفهوم العمل الخيري أو الإنساني المعاصر الذي لا ينتج مؤسسات قادرة على مواجهة الفقر من جذوره، والطوائف الحرفية تظهر كأرضية صالحة لتأسيس نموذج “تعاضدي” بين غالبية المسلمين يتجاوز النقابات في اعتمادها الحصري على التفاوض مع الدولة أو أصحاب الأعمال نتيجة افتقارها للاستقلال التمويلي، وهكذا. وهذا كله يقتضي بالطبع تنظيمًا مختلفًا لحركة الإسلاميين يقطع مع المركزية والهرمية المفرطة التي حكمت حركتهم خلال أربعة عقود.
وتدعم هذه المقاربات أطروحاتها بالاستناد لأدبيات الأنطولوجيا السياسية، أو التحليل المفاهيمي التأويلي، كما لدى هايدجر أو جادامر أو شميت - على ما بينهم من خلافات عميقة في المنطلقات والنتائج - وتصوراتهم عن الدولة الحديثة، أو الحداثة بالمجمل. فيخرج القارئ لهذه الأعمال الإسلامية الجديدة بانطباع أن الخصومة بين الدولة الحديثة والفاعلية الإنسانية غير قابلة للحل تقريبًا. فطالما وجدت السلطة مركزة في الدولة، وطالما تمر عملية إنتاج الحياة عبر دائرة رأس المال، فلا أمل في الحرية أو الانعتاق الحقيقي. وبالتالي يعاد بناء الإسلام هنا كتقليد هدفه النهائي تعظيم الفاعلية الإنسانية كخليفة لله على الأرض، ومن ثم فخصومته بدوره مع الحداثة غير قابلة للحل.
هنا، للأمانة، يقف البشري في موقع متقدم بكثيرعلى من يسعى لتجاوزه من قطبيين جدد أو إسلاميين متأثرين بنقاد الحداثة الأوروبيين. فالرجل بالرغم من تحولاته، وكما حاولنا أن نوضح، كان واعيًا بعمق، أن أي تشكيل اجتماعي، خصوصًا التشكيل الاجتماعي الرأسمالي، يحمل بذور تحولاته المستقبلية في داخله، وأن تجاوزه مرهون بإدراك الفكر لمكامن التناقض في هذا التشكيل، واستناده عليها، لتطوير مفاهيمه وأطروحاته.
ولهذا ظل البشري متمسكًا بمركزية أبنية الدولة الحديثة في مشروعه باعتبارها هي نفسها الحاضنة التي سيتطور عبر تناقضاتها مشروع الدولة الوطنية الديمقراطية الأصيلة. وهذا الإدراك هو أقوى العناصر التي احتفظ بها البشري من الإطار النظري الماركسي الذي اقترب منه في مرحلته اليسارية الوطنية.
ما بعد البشري….خاتمة:
يمكن الآن أن نلخص أطروحاتنا بالعودة من حيث بدأنا، أي ضرورة تجاوز حديث التحولات، والنقلات الدرامية، عند مقاربة فكر طارق البشري.
فمن خلال تتبعنا لإنتاجه الغزير الممتد حاولنا أن نوضح أن الانتقال من موقع اليسار الوطني إلى الموقع الوطني المحافظ قد جرى بسلاسة ومنطقية: الحديث عن وحدة الشعب العامل قاد إلى الحديث عن الوحدة العضوية للجماعة الوطنية، والحديث عن الإشتراكية العربية الأصيلة النابعة من خبرة المصريين الوطنية قاد إلى الحديث عن الشريعة التي تمثل بناءً تاريخيًا رمزيًا يجسد بحد ذاته وحدة هذه الجماعة، والحديث عن الثقافة الوطنية كدعامة لتعزيز الاستقلال القانوني والسياسي قاد إلى الحديث عن التاريخ الإسلامي بمجمله كمحدد معرف لهذه الثقافة.
فما الذي يربط هذه المحطات جميعًا ويجعل التنقل بينها على هذا القدر من المنطقية والسلاسة؟ إنه ببساطة وحدة السؤال الذي لم يتغير، ووحدة الموقع الذي قارب منه البشري هذا السؤال. فإذا كان المثقف يسعى للبحث عن أرضية إجماع لعموم المصريين، ووجهة، أو غاية نهائية، لمسار تاريخهم المتعرج، ويقدم إجاباته على هدى من ضميره الوطني والمهني المجرد وفقط كذات متعالية على التحزبات السياسية والاجتماعية، فعلى الأرجح ستتراوح إجاباته جيئة وذهابًا على هذا المتصل الذي سار عليه البشري.
وبالمناسبة، لا يعدم تاريخنا الثقافي تحولات أقل شهرة في الاتجاه العكسي - أي من الموقع الإسلامي إلى الموقع اليساري الوطني - قادها كذلك البحث عن الإجماع والغاية النهائية.
والمفارقة الطريفة هنا أن رؤية البشري كانت زاد هذه التحولات العكسية في الحقيقة - كما تؤشر حالة عدد من رموز حزب الوسط مثلًا في نهاية التسعينيات، وعدد من الخارجين على جماعة الإخوان عقب ثورة يناير - إذ قدمت رؤيته قراءة أرحب نسبيًا لتاريخ الدولة والمجتمع الحديثين في مصر بخلاف مقاربات الإخوان المنغلقة والحدّية لهذا التاريخ، كما قدمت بالطبع أساسًا للانفتاح على رؤى القوى السياسية والجماعات الفكرية الأخرى لهذا التاريخ.
وعلى هذا المتصل المشغول بالإجماع، والغاية النهائية، تبلورت أطروحات البشري المحافظة عن تاريخ المشروع الوطني المصري، واستراتيجياته، ومضمون الحريات الديمقراطية المطلوبة لتعزيزه وإكسابه شرعيته: فهي محافظة في رؤيتها التاريخية من حيث حبس تعقيد التطور التاريخي في ثنائيات “الوافد” و “الموروث”، أو الوطني والتابع، دون أن تقدم تحليلًا معمقًا للجذور الاجتماعية لهذه اللافتات، وهي محافظة في رؤيتها الاستراتيجية من حيث إصرارها على الإجماع والعمل الجبهوي و لو على حساب وضوح البرنامج وبغض النظر عن طبيعة موازين القوى القائمة، وهي محافظة من حيث حرصها على حفظ تماسك الدولة كضمانة لأي منجز وطني وديمقراطي تحقق سابقًا، وهي محافظة كذلك في رؤيتها لمضمون الحريات الديمقراطية من حيث حصرها في الحريات السياسية، وتمسكها برقابة مؤسسية على عملية التجديد القانوني والفقهي التي قد تقدم إسنادًا شرعيًا لهذه الحريات.
ومن هنا غزت التناقضات فكر البشري. فالسعي لإنتاج فكر يسهم في دعم الوحدة العضوية بين الفرد والجماعة وبين الجماعة والدولة، انتهى لإنتاج فكر مهجوس بالإجماع والثوابت، ولا يمكن أن يتجسد إلا كمشروع مصطنع للهيمنة عبر آليات الدولة السلطوية نفسها. ولأن الاستقلال النسبي المؤقت للدولة عن الطبقات، واحتكارها لمجال الإنتاج الثقافي مع بداية الستينيات، كان هو شرط الإمكان الاجتماعي لتدعيم موقع المثقف الوطني المستقل عن الطبقات والسياسة بالمجمل، فكان من الطبيعي أن ينتهي التعبير الأمثل والأكثر اكتمالًا عن هذا المثقف، متمثلًا في شخص البشري، لاستدعاء الدولة حتى وهو ينعي تغولها ويسعى لتمكين المجتمع الشعبي في مواجهتها. ومن نافل القول أن البشري لا يقف وحيدًا في تناقضاته تلك بقدر ما يعبر عن قطاع عريض للغاية من المثقفين المصريين، والمنتمين منهم للجماعة القانونية على وجه التحديد.
الدرس الجليّ إذن من التتبع النقدي لمسار البشري الفكري، هو أن العمل على إبداع مشروع وطني ديمقراطي جديد يستجيب لشروط الواقع، ولا يعلق في مرحلة التحرر الوطني وإشكالياتها، لن يكون إلا بتجاوز الموقع الفكري الذي ينتج التعلق بالدولة السلطوية بشكل دائم، أي موقع المثقف الوطني المستقل نفسه. وهذا التجاوز هو مسألة أعقد من مجرد تبديل الإطار المرجعي ما بين هذه النظرية أو تلك. فكما رأينا في حالة المجموعات الإسلامية التي سعت للانطلاق من أرضية البشري باتجاه رؤية جذرية للقطيعة مع الدولة عبر تطعيم فكر الرجل بحزمة مفاهيمية ما بعد حداثية، أو ناقدة للحداثة، رأينا أنها لم تذهب بعيدًا في الواقع، بل تراجعت عن مشروع البشري الثري بخطوات.
الموقع البديل، والذي يغيب حتى الآن عن المشهد، والكفيل بالفعل بإنجاز تلك المهمة، هو موقع المثقف المُنظم المنحاز لا المفكر المستقل - مثقف صاحب مساهمات محلية ولحظية، ويمتلك من الوعي، والشجاعة، ما يدفعه للاعتراف بمحدودية مساهماته وطابعها المؤقت وحقيقتها كلحظة من لحظات تراكم وعي تاريخي لقوى اجتماعية متصارعة لا يستطيع أن يخطط لمساره سلفًا.
أما السير على خطى البشري والإصرار على التشبث بموقع خيالي لمثقف مستقل “ينطق بالحقيقة في مواجهة القوة” فلن ينتج إلا مثقفًا تصبح رؤاه عرضه للتلاعب والتوظيف من قبل من يمتلك هذه القوة، وهم في بلدنا إمّا نخب سلطوية قابضة على سلطة الدولة، أو إسلاميون سلطويون في مقاعد المعارضة.
الهـوامـش
[1] يستخدم الفيلسوف الماركسي الإيطالي أنطونيو جرامشي لفظ “عضوي” Organic لوصف أي موقع اجتماعي يتطور من رحم علاقة اجتماعية بشكل تلقائي وبدون خطة مسبقة، أو تأمل نظري في ضرورة هذا الموقع. وهو يستخدمه في وصف فئة كبرى من المثقفين ظهرت بشكل سريع مع التطور الرأسمالي لتلبية احتياجاته كالإداريين والفنيين والاقتصاديين، ومديرين جهاز الدولة القانوني والإداري في مرحلة لاحقة. أنظر Antonio Gramsci, Selection from the Prison Notebooks, edited and translated by Quentin Hoare and Geoffrey Nowell Smith, London Lawrence & Wishart 1971, Pp 132
[2]ميثاق العمل الوطني، الصفحات ٣، ١٧، ٣٢ على الترتيب. متاح على موقع مجلة الوعي العربي على الرابط التالي
https://elw3yalarabi.org/elw3y/2018/03/13/%d9%85%d9%8a%d8%a%d8%a7%d9%82-...
[3] تحفل الفترة منذ نهاية الثلاثينيات وحتى قيام ثورة يوليو بأمثلة لعدد من المثقفين الذين إما انشقوا عن أحزابهم السابقة وطرحوا نفسهم على الرأي العام وأجهزة الإدارة كمستقلين، أو أنهم بدأوا إنتاجهم النظري كمستقلين بعيدًا عن العباءة الحزبية، وكان يشار إليهم عادةً في التغطيات الصحفية بوصفهم “مصلحين اجتماعيين”. وبعض هؤلاء، تحديدًا في الحقل الاقتصادي والقانوني، تبوأوا مناصب وزارية وإدارية رفيعة في حكومات تشكلت في ظروف متباينة واتبعت سياسات مختلفة. والرابط بين عملهم جميعًا كان في السعي لفصل سياسات الإدارة عن تقلبات المجال السياسي العاصفة وقتها وأهواء الحزبية. وبعضهم استشرف بوضوح التطورات اللاحقة التي ستنجز هذا الفصل الكامل قبل الانقضاض على الحياة الحزبية والسياسية بالمجمل. من ضمن هؤلاء تبرز أسماء كميريت غالي، المفكر متعدد الاهتمامات، والذي ركز في عدد من كتاباته على “الأداة الحكومية” ودورها الضروري في إنجاز تنمية اجتماعية شاملة، وكتب عدد من الدراسات والتقارير التي تدعم وجهة نظره، وكان دائم الهجوم على الحياة الحزبية من زاوية إهدارها للاستقرار والحياد المطلوب في أعمال الإدارة. وهو قد تولى حقائب وزارية في حكومتي أقلية عشية ثورة يوليو مع علي ماهر ونجيب الهلالي. وكذلك هناك مثال الدكتور أحمد حسين، الذي دافع بضراوة عن ضرورة الإصلاح الزراعي من وجهة نظر رأسمالية بوصفه إجراء ضروري لتحرير رأس المال المحبوس في الملكيات العقارية الكبيرة. وهو قد استقال من حكومة النحاس الأخيرة التي شغل فيها منصب وزير الشئون الاجتماعية نتيجة التسويف في تطبيق مقترحه. وكذلك هناك إبراهيم بيومي مدكور والذي ركز عمله كذلك على ضرورة إصلاح الأداة الحكومية خلال عضويته في البرلمان كمستقل. كما أن هناك مثال الدكتور محمود محمد محمود، ابن السياسي الشهير ورئيس الوزراء الأسبق محمد محمود، والذي كان مستقلًا عن الأحزاب وشغل عدّة مناصب قضائية حتى ترأس ديوان المحاسبة - الذي تحول تاليًا إلى الجهاز المركزي للمحاسبات - قبل أن يستقيل عام ١٩٥٠ نتيجة ما رآه تلاعبًا ماليًا في صفقات الأسلحة عام ١٩٤٨. وفي الحقل القانوني يبرز اسم محمد كامل مرسي، الفقيه المعروف، والذي تقلد منصب وزارة العدل في حكومة اسماعيل صدقي القمعية عام ١٩٤٦ من أجل الدفع بمشروع تأسيس مجلس الدولة والذي تولى رئاسته بمجرد إنشاءه. بل إن عبد الرزاق السنهوري نفسه، بالرغم من اقترابه من السعديين، إلا أنه طوّر موقفًا ناقدًا للحزبية بشكل عام وصولًا إلى تعاونه المشهور مع قادة يوليو ١٩٥٢ في تصفية الحياة السياسية خلال رئاسته لمجلس الدولة قبل الصدام مع الضباط.
[4] يستخدم جرامشي التعبير الإيطالي dirigente لوصف هذه الفئة من المثقفين، والتعبير يحمل معاني القيادة والتوجيه والتنظيم معًا. كما يستخدمه مثلًا لوصف الطبقة القائدة أو المهيمنة أو الحاكمة في مواضع مختلفة من كراسات السجن. أنظر Antonio Gramsci, Selection from the Prison Notebooks…. Opcit Pp 142
[5] يمكن الاطلاع على التعبير الفكري الأوضح عن رؤى يمين النظام في “تقرير لجنة الميثاق” والذي صدر كملحق، أو تعليق مستفيض، على الميثاق بهدف شرح منطلقاته. ومن الجليّ أن إصدار هذا التعليق كان بمثابة مساومة ضرورية مع الاتجاهات اليمينية داخل مؤسسات الحكم التي انزعجت من الميل اليساري الواضح في لغة الميثاق. وبالتالي، تجاوز تقرير اللجنة مهمة الشرح بكثير، وقدّم قراءته الخاصة التي ركزت على تمايز الاشتراكية العربية عن الاشتراكيات الأخرى “المستوردة” من حيث عدم إيمانها بحتمية الصراع الطبقي، وحمايتها للملكية الخاصة على قدم المساواة مع الملكية العامة، بل والدعوة لقواعد عادلة للمنافسة بين القطاع العام والخاص. وبالطبع، أسس “تقرير اللجنة” لرؤيته بالإحالة الكثيفة لنصوص الوحي على اعتبار أن الإيمان بالرسالات السماوية هو بدوره أحد أوجه تمايز الاشتراكية العربية. ووصل الأمر إلى اعتبار أن الإجراءات الاشتراكية جميعها هي مرحلة انتقالية حتى تصبح “القيم الروحية الخالدة [للإسلام] أساسًا لقيم المجتمع الجديد، ولكي تكون الشريعة الغراء مصدرًا أساسيًا للتقنين”. تقرير الميثاق، وزارة التربية والتعليم، القاهرة، ١٩٦٥، ص١٦.
ومن أجل تحليل شامل للتقرير، يمكن الرجوع إلى شريف يونس، نداء الشعب: تاريخ نقدي للأيديولوجية الناصرية، القاهرة، دار الشروق، ٢٠١٢، خصوصًا الفصل السادس.
[6] نوقش الجدل بين اليمين واليسار ورؤاهما المختلفة لطبيعة الثقافة الوطنية الجديدة في العديد من الكتابات خلال هذه الفترة. طبعًا يقفز للذهن كتاب محمود أمين العالم وعبد العظيم أنيس المفتاحي “معارك في الثقافة المصرية” إلى جانب كتابات هيكل عن أزمة المثقفين في حلقات متعددة بالأهرام خلال العام ١٩٦١، والتي اعتبرت في هذا الوقت وجهة النظر الرسمية لقمة النظام الناصري في المسألة. يقدم الناقد والمفكر غالي شكري استعراضًا ممتعًا لمواقع وأطروحات كلا التيارين في هذا الوقت في كتابيه عن “أسرار الثقافة المصرية” و “الثورة المضادة في مصر”. كما يستفيض المؤرخ شريف يونس في شرح السياق العام لتشكل يمين ويسار النظام الناصري.
أنظر، غالي شكري، من الأرشيف السري للثقافة المصرية، بيروت، دار الطليعة، ١٩٧٥
غالي شكري، الثورة المضادة في مصر، القاهرة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، ٢٠١١
شريف يونس، نداء الشعب: تاريخ نقدي… مرجع سبق ذكره
[7] بدأ أنور عبد الملك في استخدام المفهوم على نطاق واسع قبل صدور ميثاق العمل الوطني، وتحديدًا في عدد من مقالاته المنشورة في الصحف المصرية عقب العدوان الثلاثي في ١٩٥٦. وقد جمع عبد الملك هذه المقالات في كتاب واحد صدر عام ١٩٦٧. أنظر، أنور عبد الملك، دراسات في الثقافة الوطنية، بيروت، دار الطليعة، ١٩٦٧.
[8] آنجيلا جيورداني، المستشار طارق البشري ورحلته الفكرية: في مسار الانتقال من الناصرية للإسلام السياسي، مراصد العدد الخامس، مكتبة الأسكندرية ٢٠١١
[9] طارق البشري، في مفهوم الملكية الخاصة، الطليعة، أكتوبر ١٩٦٦
[10] تحفل مقالات البشري خلال هذه الفترة بإشارات متفرقة تدل على هذا الفهم. ولكنه يعود في مقال مرجعي لتلخيص آرائه في فقرات شديدة التكثيف والتعبير عن وجهة نظره. ففي مقاله “ثورة ٢٣ يوليو وتطوير الحركة الوطنيةالمصرية” المنشور في ١٩٧٧ يقول “يبدو لي، وقد لا أكون مبالغًا في الشطط، أنه إذا أريد تقطير فكر عبد الناصر وممارساته السياسية لتجمعها كلها عبارة واحدة لكانت تلك العبارة “في البدء كان الوطن”. وقد لا يتسع المجال للتفصيل في هذه الفقرة، على أنه يمكن الإشارة إجمالًا إلى أن ما كان يعتبر هدفا الحركة الوطنية المصرية خلال النصف الأول من القرن العشرين، وهما الجلاء والسودان، قد صار إنجازهما مقدمة وتمهيد لكفاح التحرر الوطني بعد ذلك. وثورة ٢٣ يوليو من ثورات التحرر الوطني ولكنها دفعت قضية التحرر الوطني إلى التشابك والتداخل مع قضايا التحرر الاجتماعي. عقب الحرب العالمية الثانية، ظهرت اتجاهات سياسية جديدة في الحركة الوطنية وذاع من خلالها مضمون جديد لحركة التحرر المصرية يربط بينها وبين حركات التحرر في العالم باعتبار ارتباط المصالح الاستعمارية في العالم وتجانس كفاح الشعوب ضدها ويربط بين الاستعمار والقوى الاجتماعية السياسية المحلية ويربط بين جلاء الاحتلال وبين مصالحه الاقتصادية وضرب الملكية الزراعية الكبيرة والشرائح العليا من الرأسمالية المتعاونة مع الاستعمار. وأتت ثورة يوليو لتغني بممارساتها هذا الاتجاه وليتحول على يديها من محض فكر سياسي ودعوة سياسية إلى تجربة سياسية في صميم الخبرة التاريخية للشعب المصري”. ثم يضيف في تكثيف كاشف “وقد بلور ميثاق ١٩٦٢ تلك التجربة بوضوح عندما ربط بين الاستعمار وبين الطبقات التي تتصل مصالحها به وأن مكافحة الاستعمار تستدعي عزل هذه الطبقات وأنه يتخفى في قصور الرجعية المحلية بما يستوجب ضربهما معًا وهزيمتهما معًا”. طارق البشري، ثورة ٢٣ يوليو وتطوير الحركة الوطنية المصرية، في “دراسات في الديمقراطية المصرية”، القاهرة، دار الشروق، ١٩٨٧، صفحات ١٣٧، ١٣٨، ١٣٩.
[11] يمكن الرجوع للتعرف على أهم الاتجاهات الماركسية في تقييم التجربة الناصرية خلال هذه الفترة إلى كتابات المفكر والناقد إبراهيم فتحي التي نشرت تحت أسماء مستعارة، وأعاد جمعها سعيد العليمي حديثًا. سعيد العليمي، الوثائق التأسيسية لحزب العمال الشيوعي المصري - الجزء الأول، القاهرة دار المرايا، ٢٠٢٠. كما يمكن الرجوع كذلك لكتابات ميشيل كامل (ط.ث.شاكر). ط. ث. شاكر، قضايا التحرر الوطني والثورة الاشتراكية، دار الفارابي، ١٩٧٢
[12] طارق البشري، الحركة السياسية في مصر (١٩٤٥- ١٩٥٣)، القاهرة، دار الشروق، ٢٠٠٢
[13] التعبير الكامل عن رؤية البشري للتجربة الناصرية نجده بالطبع في كتابه عن “الديمقراطية ونظام ٢٣ يوليو”. طارق البشري، الديمقراطية ونظام ٢٣ يوليو (١٩٥٢- ١٩٧٠)، بيروت، مؤسسة الأبحاث العربية، ١٩٨٧
[14] يشرح البشري وجهة نظره عن اغتراب جهاز الدولة والقانون الحديث عن حياة المصريين وتحوله لأداة سلطوية بالأساس في الفصل الأول من كتابه عن “الوضع القانوني المعاصر بين الشريعة والقانون الوضعي”. يقول في هذا الصدد “صار القانون خارجيًا، تجريه سلطة وحيدة في مواجهة أفراد، واغتربت السلطة عن الجمهور فلم يعد قانونها نظامًا وأحكامًا ومعيشة يتحاكم الناس بها بين بعضهم وبعض من خلال علاقاتهم المباشرة وروابطهم الإنسانية الحية، وبواسطة الكيانات الجمعية التي تضمهم بالشعور بالانتماء وبالترابط الإنساني، بحيث لا يكون على السلطة المركزية إلا أن تقوم بدور ضبط الإيقاع. وصارت علاقة الفرد بالفرد تتشكل عبر أحكام مفروضة عليهما من خارجهما، وموكل مراقبة تنفيذها لأجهزة مضروبة عليهم من عل، لا يتعايشون معها بالإدراك الجمعي. إنه لا يكفي أن يسن القانون بطريقة ديمقراطية، أي بأسلوب جماعي أو نيابي، إنما يتعين أن يسري بين الناس وفيهم مسرى العلاقات الحية التي تقوم بينهم”. البشري، الوضع القانوني المعاصر بين الشريعة والقانون الوضعي، القاهرة، دار الشروق، ١٩٩٦، صفخة ٢٩
[15] طارق البشري، المسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية، القاهرة، دار الشروق ٢٠٠٤
[16] بخلاف التأصيل التاريخي لفكرته عن الوافد والموروث في مقدمة الطبعة الجديدة من “الحركة السياسية”، يعود البشري في أحد آخر أعماله ليعبر بشكل صافي ومكثف عن فهمه لهذه الثنائية، ولا تغيب طبعًا خبرة الصدام بين التيارات الإسلامية وما يعرف بالتيارات المدنية بعد ثورة يناير عن الخلفية. ففي مقدمة كتابه “جهاز الدولة وإدارة الحكم المعاصر في مصر”، عاد لهذه المسألة واتسمت رؤيته بقربها من مواقفه الأولى عن “الشعب الموحد” في مواجهة الأقلية الرأسمالية الاحتكارية، أكثر من مواقفه التي خلت من هذا التحديد الاجتماعي خلال التسعينيات وبداية الألفية. يقول: “يمكن القول أن ثمة هوة تفصل بين ثقافتين في المجتمع، أولاهما الثقافة العامة الموروثة والسائدة بين جماهير الشعب المصري في ريفه وحضره الشعبي وفي المستويات الاجتماعية غير الميسورة، وثانيتهما الثقافة الوافدة التي تنتشر بين النخب الاجتماعية المتيمزة اقتصاديًا وتعليميًا، ولأن هذه النخب تنتشر في مجالات السيطرة والنفوذ في شئون الاقتصاد والمؤسسات الاجتماعية، ونسبتها بين المهنيين أكبر بطبيعة الحال من ندرتها النسبية بين الطبقات الشعبية، فإن هذا الوجود الأغزر يوجد في أجهزة إدارة الدولة، ونضح هذا الوجود على الدولة وأجهزتها، وانعكس انعزالًا عن جماهير الشعب”. طارق البشري، جهاز الدولة وإدارة الحكم في مصر المعاصرة، القاهرة، دار نهضة مصر، ٢٠١٤. صفحة ١٢
[17] يعبر البشري عن فهمه للموروث، أو الثقافة الإسلامية، في نفس المرجع السابق بشكل مكثف كذلك، ويقول: “أنا هنا لا أتكلم عن الإسلام بوصفه العقدي ولا عن مدى الإيمان الديني، ولكنني أتكلم عنه بوصفه الثقافة العامة السائدة التي يتعين أن تكون أساس الاتصال بين أي داعية لأي سلوك أو فعل، كما أنه ينبغي أن يكون الخطاب باللغة السائدة، وأن أي خطاب بغير اللغة السائدة لن يكون وقعه لدى جمهور غير المستخدمين لهذه اللغة أكثر من الضجيج”. المرجع السابق، صفحة ١٦
[18] يخصص البشري الفصل الأول من “الوضع القانوني المعاصر بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي” بشكل شبه كامل لاستعراض جهود التجديد المتزامنة والمتتالية في القرن التاسع وبداية القرن العشرين حتى صدور التقنين المدني المصري في شكله النهائي بعد الحرب العالمية الثانية.
[19] طارق البشري، منهج النظر في دراسة القانون مقارنًا بالشريعة، منشور في “الوضع القانوني..” مرجع سبق ذكره، صفحة ١١٥
[20] يقول البشري في هذا الصدد: “الإثم الأعظم أننا فصلنا تنظيمنا عن عقيدتنا كأصل للشرعية ومعيار للاحتكام، وأخذنا من عقائد الآخرين أصل شريعتهم ومعايير احتكامهم. لم يكن المقصود إذا استبدال حكم فرعي في واقعة أو نازلة محل حكم آخر، إنما كان المقصود العدول عن أصول الشريعة الإسلامية إلي أصول شريعة وضعية غربية وافدة…. وبهذا يظهر أن حركة العودة للشريعة الإسلامية إنما تجد أساسها وحقيقة مقصودها في العودة للإطار المرجعي والمصدر التشريعي للأحكام الشرعية التي ولدها الفقه الإسلامي بأساليب الاجتهاد المعروفة، من الأصلين الثابتين للشريعة، وهما القرآن الكريم وسنة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام”. الوضع القانوني…، مرجع سبق ذكره، صفحة ١٢٣، ١٢٤
[21] يعرف البشري تقنية الإسناد الشرعي المقترحة بوصفها “ممارسة تجري لتغيير الأطر المرجعية، أي تعديل قواعد الاحتكام للنصوص والأحكام السارية الآن، ليصير مصدر الشرعية هو اتفاقها مع الشريعة. المطلوب هنا هو النظر فيما تسعه الشريعة الإسلامية من أحكام تقوم بها القوانين والتشريعات السارية والنافذة في المجتمع الآن، ورد هذه الأحكام إلى أطرها المرجعية من الشريعة الإسلامية وإسنادها إلى ما يمكن أن تستند إليه من مصادر التشريع الإسلامي وفقًا لما تفتق عنه اجتهاد الفقهاء المسلمين قديمًا وحديثًا. وهذه المسألة هي ما أحاول عرضه، أن يتجه رجال القانون والفقه والعاملون من المحامين والقضاة والشارحين والأساتذة المعلمين، أن يتجه كل هؤلاء إلى بيان الإسناد الشرعي لأحكام القوانين القائمة، في ضوء ما تطيق الشريعة الإسلامية وفقهها”. المرجع السابق، صفحة ١٢٥
[22] تطرق البشري لنقد أفكار سيد قطب ورؤيته عن الانقطاع في تاريخ المسلمين في أكثر من موضع. انظر مثلًا طارق البشري، سيد قطب بين فكر الحرب والسلام، منشور في “الملامح العامة للفكر السياسي الإسلامي في التاريخ المعاصر”، القاهرة، دار الشروق، ١٩٩٦، صفحة ٣١
[23] يقول البشري في هذا الصدد: “نحن نلحظ من متابعة وقائع حركة المطالبة بالعودة إلى الشريعة الإسلامية، أنه كلما توجهت هذه الحركة إلى الدولة كلما تعثرت وارتدت على آثارها وكلما توجهت إلى الجماعة سواء في خاصتها أو عامتها، كلما ازدهرت وزهت. وموقف “الدولة الحديثة” ليس مرجعه إلى أنها لم تؤمن بالتوجه إلى الشريعة الإسلامية بعد ولكن مرجعه إلى أنها بمركزيتها الطاغية وامتلاكها للمجتمع لا تستطيع إلا أن تمتلك مصدر الشرعية في المجتمع، فلا تكتفي بامتلاك سلطة التشريع، كما لا تستطيع إلا أن تكون لديها القدرة على صياغة القيم وامتلاك الأساس الذي تقوم عليه القيم”. المرجع السابق، صفحة ١٢١
[24] يقول البشري في تعريفه للتخلل: “المقصود هنا بالتوجه إلى الأمة بالمطالبة بعودة الشريعة الإسلامية، لا يبغي تحدي سلطة الدولة، ولا يصل إلى إيجاد قانون وتنظيم بديل على غير ما سنت الدولة، ولا يبلغ الخروج على قوانينها، وفي الوقت ذاته ليس المقصود فقط هو عموم الدعوة للشريعة الإسلامية وتزكية أطرها المرجعية ومعايير الاحتكام بها بين الناس، إنما المقصود هو منزلة بين المنزلتين…. المقصود ليس فقط الدعوة للمطالبة، إنما هي دعوة تفيد الحث على الممارسة”. المصدر السابق، صفحة، ١٢٤و ١٢٥
[25] تعرض البشري خلال كتاباته الغزيرة منذ بداية ثورة يناير بالنقد للتيار الإسلامي بشكل عام، وللإخوان على وجه الخصوص، عبر محطات كثيرة من المسار السياسي الذي أعقب تنحي مبارك. وفي أحد أواخر كتبه التي جمع فيها عددًا من مقالاته وحواراته الصحفية خلال تلك الفترة، أجمل نقده للتيار الإسلامي في المقدمة بقوله: “التيار الإسلامي بتنظيماته القادرة على الوصول إلى السلطة بالأسلوب الشعبي الديمقراطي، هو تيار وإن كان يرتكن إلي العقائد السائدة في المجتمع بأغلبية كاسحة، فإن كوادره التنظيمية هم من الدعاة…. أما رجال الدعوة فهم مستغرقون في أدائهم الدعوي لجذب المؤمنين بما يدعون إليه، وهم لا يعنيهم كثيرًا أمر من يخالفون من غير من يؤمنون بهم، لأنهم متفرغون لجذب المؤمنين بدعوتهم، ولذلك يهتمون بما يمكن أن نسميه “الفروق”بين الاتجاهات والتيارات، ولا يعنيهم ما يمكن أن نسميه “الموافقات” بين هذه الاتجاهات. كما أنهم اعتادوا أن يرسلوا بدعواتهم للآخرين لا أن يتلقوا منهم آرائهم وأفكارهم ومواقفهم إلا إن كان هذا التلقي في سبيل السعي لدحض حجج الآخرين والرد عليها، فهم يرسلون ولا يستقبلون ولا يتعاملون في الأساس أخذًا وإعطاءًا مع الآخرين. وهذا الأداء يختلف كثيرًا عما يتطلبه العمل السياسي، وبهذا الجانب الإرسالي وحده لا يمكن إدارة شئون الحكم أو الشئون السياسية بنجاح وفاعلية”. طارق البشري، ثورة ٢٥ يناير والصراع حول السلطة، القاهرة، دار البشير، صفحة ١٢،١٣
[26] لا يوجد مدخل سلس بالطبع للتعرف على أطروحات فيلسوف عملاق مثل هيجل. ولكن بشكل عام يمكن البدء بمحاضراته عن فلسفة التاريخ لتكوين فهم أولي عن فكرته عن كمون الحقيقة في صيرورة الواقع، ثم العودة لعمله المرجعي عن ظاهريات الروح من أجل فهم أدق وأكثر عمقًا لنفس الفكرة. والطبعات التالية تحديدًا تتضمن مقدمات وافية للمحررين تساعد في تبسيط المحتوى المركب.
Hegel G.W.F. Lectures on the Philosophy of World History, Translated by Hugh Barr Nisbet and Introduction by Duncan Forbes, Cambridge University Press, 1975
Hegel G.W.F, Phenomenology of Spirit, Translated by A. V. Millner with an Analysis of the Text and Forward by J. N. Findlay, Oxford University Press, 1977
[27] يعبر البشري عن منهجه هذا بصياغة شديدة الوضوح والتكثيف في كتابه “نحو تيار أساسي للأمة”، فيقول: “هذا المشروع الوطني لا تظهر عناصره أو مفرداته متكاملة من أول وهلة، ولا تبدو منسجمة ومتجانسة على الدوام، وقد يظهر نوع من التعارض بين تلك العناصر والمفردات وقد تتصارع جزئياته بعضها مع بعض، وقد تمسك كل جماعة سياسية بطرف تلك الجماعة الأخرى، فتبدو عناصر المشروع الواحد يضرب بعضها بعضًا، ولذلك فإن الحوار حول المشروع الوطني ذو أهمية ترتبط مباشرة بهذه الاحتمالات الواردة بشدة، لأن الحوار يمكّن من فرز المفردات والمطالب السياسية والثقافية والاجتماعية، ويوضح ذلك إسهامًا في المشروع العام، وما لا يعتبر كذلك…. المفردات المعنية هنا ليست نتاجًا لدعوة المفكرين، إنما دعوات تقوم عليها حركات وجماعات مختلفة، تثبت جديتها وحجمها بقدر ما تلقى من صدى وتجاوب من قوى المجتمع الثقافية والسياسية والاجتماعية… إن هذه الحصيلة المعقدة والضاربة في أعماق التاريخ والجغرافيا ليست كالتصميمات الهندسية وخرائط المسّاحين التي ينفصل إعدادها عن تنفيذها ويسبق الإعداد فيها التنفيذ، إنها على العكس من ذلك تتداخل مراحلها تكوينًا وبناء، تنظيرًا وتطبيقًا”. طارق البشري، نحو تيار أساسي للأمة، القاهرة، دار الشروق، ٢٠١١، صفحة ٣٢، ٣٣
[28] يحيل البشري في كتابه “الوضع القانوني” إلى الفقيه الإنجليزي دينيس لويد Dennis Lloyd (١٩١٥- ١٩٩٣) من أجل التأصيل لأطروحته عن ضرورة استناد القانون لأساس أخلاقي في ثقافة المجتمع، وعن ضرورة لعب القانون لدور في دعم هذا الأساس بالمقابل. ولويد معروف بتوجهه الوظيفي/الليبرالي، حيث يرى أن القانون قادر على لعب الدور الأساسي في مصالحة تناقضات المجتمعات، والمساهمة بالتبعية، في تطوره. ولويد عبر تأريخه، يجادل بأن القانون كان حاضرًا في مختلف الحضارات لممارسة هذه الوظيفة الحيوية، خصوصًا في الحضارة الرأسمالية الحديثة. كما يحيل البشري في أكثر من موضع من الكتاب المذكور للدكتور علي بدوي، وخصوصًا مقاله المرجعي عن “أصول الشرائع” والذي يغزل على نفس منوال لويد بشأن دور القانون الحديث وتاريخه.
طارق البشري، الوضع القانوني المعاصر… مرجع سبق ذكره، صفحة ٣١
علي بدوي، أبحاث في أصول الشرائع، مجلة القانون والاقتصاد، السنة ٥، العددان ١و٢، يناير ١٩٥٣
Dennis Lloyd, The Idea of Law, Baltimore, Penguin Books 1991
[29] يمكن استشفاف هذا الميل لإسقاط التاريخ الأوروبي على التاريخ المصري الحديث في عدد كبير من كتابات البشري. وعلى وجه الخصوص فكتابه “جهاز الدولة” سابق الإشارة إليه، يعبر بشكل واضح عن هذا الميل. فيقول البشري عند مقارنة تاريخ نشأة الدولة في السياق الأوروبي الغربي وفي بلدان العالم الإسلامي “كان ظهور أساليب الإدارة الحديثة في أوروبا ونماذج التنظيمات الحديثة هناك متوازنًا مع تطور مجتمعاتها واقتصادها وحركاتها السياسية والاجتماعية وأنشطة جماعاتها الفرعية، إنتاجية وطبقية كانت كشركات المساهمة ونقابات العمال، أو اجتماعية وثقافية مثل الجمعيات وأنظمة الحكم المحلي وغيرها. ولذلك فإن هذا النمو المتوازي والمتكافئ لنظم الحكم والإدارة الحديثة ولنماذج تنظيم الهيئات والمؤسسات في الغرب كان مطردًا سواء في أبنية إدارة الدولة المركزية أو في مؤسسات المجتمع المدني أحزابًا وجمعيات ونقابات واتحادات رجال أعمال وغرف تجارية وصناعية وشركات وغير ذلك. فكان اشتداد عود أجهزة الدولة من حيث القدرات والكفاءات يوازيه ويوازنه اشتداد عود أجهزة وإدارات جهات المجتمع المدني، فلم تطغ قوة الدوة الحديثة على أجهزة إدارة الهيئات المدنية الشعبية ولا أزهقت روحها. أما في بلادنا العربية والإسلامية والشرقية بعامة، فلم يحدث هذا النمو المتوازي والمتكافئ…”. البشري، جهاز الدولة وإدارة الحكم… مرجع سبق ذكره، صفحة ٣١ و ٣٢.
[30] يمكن الرجوع لعمل كارل ماركس الصادر في ١٨٥٩ “مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي” من أجل شرّح مفصل لهذه الرؤية للعلاقات الاجتماعية، خصوصًا في القسم الثاني من ملحق الكتاب والمخصص لتحليل علاقة عملية الإنتاج بعمليات التبادل والتوزيع والاستهلاك. الطبعة الآتية تتضمن مقدمة جيدة كمدخل
A contribution to the critique of political economy, translated from the German by S.W. Ryazanskaya with an introduction by Maurice Dobb, London : Lawrence and Wishart, 1971
ومتاحة كذلك على الرابط التالي: https://www.marxists.org/archive/marx/works/1859/critique-pol-economy/index.htm
[31] النظر للدولة ومجتمعها السياسي من أحزاب وبرلمانات وغيرها من مؤسسات كتكوينات خارجية أو مصطنعة لا بوصفها تكوينات تعبر عن تطور عضوي للمجتمع - أو يمكن تحويلها لتعبر عن تطور عضوي - يجد تعبيره الأمثل لدى ماركس كذلك. والأخير طور مقاربته للدولة، كجهاز وفكرة تنشأ بالتمفصل مع المجتمع الطبقي وتسعى لإعادة إنتاجه، عبر نقد أفكار هيجل و يساره الشاب. الكتابات المبكرة لماركس خصصت بالكامل تقريبًا لتطوير هذا المنهج ويمكن التعرف عليها في الأعمال الآتية:
Marx K. On the Jewish Question (1843), in The Marx- Engels Reader, edited by Robert C. Tucker, NewYork: Norton, 1978.
متاح أيضًا على الرابط التالي:https://www.marxists.org/archive/marx/works/1844/jewish-question/
Marx K. and Engels F., The German Ideology including Theses on Feuerbach, Prometheus Books, 1998
متاح أيضً على الرابط التالي: https://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/german-ideology/
[32] يخصص البشري الفصل الثاني من كتاب “جهاز الدولة وإدارة الحكم في مصر المعاصرة” السابق الإشارة إليه للتحليل التفصيلي لهذه العملية المعقدة. والفصل معنون “ النشأة الحديثة لأجهزة الدولة حتى ثورة ١٩٥٢”.
[33] التفت عدد من الدراسات التاريخية المتأخرة لتحولات أساليب التعليم الديني ومناهجه ومضمونه كأحد أهم المجالات التي تجلى فيها فعل آليات السلطة الحديثة في مصر، وهو المجال الذي عادت تحولاته لتصبغ مسار هذه السلطة بطابعها. نعتمد هنا على دراستين يعدان مثالًا مرجعيًا لتتبع هذه التحولات وهما دراسة إنديرا جينسك عن الجدل حول “إصلاح الأزهر” في نهاية القرن التاسع عشر، ودراسة تيموثي ميتشل الرائدة عن استعمار مصر، والتي قارب فيها الاستعمار كحزمة من الممارسات والنظم السلطوية الحديثة الهادفة لإنشاء ذات اجتماعية موظفة في خدمة توزيع السلطة والثروة غير المتكافئ على الصعيد العالمي، وبالطبع كان التعليم أحد أهم محاور عمل هذه الممارسات. انظر:
Gesink, I. F. (2009). Islamic ٍٍReform and Conservatism: Al-Azhar and the .evolution of modern Sunni Islam. New York: I.B. Tauris
Mitchell, T. (1991). Colonizing Egypt. Berkeley: University of California .Press
[34] البشري، نحو تيار أساسي… مرجع سبق ذكره، صفحة ٤٢
[35] عدم القدرة على تجاوز الدعاية الفكرية في المنافذ الإعلامية هو المأخذ الرئيسي للبشري على أداء القوي الليبرالية واليسارية الوطنية قبل و عقب تنحي مبارك، كما أنه السبب، من وجهة نظره، في عجزها عن تأسيس قاعدة شعبية يعتد بها. وهو يعزو ذلك بالأساس في “جهازالدولة وإدارة الحكم في مصر” إلى اغترابها الثقافي التاريخي المسئول عن عجزها عن التواصل السلس مع الجمهور. البشري، جهاز الدولة… مرجع سبق ذكره، صفحة ١٤
[36] وظفت تلك الدراسات جملة من المفاهيم والمناهج تطورت بالأساس في حقول الاجتماع والأنثروبولوجيا كالطبعات المتطورة من الفيبرية أو الماركسية أو مابعد البنيوية. من ضمن تلك الدراسات، حازت أعمال وائل حلّاق مثلًا - التي ركزت على سلطة العلماء وعلاقتها بمناهج استنباط الأحكام الفقهية - على درجة معقولة من المعرفة والانتشار في العالم العربي. ويمكن الاطلاع على المرجع الآتي الذي حرره في وقت مبكر نسبيًا كمدخل وافي لمنهجه
Hallaq W., The Formation of Islamic Law, Routledge 2004
كذلك يمكن الاطلاع على الأعمال الآتية لتكوين وجهة نظر عن السياق الاجتماعي الذي تطورت من خلاله سلطة العلماء في الفترة المذكورة
Berkey, Jonathan, The Formation of Islam: Religion and Society in the Near East 600-1800, Cambridge University Press 2003
Safi, Omid, The Politics of Knowledge in Pre-Modern Islam: Negotiating Ideology and Religious Inquiry, University of North Carolina Press, 2006
[37] البشري، الوضع القانوني المعاصر…، مرجع سبق ذكره، صفحة ٢٨
[38] من ضمن أهم الوثائق التي تعبر عن رؤية ما اصطلح على تسميته بالتيار المدني في هذا الوقت للوضع القانوني للأزهر ونطاق صلاحياته واختصاصاته، موقف “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” من تعديلات القانون المنظم للأزهر التي طرحت في صيف ٢٠١٢ وألهمت الصياغات الدستورية التالية. الموقف كاملًا يمكن الاطلاع عليه على الرابط التاليhttps://bit.ly/3th00xZ. في المقابل يمكن الاطلاع على وثائق الأزهر المذكورة على الرابط التالي:http://www.azhar.eg/azharstatements
[39] أنظر مثلًا تعليقه المفصل حول مسودة الدستور الذي أعدته الجمعية التأسيسية المشكلة من قبل البرلمان المنتخب في ٢٠١٢ والذي نشره عشية الاستفتاء علي هذه المسودة بعنوان “ملاحظات حول مسودة الدستور”. منشور في “ثورة ٢٥ يناير…” مرجع سبق ذكره، صفحة ١٣٢
[40] https://manshurat.org/node/21616
[41] يقول البشري في معرض رؤيته للشريعة بوصفها أحد مكونات النظام العام للدولة الذي ينبغي حمايته عبر التشريع: “والإسلام دين الغالبية العظمى من الشعب المصري، بحسبان أن الشعب هو الركن الركين للدولة التي ينظمها الدستور، ومن ثم تقوم خصائصه الثابتة في الواقع بحسبانها من خصائص الدولة المعترف بها في القانون، وقد نص دستور ١٩٧١ في المادة (٥) على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. وبهذا يظهر أن الإسلام ومبادئه وقيمه إنما يتخلل النظام العام والآداب وهو كذلك مما تتضمنه المصالح العليا للدولة، حسب الصيغة التي أقام بها قانون الرقابة على المصنفات ركن الغاية في القرار الصادر بشأن الترخيص بأي من هذه المصنفات”.
ثم يتجه البشري بعد ذلك للحديث عن مصدر صلاحيات الأزهر في الرقابة والترخيص للأعمال الفنية التي تتناول الشئون الإسلامية: “واستظهرت الجمعية العمومية من هذه النصوص في تتابعها الزماني، أن التشريع الوضعي الذي بنى الهياكل الحديثة للدولة والمجتمع، قد اطردت أعرافه وسياساته التشريعية على أن يوكل للأزهر الشريف في كل تنظيم له، مهمة حفظ الشريعة الغراء وفهم علومها ونشرها وحفظ التراث ونشره وحمل أمانة الرسالة الإسلامية إلى الشعوب كلها”. ملف رقم ٦٣/١/٥٨ بشأن تحديد اختصاصات كل من الأزهر الشريف ووزارة الثقافة في التصدي للأعمال الفنية والمصنفات السمعية أو السمعية البصرية التي تتناول قضايا إسلامية أو تتعارض مع الإسلام، جلسة ٢ فبراير ١٩٩٤، منشور في “المختار من فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في خمسين عامًا، القاهرة، مجلس الدولة، ١٩٩٧، صفحات ٧٣٨، ٧٤٠
[42]طارق البشري، أدعوكم إلى العصيان، العربي الناصري ١٠ أكتوبر ٢٠٠٤، متاح على الرابط التالي https://www.facebook.com/3twa.kanana/posts/961793890520229/
[43] طارق البشري، مصر بين العصيان والتفكك، القاهرة، دار الشروق، ٢٠١٠
[44] حول رؤية حركة كفاية والصلة بينها وبين تصورات البشري، أنظر، عمرو عبد الرحمن، اللغة السياسية لحركات التغيير في مصر: تواطؤ الانتلجنسيا الفعّال وحدوده، في، عمرو عبد الرحمن (محرر)، “ثورة يناير: رؤية نقدية”، القاهرة، دار المرايا، ٢٠٢٠
[45]يقول البشري في نهاية المقال "وأظن أن موضوع التوريث لا يمكن أن يكون محل رضاء الجادين فى دولة كالدولة المصرية، إلا أن يكون سكوتهم ناتجا عن عدم الاستطاعة، ومن الواضح أن عدم الاستطاعة يعكس تقديرا ما لموازين القوى فى قمة دولة حكمت بطريق شخصى فردى متتابع العقود، وأن قمة أجهزة الحكم فى تركيباتها المتوازنة بما يلائم فردية السلطة القابضة على رأس الدولة، تفضى إلى نوع من التوازن السلبى الذى ينتج الوهن وعدم القدرة على الحركة، وقد ينتج أيضا عدم القدرة على التوقع والحساب وكل ذلك يشل الفاعلية". البشري، أدعوكم إلى العصيان، مرجع سبق ذكره، على الرابط التالي https://www.facebook.com/3twa.kanana/posts/961793890520229
[46] تعبر جماعات متعددة ومتداخلة عن هذا الميل ولا يمكن اختزاله في تنظيم أو مؤسسة واحدة. وهذه الجماعات لم تبدأ في الظهور كرد فعل مباشر على تحولات ٢٠١٣، ولكن أغلبها في الحقيقة ظهر بعد تنحية مبارك بهدف “تجذير” أو “تثوير” رؤية المنظمات الإسلامية، أي دفعها في اتجاه استهداف أنوية السلطة الصلبة والتي بدونها لا يمكن تحقيق هيمنتها السياسية والأيديولوجية. من ضمن هذه الجماعات “التيار الإسلامي العام”، و “الجبهة السلفية”، أو حركة “أحرار” في مرحلة تالية. وكلها أنتجت تعليقات غزيرة على الأحداث تدور في نفس الفلك القطبي الجديد. يمكن الإطلاع على ما يشبه الإعلان النظري التأسيسي للتيار الإسلامي العام على الرابط التالي
https://www.albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?ID=5512
كما يمكن الإطّلاع على رؤية حركة “أحرار” التأسيسية في أحمد سمير، معركة الأحرار، ٢٠١٥ (غير مطبوع)، متاح للتحميل على الرابط التالي
وحاليًا تعد كتابات الباحث محمد إلهامي مثالًا نموذجيًا على هذا النزوع، وهو كاتب غزير الإنتاج، متنوع الاهتمامات. وما يجعل إنتاجه ذو أهمية بالغة هو أنه بدأ في الانتشار والتأثير مع انطلاق ثورة يناير ، واتخذ قوامه بالتعليق المكثف على محطاتها. للإطلاع على أعماله يمكن الرجوع لمدونته الشخصية http://melhamy.blogspot.com/
[47] أنظر مثلًا كتاب هبة رؤوف عزت عن الخيال السياسي للإسلاميين من أجل شرح مفصل لهذه الأطروحات، خصوصًا، فصله الرابع الذي يطرح عددًا من الأسئلة حول إعادة بناء مفاهيم الأمة والمجال العام والعلمانية.
هبة رؤوف عزت، الخيال السياسي للإسلاميين: ما بعد الدولة وما قبلها، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت ٢٠١٥.
أما المهندس أيمن عبد الرحيم، فبالرغم من التأثير الواسع لمحاضراته المصورة، إلا أن كتاباته قليلة. يمكن الرجوع لمقالاته الأربعة التي نشرها في موقع إضاءات وهي بمثابة مثال مكتمل على طرحه.https://www.ida2at.com/author/ayman-abd-el-rehem/